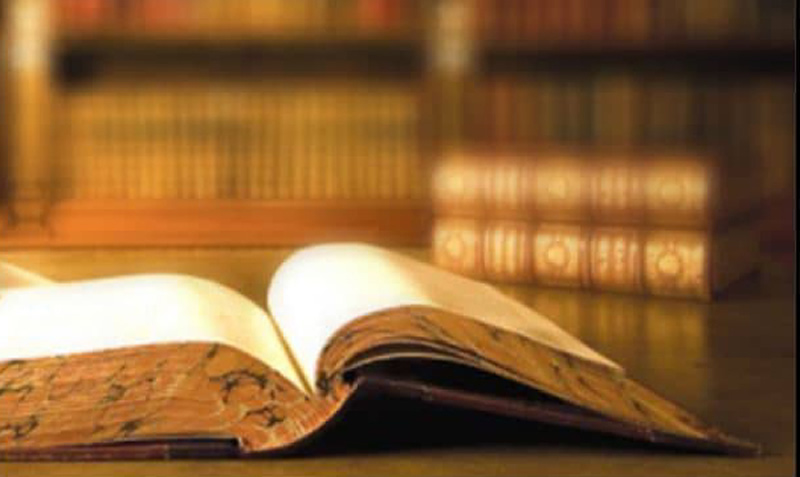يعرض المجتمع العديد من النوازل والقضايا التي تحتاج جوابا في كل وقت وحين، مما يجعل الأمر قد يلتبس على بعض العامة الذين يظنون أن الأحكام الشرعية كلها أحكام ثابتة لا تتغير، وهذا مما يخلق لهم تضاربا في الأفكار، بل وربما يوهم بعضهم بأن العلماء يتلاعبون بالدين، أو لا يستطيعون إصدار فتاوى لكل مايعرض لهم.
دعونا أولا نقف عند مفهوم الواقع وأثره على بناء الحكم الفقهي أو بالأحرى أثره فالاجتهاد وصناعة الفتوى، هذا الذي يجعلنا نتساءل، هل من حق الفقيه أن يجتهد ويصدر الفتوى خارج الواقع كما يظن البعض، أم أنه لابد أن يجعل نفسه جزءا من هذا الواقع الذي هو بصدد دراسة عينية لقضاياه وإشكالاته؟
إن الواقع هو تلك الحقيقة التي لا يمكن إنكارها أبدا، بل يجب الاعتراف بها وتكييف الأحكام حسب ماتعرضه هذه الحقيقة من ظواهر اجتماعية مختلفة، وعليه فإنه من الوهلة الأولى يتبين لنا أنه لايمكن للفقيه أن يجتهد خارج حيزه الزماني والمكاني والحالي، وإلا فإن اجتهاده سيؤول به إلى ماهو مخالف لواقع الناس، وبالتالي مخالف لمقصد الشارع.
إنه مما هو معلوم أن الأحكام المتعلقة بالمكلفين متأثرة بأحوالهم وجوبا، ونهيا، وندبا، وإباحة، وكراهة. فلا يمكن إطلاق الأحكام هكذا اعتباطا دون النظر في موجباتها، لأن الموجب للحكم إذا انعدم، انعدم معه الحكم أيضا، كالعقل إذا غاب سقط عن صاحبه التكليف، لأنه مناط هذا التكليف، فلا يتم إلا به. ومعلوم أيضا أن أحوال هؤلاء المكلفين إنما يشهد عليها واقعهم، وعليه فإن للواقع حظا وافرا في بناء الحكم، وسنحاول أن نأتي بأمثلة على ذلك للبيان والتوضيح. وإنما سقت هذه المقدمة لبيان حاجة الناس لفقه يخدم واقعهم ويدرسه دراسة علمية، أما ما يدعيه البعض ممن لا دراية له بالشريعة أصولا وفروعا، على أن هذه الشريعة أحكامها كلها توقيفية، وأن باب الاجتهاد قد أغلق مع المتقدمين، دون أن يميز ويدرك أن الله يفتح على هؤلاء بما لم يفتح به على غيرهم، فإنه يدعي ذلك عن جهالة بأصول الشريعة وقواعدها وأحكامها ومقاصدها.
والحقيقة لمن أنصف وأبحر في علوم الشرع وبحث فيه بكل موضوعية، يجد أن أصوله ثابتة لاتتغير، وهي بمثابة دعائم وقواعد ومنهج تتأسس عليه باقي الفروع الفقهية الأخرى، وأما هذه الفروع والجزئيات فإنها لاتنتهي ولاتنحصر إلى أن تهلك الارض ومن عليها، وهذه الفروع تختلف باختلاف الأزمان والأمكنة والأحوال، ولذلك نجد مجموعة من القواعد التي تبنى عليها أحكام الشرع نابعة من واقع الناس، كالعرف، والمصلحة، واتباع المقاصد...، مما يدل على أن هذه الشريعة لايمكن أن تبنى أحكامها إلا من خلال واقع ملموس ومرئي رأي العين، وليس في واقع معدوم أو افتراضي.
ومما يدل على أن فقه الواقع مهم في بناء الحكم، أن هذا الحكم المراد بناءه إنما منبع إشكاله هو الواقع نفسه، لأن الفقيه يريد بناء حكم وتنزيله على واقع معين، ولابد في ذلك من فهم هذا الواقع أولا وتصوره وتحليل جزئياته حتى يتمكن من الوصول إلى الحكم المناسب للمسألة أو الواقعة المراد الاجتهاد فيها، فلا يمكن أن يتوصل هذا الفقيه للحكم المناسب للواقعة وهو ليس على وعي بها، فذلك يوقع اضطرابا في الأحكام الشرعية الاجتهادية، ويجعلها بعيدة عن الواقعية كل البعد، ونحن نريد أحكاما واقعية متصلة بواقعها تمام الاتصال، والناظر في العمل الفقهي الحقيقي يجد أنه عمل يتصل بواقع الناس وحاجاتهم، وإلا فما حاجة الناس للفقه إذا لم يجبهم على تساؤلاتهم وإشكالاتهم، وذلك لأن دور الفقيه الحقيقي هو "إجراء النظر في مجاري بناء الأحكام في مواطنها، على وفق قواعدها، وضوابطها، وموجباتها"[1]، وهذا النظر يستدعي مراعاة الواقع وأحوال الناس حتى يجري الحكم في موضعه الذي يجب أن يجري فيه دون أن يتخلله شك ولا ريبة تقضي بفساده والإعراض عنه.
ولنا أمثلة من ذلك:
المثال الأول: من أحيا أرضا مواتا أو ابتاع خرابا فعمرها ثم جاء مستحق: فإنه يأخذ ملكه إن أحب بعد دفع قيمة العمارة القائمة، ويرجع المشتري بالثمن على بائعه، فإن لم يختر المستحق ذلك قيل للثاني ادفع إليه قيمة أرضه براحا وتكون لك، فإن أبى كانا شريكين بقدر قيمة البراح من غير عمارة وقيمة العمارة قائمة[2]
وصورة ذلك أن يأخذ رجل أرضا خرابا فيعمرها ويبنيها ثم يسكنها مدة معينة، ثم يأتي من يدعي أنها في ملكه وتحت حوزة يده ملكا شرعيا كما تحاز به الأملاك. فإن أثبت ذلك بما يشهد له من رسوم وأدلة، كان له الحق فيما ادعاه، فإذا تم تمكين المدعي مما يستحقه من ملك تلك الأرض – وذاك حقه – كان ذلك فيه ضرر للمالك بالشبهة، أعني الذي عمرها وبناها بشبهة الملك،وإذا قلنا إنها لمن عمرها فإن ذلك فيه ظلم لصاحب الملك. فيتحصل من ذلك ثلاثة أحوال:
أولا؛ الخيار للمالك الحقيقي في أن يدفع لمن عمر تلك الأرض ثمن بناءه ويحوز منه الأرض.
ثانيا؛ الخيار للمالك بالشبهة أن يدفع ثمن الأرض لصاحبها وتبقى له .
ثالثا؛ إن أبى كل منهما أن يدفع للآخر فلا يبقى إلا أن تقوم الشركة بينهما إلزاما، أحدهما بالأرض، والآخر بالتعلية، وهذا كله لدفع الضرر المتوقع من كلا الطرفين، ومجانبة ضياع الحقوق، وهذا كله كما ترى فرضه الواقع والأحوال المحيطة بالنازلة، وبناءا على قاعدة "الضرر لا يزال بالضرر"، وأنت كما ترى فإنه بذلك يكون قد ارتكب أخف الضررين حفظا للحقوق.
المثال الثاني: وجوب الشفعة للشريك المخالط، والأصل فيها قولﷺ {الشفعة فيما لم يقسم}[3]
وقد اشترط المالكية أن يكون الشفيع شريكا في الشيء المشفوع فيه (كالدور والعقار والأراضي) وليس للجار الشفعة خلافا لأبي حنيفة.
وجه وجوبها فيما لم يقسم دون غيره، أي الذي لازال في الشياع شركة بينهم، أن الذي اراد ان يبيع حقه وجب عليه إلزاما أن يقدم الشريك على غيره، وذلك دفعا للضرر الذي قد يلحق بهذا الشريك أو هؤلاء الشركاء بدخول شخص أجنبي عنهم،وهذا فيه تقديم للمصلحة العامة على الخاصة. وهذا أمر يفرضه الواقع وحال الناس في معاملاتهم وعاداتهم، فإنهم لايحبون أن يدخل عليهم شريك غريب لا معرفة لهم به، فكان حقهم في الشفعة أولى بهم من غيرهم حفظا للمصلحة العامة.
المثال الثالث: القراض (المضاربة)
وصفة المضاربة أن يدفع الرجل رأس مال لغيره ليتجر فيه ويبتغي من فضل الله تعالى، ويكون الربح بينهما على جزء يتفقان عليه من قليل أو كثير.[4]
وهذا النوع من المعاملات التي كانت معروفة في الجاهلية وأقرها الإسلام "والرخصة في ذلك إنما هي لموضع الرفق بالناس"[5]
وإذا ما تأملنا في هذا النوع من المعاملات، نجد أن الفقهاء يجعلون الربح والخسارة على الطرفين معا، ولاضمان فيه إذا أفلس المتاجر منهما، فكما أن صاحب المال ينتظر نصيبه من الربح، فكذلك له أن يتحمل الخسارة، ولذلك قالوا أنه لايجوز لصاحب رأس المال أن يشترط الضمان وإلا فالعقد فاسد. ووجه ذلك هو المساواة في تحمل الخسارة كما في الربح، لأن السوق والتجارة ربح وخسارة، والذي يدخله يعول على ذلك كله، وهذا مبناه على قاعدة "الضرر يزال" وهي نهي عن الإضرار بالناس أو التسبب لهم في الضرر، ووجه ذلك أن هذا الذي قد خسر التجارة إذا تحمل الضرر وحده، فإنه يتحمله على جهتين:
جهة تحمل خسارة التجارة، وجهة رد المال لصاحبه، وأما إذا تحمل الربح فإنه يقاسم فيه صاحب رأس المال، ولذلك يجب أن يقاسمه في الخسارة كما يقاسمه في الربح لقوله ﷺ{لاضرر ولاضرار} وهو مبنى هذه القاعدة المذكورة، وذلك حفظا للعلاقات الإنسانية التي يمكن أن تتأثر بأدنى شيء فتخلق العداوة بين الناس ، وهذا مخالف لمقصد الشريعة وأحكامها، لأن الأحكام إنما وضعت لتنظم العلاقات بين الناس، فلزم أن تكون ملائمة لواقعهم، فيكون لها دور حمائي قبل أن يكون زجريا.
والأمثلة من ذلك كثيرة ومبسوطة في كتب الفقه والنوازل، مما يدل على أن الواقع له دور مهم في بناء الأحكام وتوجيهها وتنزيلها على وجه سليم لا يتعارض مع واقع الناس ولا يناقضه.
ولذلك من شروط المفتي أن يكون على معرفة بالواقعة " ودراسة نفسية المستفتي والجماعة التي يعيش فيها، ليعرف مدى اثر الفتوى سلبا وإيجابا"[6]
وهذا كله حتى لا نوقع الناس في الضيق والحرج والتشدد في بعض المواقع التي لاتحتاج ذلك، ومن الضروري الأخذ بعين الاعتبار بأحوال الناس وظروفهم وتفاوت درجاتهم، فالناس ليسوا سواء، وليسوا في درجة واحدة، فإن أحوالهم وظروفهم تتفاوت، وهذا التفاوت لا بد من الأخذ به بعين الاعتبار في صناعة الفتوى وبناء الأحكام، فقد يكون عدم العلم بذلك كله وبناء الحكم عن جهل فيه إلحاق الضرر بالناس وتحقيق المفاسد عن غير قصد، ولربما اليوم أصبح من الواجب على الفقيه والمجتهد المفتي أن يكون على اطلاع ببعض العلوم التي تهتم بدراسة المجتمع وأحواله، إذ من شأنها أن تساعده على الوقوف على حقيقة هذا المجتمع، كعلم الاجتماع، وعلم النفس، وعلم التاريخ، والاقتصاد...، حتى يكون هذا الفقيه متسع النظر، متبصرا بأحوال الناس خبيرا بواقعهم، بل ويكون هو جزء من هذا الواقع، هذا الذي يجعل الفقيه يجيب الناس على إشكالاتهم كلما طرحوها عليه، والتي ربما لا يجدون لها جوابا إلا عنده، فإن تخلف هو الآخر وقعت الفوضى والفساد بسبب ذلك. ومن المعلوم أن الفقه كان له هذا الدور منذ أن نشأ وإلى اليوم، إلا أنه اعتراه بعض التقليد والجمود، وقد حان الوقت لإعادة النظر في بناء معارفنا والنهوض بعلومنا الإسلامية التي تخدم والواقع والأمة، ومن أهمها الصناعة الفقهية.
الصناعة الفقهية/ص327/ مولود السريري[1]