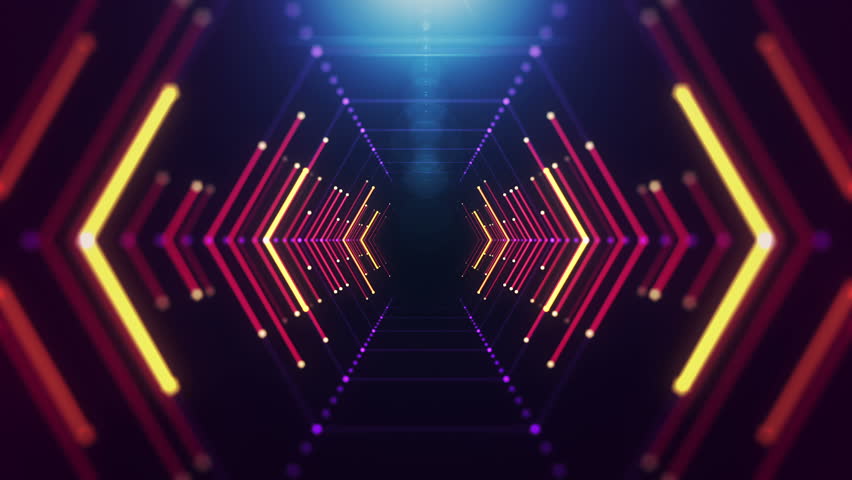الموقف الفلسفي
تحث عدة هيئات وجمعيات على مساهمة الفلسفة في تسليط الضوء على المشاكل التي تثيرها الأبحاث والتطبيقات المنجزة في إطار العلوم البيولوجية والطبية. ويمكن كذلك أن نفترض أنه يوجد عند الجمهور أفق انتظار بهذا المعنى، كما لو كان على موعد مع التعبير عن وجهة نظر العلماء والمشرعين ورجال الدين. بكل اختصار، يمكن للطلب الاجتماعي على الفلسفة أن يتوجه إلى ما من لازلنا نعتبرهم كاختصاصيين في الشمولية.
لنطرح السؤال الأول عما يعقل انتظاره من الفلسفة. لهذا السبب يتوجب التشديد على الطابع الخصوصي لموقف الفلسفة من من قضايا وتيمات الأخلاق البيولوجية ومن كل تدخل ممكن بهذا الصدد. فإذا كان رجال الدين يعتبرون كممثلين لعقيدتهم الدينية التي ينبغي في نظرهم احترامها، نجد أن الفلاسفة لا يصدق عليهم نفس المقال. لا أحد منهم بإمكانه الادعاء بأنه يمثل الصوت الحقيقي للفلسفة؛ وهذا راجع إلى ثلاثة أسباب:
- السبب الأول هو أنه لا وجود لفلسفة واحدة وموحدة. ثمة الآن، كما في الماضي، فلسفات متعددة ومختلفة ومتعارضة فيما بينها في الغالب وسجالية على نحو عنيف بحيث يستحيل الرجوع إلى مذهب فلسفي موحد، باستثناء أنه يمكن التشبث بتعريفات فضفاضة لا طائل من ورائها. لهذا أمكن القول في القرن الثامن عشر باستحالة تعلم الفلسفة، ويالتالي فأقصى ما نفعله هو التمرس على تعلم التفلسف (كانط). فما بالنا، والحالة هاته، عندما يطلب منا توضيح بعض المسائل الخاصة، مثل مسألة الأخلاق البيولوجية التي تتطلب منا إصدار أحكام واتخاذ مواقف؟
- السبب الثاني يرتبط، على نحو مفارق، بوجود نقاط مشتركة بين مختلف الفلسفات، وهو ما يشكل روحها التي تسمح بالتمييز فيها بين ما ينتمي إلى الفكر الفلسفي وبين ما يعود إلى المجال الديني وإلى مجال العلوم الاجتماعية والإنسانية.
- السبب الثالث والأخير هو أن الفلاسفة لم يتعودوا أبدا على المشاركة في النقاشات العمومية والخروج من فضائهم المفضل، لديهم؛ أي البحث والتدريس. وهذا بدوره راجع إلى عدة أسباب، منها أولا أن الفلاسفة لا يستطيعون الانتساب إلى تخصص معين أو كفاءة خاصة بهم مثل المهندسين والأطباء ورجال القانون، إلخ.. ومنها، ثانيا، أن الفلسفة انحصرت في مجال ضيق أدى بها، انطلاقا من القرن التاسع عشر، إلى العزوف عن المشاركة في النقاشات وعن اتخاذ موقف بشأن الأسئلة الكبرى التي يطرحها عصرنا الحالي. لماذا إذن نحمل الفيلسوف على إبداء رأيه بخصوص مسائل دقيقة تتطلب معالجة المختص، بينما هو ليس بمختص كما رأينا؟
وعلاوة على ذلك، ليس هناك ولو سبب واحد يجعلنا نعتقد مسبقا أن آراء الفيلسوف تفوق من حيث القيمة آراء أي مواطن كيفما كان. إذن، بما أن الفيلسوف يرفض اتخاذ موقف بناء على يقينيات مكتسبة، ينتج عن ذلك أنه كلما تم استدعاؤه يكتفي بأن يقترح محاولة إمعان النظر في المسألة المعروضة عليه لأجل الخروج برؤية واضحة في شأنها عن طريق الطرح الدقيق لبعض الأسئلة والبحث العميق في اللغة التي يجري بها النقاش، تاركا لكل واحد حرية الحكم وفق إرادته. من هنا يأمل الفيلسوف في أن يساهم على الأقل في خلق شروط النقاش العمومي والمدني.
° الفترة الراهنة
لن أضيف جديدا إذا قلت بأن ما يميز الفترة الراهنة عما سواها احتواؤها على أزمة شاملة. لكن من المؤكد والبديهي أنها أثرت وسوف تؤثر لا محالة على طريقتنا في تناول مسائل الأخلاق البيولوجية، سواء أكان ذلك بغير وعي أم بوعي. الأزمة ليست فقط مرحلة من الانقلابات والاتهامات المتبادلة وفقدان المعلمات الاعتيادية، بل أيضا مرحلة يظهر فيها الجديد وينبثق منها المستقبل ويتشكل أمامنا المسكوت عنه الذي لم يسم بعد.
المسألة الأولية، إذن، هي مسألة المواقف التي يتعين تبنيها. هل يتوجب علينا إصلاح القيم القديمة، دون أن نفهم لماذا وقعت الأزمة؟ هل يتعين رفض كل ما يرى النور واتهام الجديد بشكل مسبق؟ من جهة أخرى، هل يلزمنا الاكتفاء برمي التقليد جانبا واحتضان الجديد بدون فكر نقدي، وبالتالي الانبهار أمام الحداثة ومغرياتها والاستسلام فقط لما هو آت؟ أم يتعين علينا أن نتطلع من الآن إلى تأسيس قيم جديدة ننظم بها المستقبل ونتقي بها المخاطر التي نتوجس منها خيفة؟ باسم ماذا نقدم على إشهارها إذا كان كل شيء مأزوما؟
ومع ذلك، يمكن القيام بأعمال إيجابية في ظل الأزمة، كما تقول الفيلسوفة الأمريكية حنا أرندت: "عندما تجبرنا الأزمة على الرجوع إلى الأسئلة ذاتها لا تطلب منا أفكارا جديدة أو قديمة، بل أحكاما مباشرة على أي حال (...) لا تعود (الأزمة) كارثية إلا إذا أجبنا بأفكار جاهزة كليا، أي بأحكام مسبقة".
بناء على هذه الدعوة إلى الإبداع الكامنة في أحشاء الأزمة كواقع ومفهوم في وقتنا الراهن، ومن أجل توصيف العلاقة بين الفلسفة والأخلاق البيولوجية، أقترح التطرق للمسائل التالية التي أسجل بصددها بعض الملاحظات الإشكالية:
1) العلم من التحرر إلى الخوف؛
2) الرغبة والحق؛
3) الحق الأخلاقي مسألة الحدود؛
1) العلم من التحرر إلى الخوف
منذ هيروشيما، اعتدنا على اعتبار العلم والتقنية كتهديدين كبيرين وانتهينا إلى التذكير بما قاله هيدغر عن التفتيش الذي خضعت له الطبيعة والإنسان من طرف التقنية، العقل الحاسوب، بتحويلهما إلى أشياء جامدة خاضعة للتجريب المستمر وللاستعمال والاستغلال. بيد أنه ينبغي أن نلاحظ أن هذا الموقف يبرز انقلابا على مستوى القيم مقارنة مع تقليد راسخ طبع الثقافة الإنسانية منذ ما قبل ظهور الإسلام بقرون طوال.
يفيد هذا التقليد الذي يمكن أن نعود به إلى بعض فلاسفة اليونان بأن المعرفة العقلية والمنهجية بالطبيعة وبالإنسان، أي ما أصبح يعرف لاحقا بالعلم، تمد الإنسان بأدوات لمحاربة خوفه وبأدوية لإزالة بؤسه. فهذا الفيلسوف اليوناني أبيقور وتلميذه الروماني لوكريش يوضحان بأن الأساطير والأهوال المتولدة عن الخرافات الدينية قد تراجعت أمام زحف المعرفة العقلية بالطبيعة، هذه المعرفة القادرة وحدها على أن توفر صفاء الروح وهناءة السلم بين الناس المتصالحين أخيرا فيما بينهم. وسوف يأتي ديكارت لاحقا ليعرض ثقته في الغاية الجديدة التي مكن العلم بعد غاليلي الناس من تحقيقها؛ ألا وهي القوة والحكمة في آن واحد. لكن فكرة ديكارت حول سيطرة الإنسان على الطبيعة تعرضت مؤخرا للنقد بناء على أن الإنسان ذاته جزء من الطبيعة، فكيف يعقل أن يهيمن الجزء على الكل؟
من كتاب ديكارت "خطاب في المنهج"، أورد في ما يلي نصا كثيرا ما تم الاستشهاد/الاستئناس به، غير أنه تعرض هو الآخر للنقد لأن البعض رأى أنه يضفي الشرعية على شرورنا الراهنة:
"بمجرد ما اكتسبت بعض الأفاهيم المتعلقة بالفيزياء، لاحظت إلى أين يمكن لها أن تقود، واعتقدت أني لا أستطيع أن أحتفظ بها مخفيا إياها دون أن أجني كثيرا على القانون الذي يلزمنا، بقدر ما هو كامن فينا، على تقديم الصالح العام لجميع الناس، ذلك لأنها جعلتني أرى أنه من الممكن الحصول على معارف تكون مفيدة جدا للحياة، وأنه عوض هذه الفلسفة التأملية التي ندرسها في المدارس، نستطيع أن نجد لها تطبيقا، بواسطته نعرف بوضوح طاقات وحركات النار والهواء والنجوم والسماوات وكل الأجسام التي تحيط بنا مثلما نعرف مختلف صنائع صناعنا، ويغدو بإمكاننا استخدامها بنفس الطريقة في كل الاستعمالات الخاصة بها، وهكذا نصبح سادة وملاكا للطبيعة".
وحتى لا أكثر من الاستشهادات، أكتفي في هذا السياق باستحضار فكرة رائجة في الثقافة الغربية وقائمة على الربط بين المعرفة بصفة عامة والإسهامات العلمية وبين ممارسة المواطنة. فحسب كوندورسيه، مثلا، تتأسس الحرية السياسية المعترف بها في القوانين على قدرة المواطن على الحكم والإرادة بكل ما أوتي من خبرة. فإذا كان تعليم المعارف وتعميمها وتطبيقها من واجبات كل جمهورية، فلأن لا وجود لجمهورية بدون جمهوريين، أي بدون مواطنين متنورين.
فلماذا يفترسنا الخوف حاليا؟ ما هو الشيء الذي ضاع من حلم التحرر لدى الناس بواسطة المعرفة والتطبيقات العلمية؟ لماذا أدرنا ظهرنا للصيغ الديكارتية؟ لن ننسى قنبلة هيروشيما وسوف نتذكر دائما الإبادة الجماعية الفظيعة لليهود والجنازات التي تشيع الآن يوميا للضحايا الفلسطينيين. لن يغيب عن بالنا لحظة واحدة القنابل الإيكولوجية الموقوتة. لذلك، لا يسعنا إلا أن نحمل المسؤولية عن هذه الفظائع لإيديولوجيا علموية معينة تجعل من تنامي القوة واحتقارها للإنسان شعارا يكاد يكون خاصا بها. لكن، لتجاوز هذه المعاينة التي بالإمكان تعقيدها أكثر وإغناؤها بمزيد من الأمثلة الصارخة، حسبي الكشف عن المكامن الفعلية للتهديدات.
إذا تم تناسي الغائية الكلاسيكية (التحرير، المساعدة على جعل الناس أكثر حكمة وسعادة)، فلأن العلم وجد نفسه تدريجيا محكوما بالاقتصاد وخاضعا لمنطقه: الربحية، المردودية، التنافسية. وفضلا عن ذلك، لا يستطيع العلم المعاصر أن يشتغل إلا إذا ساندته وشجعته السلطة السياسية. إن هيروشيما لا تضع في قفص الاتهام ما يعرف باسم العلم التقني فقط، بل تضع فيه أيضا الصناعة العسكرية وسلطة رجل السياسة. هكذا يعتمد رجال السياسة، وبصورة أشمل جهاز اتخاذ القرار الدولتي، اعتمادا كبيرا على الإكراهات التي يفرضها تداخل المقتضيات العلمية الخالصة مع المقتضيات الاقتصادية. ويترتب عن ذلك عجز عن التحكم في قوة العلم التقني الذي يبدو منفلتا من قبضة المواطنين الذين لا يفقهون فيه شيئا، والعلماء الذين لا يراقبون سلسلة البحث- التطبيق- التسويق، والمسؤولين السياسيين الذين يحملون العلماء والتقنيين المسؤولية.
ومهما يكن من أمر، لن يجمل بي أبدا تحويل العلم إلى فزاعة أو كاريكاتير والتلويح دائما بنفس الصور لتجريده من قيمته. لكن ليس من المؤكد أن العلم والتقنية في مجال القوة لم يحققا تقدما يذكر في سبيل الاقتراب من برنامج "خطاب في المنهج".
إذا انتقلنا إلى مجال المعرفة بالكائن الحي، فمن البديهي أن تكون المخاوف على هذا المستوى أكثر إثارة للفزع. هنا نلامس الحياة والموت والإنجاب وحماية الأفراد وبقاء النوع وتناسل الذات في الآخر وهويتها الخاصة وعلاقتها بالآخر..غير أن العلم الحديث يخضع لمسلمة مفادها أن ما يمكن فعله، سوف نفعله، سوف ننتهي إلى تحقيقه، لا بل يجب فعله".
واضح، إذن، أن تطبيق هذه المسلمة على الحياة البشرية داع من دواعي القلق. لأول مرة، يتمكن علما الحياة والطب من تغيير وتحويل المسارات الحيوية وإخضاعها لغايات غريبة عنها. قد تكون هذه الغايات سياسية (علم تحسين النسل) واجتماعية (الانتقاء والإقصاء بناء على نتائج الروائز الوراثية)، واقتصادية (المتاجرة في الأعضاء الحيوية والأجزاء الأخرى من الأجساد الحية)، وقد تكون راجعة إلى أنانية محلوم بها بشكل غريب (اختيار جنس المولود، إلخ..).
كل ذلك صار معروفا. لكن ينبغي أن نتساءل عن الحدود المفترض وضعها أمام تطبيق العلوم الوراثية والطبية. فانطلاقا من ماذا يمكن لنا الإعلان عن الموانع، والنواهي والالتزامات؟ من يرى أنه لأجل تجاوز هذه الأسئلة الحاسمة يتعين التخلص من الخوف؟ وبناء عليه، يستحسن أن نأخذ بعين الاعتبار ظاهرة أساسية ضمن الوضع الناجم عن تقدم علم الوراثة، وهي متعلقة بدور الطب الفردي والجماعي. هذا الطرح الأخير يفضي بنا إلى مسألة الحق وعلاقته بالرغبة.
2)الرغبة والحق
لا شك أن هذه الفقرة تندرج ضمن إشكالية الحق في الرغبة، ما يجيز لنا العودة إلى المسلمة الواردة أعلاه: كل ما يمكن فعله يجب فعله. نلاحظ أولا أن هذه المسلمة ليس لها معنى وليست لها إمكانية التحقق سوى لأن شيئا ما ينقل هذا "الممكن فعله" إلى "الفعل". وإذا وضعنا جانبا المصالح الاقتصادية والتجارية المشار إليها آنفا، يجدر بنا الحديث، ولو بإيجاز، عن ظاهرتين أساسيتين، حتى نتمكن من استيعاب ما يجري.
.أ) جميع الإنجازات في مجال الإنجاب الموضوع تحت المراقبة، مثلا، تتأسس فعلا على معطى طبيعي يتمثل، باعتباره نتيجة لتطور النوع البشري، في كون وظائف التناسل وممارسة الجنس قابلة للتعديل. من هنا إمكانية الاختيار الكامنة في الطبيعة ذاتها بين الرفض والقبول. وهذا الأمر نعاينه اليوم من خلال تحويل الإنجاب عن مساره . لقد جاءت البيولوجيا في عصرنا الحالي لتمنح لما كنا نعرفه منذ الأزل وجودا عمليا ملموسا..هل يتعين علينا، مخافة من المخاطر والانزلاقات الممكن تصورها، أن نلغي بجرة قلم هذه الحقيقة الطبيعية وما تسمح به من حرية وما يستتبعها من متعة ورغبة؟
ب) انطلاقا من هنا، نتفهم إمكانية ومشروعية المطالب التي تعبر عنها صيغة "له الحق" (ضمير الهاء يعود هنا إلى الكائن البشري ذكرا كان أم أنثى). له الحق في أن يكون له أطفال، في أن لا يكون له أطفال، لا الآن ولا لاحقا، له الحق في أن يكون له بنات أو بنين، أطفال بدون أم، بدون أب، أو بدونهما معا، إلخ..
إن هذا المطلب الأخير نابع من الوفرة الحالية التي شهدتها الحقوق الشخصية التي لا يتطلب تحقيقها سوى مقدرات مادية وعملية، والتي تضع رغبة الفرد في مواجهة القضاء والاقتضاء كليهما، شريطة أن يبرر كل فرد رغباته، ليثير مشاكل فقهية وإنسانية تستعصي على الحل وتبدو مخيفة بحيث أنها تعزز الموقف الارتيابي حيال الوراثة البيولوجية.
3) الحق والأخلاق
لنطرح مشكل الحدود ضمن دلالة مفهوم الأخلاقيات البيولوجية. اعتبارا للفكرة التي مفادها أن الأخلاق ملزمة بأن تعطي ما به تضفي الشرعية على فرض حدود أمام توسيع وتمديد العلوم التقنية للعنصر الحي الموجود في الكائن البشري، وإذا كان الكل يعتبر ذلك مهمة مستعجلة منوطة بمجتمعاتنا، فلا يعني هذا أننا متفقون على طريقة واحدة في تناول مشكلة الحدود. ما الذي يتوجب علينا حظره كليا أو مراقبته فقط أو تأطيره بدقة ضمن مجال الأبحاث العلمية الأساسية وضمن التطبيقات الطبية والبولوجية وضمن ممارساتنا الشخصية ومطالبنا؟ بالطبع، هذا إشكال يواجهنا وهو يتمثل في كون البيولوجيا الجديدة ترغمنا على إعادة التفكير في معاييرنا وقيمنا الأخلاقية.
زيادة على السؤال الكبير والعويص عن أصل القيم الأخلاقية (هل هو الله؟ الطبيعة؟ العقل البشري؟ الصالح العام؟ وهذا الأخير، كيف ينبغي تحديده؟ هل هو سعادة كل فرد؟ مصلحة الجميع؟ وبأي منظور؟ بمنظور الحاضر أو المستقبل؟)، لا نعرف ماذا نصنع بمفاهيمنا الأخلاقية الراسخة كلما تعلق الأمر بقرارات لا بد من اتخاذها.
بالنسبة لما هو أساسي، يحق لنا أن نقول بأن الفكر الأخلاقي، أقصد تصورنا للأخلاق، يقوم على فكرة مؤداها أن الكائن البشري شخص أولا وقبل كل شيء. هذا هو المفهوم الرئيس في علم الأخلاق، وبالتالي فهو ما نعنتقد أنه قادر على منحنا القاعدة التي تبنى عليها واجباتنا إزاء ذواتنا وإزاء الآخرين.
يعلم معشر الفلاسفة أن كانط (1724-1804) هو الذي وضح وفسر هذا المفهوم. يميز هذا الفيلسوف بين الشيء الذي يمكن استعماله وهو ذو منفعة وذو ثمن وبين الشخص؛ أي الكائن المستعصي على أية مقارنة ممكنة، الذي لا يرتبط بشيء آخر غير ذاته، لذا فهو ذو قيمة مطلقة، ليس له أي ثمن مقابل، بل له كرامته.
ينتج عن هذا أن أي شخص محط احترام مطلق غير متوقف على اعتبارات ظرفية أو جسدية أو اخلاقية أو اجتماعية، إلخ..من هذا المفهوم عن الشخص نستنتج، إذن، بسهولة قانونا أخلاقيا يلزمنا دائما بأن نحترم في شخص الآخر الذات الإنسانية والكرامة اللتين تحددانه، وبأن نتعامل مع إنسانية الذات والآخر باعتبارها غاية وليس فقط باعتبارها وسيلة.
لربط الماضي بالحاضر، أستدعي على سبيل الاستئناس فيلسوفا ألمانيا آخر معاصر لنا، شرع منذ سنوات في دراسة الإشكاليات المرتبطة بالأخلاق البيولوجية ضمن الأخلاق التطبيقية، وتجسدت تمرة أبحاثه في إصداره مطلع الألفية الثالثة للكتاب الحامل لعنوان "مستقبل الطبيعة البشرية".
يتعلق الأمر بهابرماس الذي قال في حوار أجرته معه صحيفة "لوموند" الذائعة الصيت ونشرته في أحد اعدادها لشهر فبراير من سنة 2002 في معرض جوابه عن السؤال الثاني الذي صيغ بلغة كانطية: "ينبغي التأكيد فورا على أني لست مختصا في البيولوجيا وأجهل ما إذا سيكون سيناريو" التبضع من سوق الجينات الممتاز" الذي برز اليوم في خطوطه الرئيسية واقعا متحققا. بإمكاننا أن نتمنى بقاء فكرة "أطفال التصميم" مجرد تأمل لا يخضع لأي قيد أو شرط. وعليه، فالمسألة من الجدية بحيث لا يمكن أن نتصور على سبيل الافتراض أننا سنكون ذات يوم في حضرة علم لتحسين النسل إيجابي يتجاوز العلاج الوقائي البسيط. بالموازاة مع ذلك، سوف تتاح للآباء إمكانية وصلاحية التقرير قبل ميلاد أبنائهم (أيا كان عددهم) في شان خصائصهم، استعداداتهم أو كفاءاتهم الوحيدة الخلية. في مثل هذه الحالة، أتوقع إمكانية شعور مراهق توصل إلى الإحاطة علما بأنه كان موضوع استعمال في مرحلة تكونه الجنيني، بمحدودية حريته الأخلاقية".
يتابع هابرماس جوابه قائلا: "سوف يكون بمقدور هذا المراهق أن يطالب أبويه، المسؤولين عن منحناه أو تصميمه الجيني، بتقديم الحسابات. قد يكون بإمكانه، مثلا، أن يتهمهما بأنهما زوداه بقريحة الرياضيات ولم يجهزاه لرياضة ألعاب القوى أو الفن الموسيقي بكفاءات من شأنها أن تكون أكثر فائدة لتحقيق حلمه بمزاولة مهنة بطل رياضي أو عازف على البيانو. هل بإمكانه كذلك أن يستوعب ذاته بوصفه الفاعل الوحيد في سيرة حياته عندما يتوصل إلى معرفة النوايا التي وجهت اختيار الفاعلين الشريكين في منحاه الجيني؟ أكيد أن الآباء يتمنون الأحسن لأبنائهم، لكنهم لا يستطيعون معرفة نوعية الموهبة التي ستكون "الأحسن" في سياق غير متوقع لسيرة حياة ليست هي سيرة حياتهم".
ختاما، إذا عدنا إلى السؤال الذي انطلقنا منه (أي دور للفلسفة؟)، يبدو لنا جليا أن الفلسفة حالما تريد إسماع صوتها في خضم جملة المشاكل المشار إليها سابقا – على سبيل المثال لا الحصر – فعليها ألا تقتصر على تحديد المبدإ المطلق للأخلاقية، وفي أسوإ الأحوال على فضح العلم وانزلاقاته، بل عليها الاهتمام بعلم القضايا الضميرية أثناء الخوض في مسائل الأخلاق التطبيقية، والاعتراف بأن خصوصيتها تستدعي قلب علاقة العام بالخاص وعلاقة المقدمة بالنتيجة. كما أن السؤال عن كيفية التعامل مع الحالات الخاصة يشكل محكا لصلاحية النظريات الأخلاقية ودافعا لإنتاج نظريات جديدة.