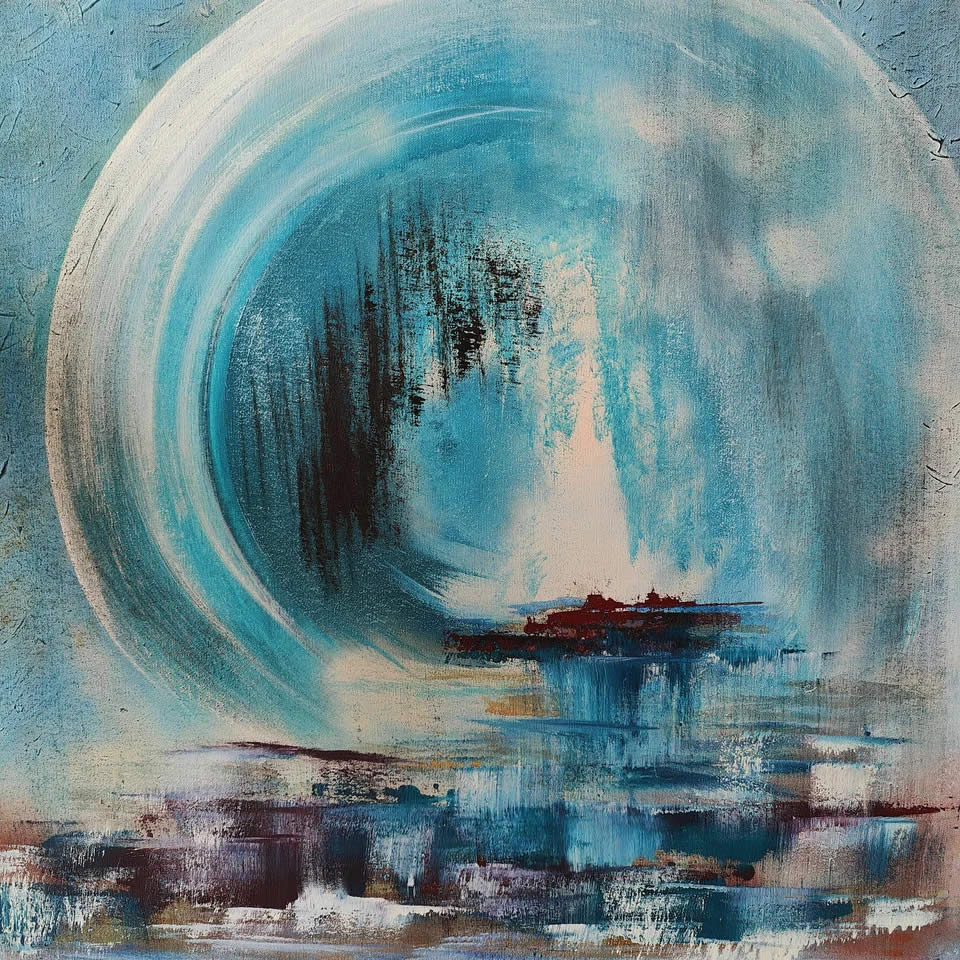ألقى جان غروندين، أستاذ الفلسفة بجامعة مونتريال الذي نشر مؤخرا (2019) كتابا تحت عنوان "جمالية الميتافيزيقا: بحث في دعاماتها الهرمونيطقية"، هذه المحاضرة صمن ندوة متعددة التخصصات سلطت الضوء على اندماج معهد الدراسات الدينية في كلية الآداب والعلوم بجامعة مونتريال سنة 2017، ويود المؤلف في محاضرته هاته أن يتناول بعض الروابط الوثيقة التي وحدت الفلسفة بالدين وعلم اللاهوت.
إنه يؤكد أولاً على الديون الفلسفية اللامتناهية والعتيقة والمؤلمة بأحد المعاني تجاه الدين، الذي فكر واحتفل قبلها (الفلسفة) بفكرة نظام وجمال العالم، ثم ديون اللاهوت وديون الدين نفسه تجاه الفلسفة عندما أرادا أن يعبرا عن رسالتهما الخلاصية بلغة العقل.
إن الصعود الأخير المذهل لفلسفة الدين، والذي يمكن رؤيته في عدد لا يحصى من المنشورات وفي إنشاء جمعية فرنكوفونية لفلسفة الدين سنة2011، ثم الجمعية الكندية لفلسفة الدين في عام 2018، هو ظاهرة لها عدة أسباب.
إن "عودة الديني" التي تمتمت بها وسائل الإعلام في أعقاب أحداث 11 سبتمبر 2001 لها علاقة بهذه الظاهرة، كما هو الحال مع وصول مهاجرين من ديانات غير مسيحية إلى الدول الغربية، والذين واجهوا هذه المجتمعات بعودة ظهور، مقلقة بالنسبة للبعض، لل"ديني".
عندما يتعلق الأمر بالفلسفة، تبدو عودة الدين كموضوع اكتسى اهتماما كبيرا مفاجئا لأن الدين كمخدر سام قد اختفي من فلسفة ما بعد الحرب، مع الشعبية التي حققتها الوجودية "الملحدة" والماركسية والبنيوية و"الوضعية" و"الفلسفة التحليلية، التي اعتقدت أن الخطاب المعقول الوحيد هو خطاب العلوم الدقيقة. لكن بالنسبة لكل هذه الفلسفات، التي مارست ولا تزال تأثيرا كبيرا على عقول الناس، خاصة في المدارس والثانويات والجامعات وفي العديد من وسائل الإعلام، تم فهم سبب الدين: كان أفيون الشعوب، منه تحرر العقل الفلسفي بشكل نهائي وناجح.
هنا، أدى سقوط جدار برلين في عام 1989 عمله: فقد أظهر أن اليقين الماركسي (والوضعي) بأن الدين كان مجرد شكل من أشكال الاغتراب كان في حد ذاته نتيجة اعتقاد، بل حماسة لم تكن سوى متماثلة مع الدين.
قال ريمون آرون بشجاعة في عام 1955 عن هذه الماركسية إنها أصبحت أفيون المثقفين (وهو ما لا يزال صحيحا في بعض الخلايا الجامعية).
انهيار الماركسية، التي نكتشف أنها عملت قبل كل شيء كدين مبتذل، هجمات 11 سبتمبر، تدفق المهاجرين المرتبطين بأصولهم الدينية على المجتمعات الغربية ومفارقات الفلسفات التي شعرت بجو من التفوق على "الديني"، كل ذلك دفع الفلاسفة - خاصة المشاهير منهم مثل دريدا، وهابرماس، ورورتي، وتايلور، وفاتيمو، وجان غريش، وريمي براغ، الذين نادراً ما تحدثوا عن الدين في كتاباتهم السابقة، مادام الموضوع كان مكروهاً - إلى إعادة اكتشاف الروابط اللانهائية والمقموعة منذ فترة طويلة بين الدين والفلسفة، والتي نود أن نناقشها هنا على وجه الخصوص.
يوجد بالفعل تقاطعات بين الدين والفلسفة بعدد أكثر من النجوم في السماء، حتى لو كانت غيوم الوقت الحاضر تمنعنا أحيانا من رؤيتها وتقدير لمعانها.
كان أعظم الفلاسفة من علماء اللاهوت الرائعين والمؤثرين. يكفي التفكير في أفلاطون، أرسطو، أفلوطين، موسى بن ميمون، ابن سينا، أنسيلم، ابن رشد، طوماس الأكويني، نيكولاس دي كوز، باسكال، ديكارت، سبينوزا، لايبنيز، كانط، هيجل، كيركيغارد، حتى نيتشه وهايدجر (الأول كان ابن قس والثاني درس اولا اللاهوت؛ ولا يزال تأثير كليهما على اللاهوت المعاصر هائلاً).
من جانبهم، كان اللاهوتيون دائما وتقريبا فلاسفة من الدرجة الأولى: بصرف النظر عن الأسماء التي ذكرناها للتو (هل كان طوماس الأكويني ونيكولاس دي كوز وباسكال فلاسفة أكثر من اللاهوتيين؟ السؤال غير قابل للتقرير). يكفي التفكير في عمالقة مثل أوريجانوس، أوغسطين، بونافنتورا، مايستر إيكهارت، ماليبرانش أو شلايرماخر. هذا لا يزال صحيحا اليوم.
كان البابا يوحنا بولس الثاني، كما يعلم الجميع، في البداية أستاذا للفلسفة وكذلك خليفته، بنديكتوس السادس عشر، الذي درس أيضا الفلسفة وأعد أطروحة دكتوراه حول أوغسطين ثم أطروحة تأهيلية عن بونافنتورا، وقبل أن يعتلي عرش البابوية بفترة وجيزة، خاص نقاشا مع أحد أشهر الفلاسفة في عصرنا، يورغن هابرماس. تلقى معظم علماء اللاهوت البارزين في القرن العشرين تكوينا فلسفيا قويا.
نستحضر هنا شخصيات متألقة مثل كارل بارث (حتى لو قال، مثل سانت بول ولوثر، إنه كان حذرا من الفلسفة أو "حكمة العالم")، رودولف بولتمان (الذي اهتم بالفلسفة عن طيب خاطر)، كارل رانر ( تلميذ هايدغر)، يورغن مولتمان (قارئ ومحاور عظيم لإرنست بلوخ)، إيبرهارد يونغيل (قدم فكرة عن ثقافته الفلسفية الواسعة)، هانز كونغ (مؤلف كتاب عن عقيدة التجسد عند هيجل) أو والتر كاسبر. ويعترف الكاتب شخصياً بأنه كان تلميذا للأربعة الأواخر عندما درس الفلسفة واللاهوت في جامعة توبنغن. غرسوا كلهم في داخله فكرة سامية عن اللاهوت.
إذا لم تكن العلاقات بين الدين والفلسفة اعتباطية، فذلك لأن، حسب وصف "الفلسفة واللاهوت" الصادر عن منشورات Cerf، كل الفكر الغربي ، وليست الفلسفة وحدها، "يعيش على تراث مزدوج شكله التقليد الفلسفي واللاهوت النابع من الإيمان بالله المنزل للوحي".
يتم التعبير عن هذا التراث في الثنائيات المكونة للحضارة الغربية، إن لم يكن في وجودنا، مثل الإيمان والعقل، والحس والعلم، والهشاشة والامان. البداهة الوحيدة التي لن يكون لدينا وقت للدفاع عنها أو ذكرها هنا هي أن هناك دينا في كل فلسفة كما توجد فلسفة في كل دين، وكلاهما جزء من الإنسان العاقل الذي ننتمي إليه، وكلاهما كائن يصبو للمعرفة (عاقل) والاعتقاد.
لذلك نود أن نذكر هنا شيئًا من الروابط الحميمة بين الفلسفة والدين. فبدلاً من البدء من المؤلفين المختارين، القدامى أو المعاصرين (سيكون هناك الكثير منهم)، سنبدأ من الأشياء نفسها، أولاً مذكرين بالدين الموجود في الفلسفة، ثم بالفلسفة الموجودة في الدين، بأقصى ما يمكن من الاختصار.
1. الدين في الفلسفة
لا يمكن للعقل البشري والفلسفة أن يفكرا دون الاعتراف بديون مؤلمة لانهائية، سحيقة، بمعنى ما، تجاه الدين. إنها لانهائية لأنها تؤثر على جميع موضوعات الفلسفة: فكرة الميتافيزيقيا أو رؤية شاملة للواقع، والتي تستوعب الواقع انطلاقا من مبدإ، كانت متوقعة اولا، ثم تحققت، في الأديان الكبرى قبل أن تجد نفسها في قلب كل الأنظمة الفلسفية العظيمة ؛ فكرة الأخلاق التي تقترح الوصايا على الفعل البشري (أو التي تريد أن تجلب هذه الوصايا إلى التفكير) موجودة أيضا في الأديان (يكفي التفكير في الوصايا العشر أو عظة الجبل)، وليس من الخطأ القول إن كل الأخلاق تفترض مسبقا حساسية أخلاقية شكلتها الأديان لا محالة؛ أخيرا، إن أمل التحرر الذي ظل، منذ أسطورة كهف أفلاطون، ينشط جميع الفلسفات - حتى لو كان مجرد مسألة تحرير الذات من أشكال أخرى من الفلسفة ... - يقتفي بداهة أثر الانتظارات الخلاصية للأديان. هذه الديون، في نظرنا واضحة للغاية، سحيقة لأنها قديمة جدا ولا يدركها فلاسفة اليوم إلا نادرا، ولا شك أنهم يؤمنون (يقصد من الفعل أن يكون ساخرا قليلاً هنا)، بشكل خادع، في الاستقلالية الراديكالية للعقل الفلسفي.
يكفي القليل من التمرين في سوابق الذاكرة الأولية لإدراك هذا الأصل الديني - لما يمكن أن نطلق عليه "فلسفة الدين" بالمعنى الذاتي للدمج، أي الفلسفة المتأصلة بالفعل في الدين - وإظهار مدى دعمه لجميع الفلسفات.
هذه الديون مؤلمة أخيرا ، لأنه إذا كانت للفلسفة جذورها في الدين، فإنها تعرف أو لديها شعور بأنها لا تستطيع تحقيق كل وعودها، خاصة في عصرنا: هذا لأن فكرة الرؤية الميتافيزيقية والشاملة للعالم أصبحت إشكالية (على الأقل بالنسبة للكثيرين) في عصر ما بعد الحداثة هذا الذي يحب الاحتفال بالشظايا، غير المكتملة والمتناهية. ولأن حيوية الأديان لم تعد كما كانت، على الأقل في الغرب (ربما تكون مختلفة في أجزاء أخرى من العالم)، يمكن القول أن تلك الديون مؤلمة. ويرجع هذا إلى أن الدين، بالنسبة للعديد من الفلاسفة، لم يعد اليوم يمثل محاورا ذا مصداقية أو أساسيا: كما تريد النسخة اللاتينية للإنجيل المنشورة على نطاق واسع، كان من الممكن أن يفقد الدين مصداقيته بسبب التقدم المنتصر للعلم الحديث، بدء من نظرية التطور. كما لو كان من الضروري أن نضيف شيئا من نفس القبيل، كان على "الدين" أن يتجرع مرارة فقدان الثقة على يد ممثليه (كهنة مغرمون بالأطفال، الإرهاب الإسلامي، الأنظمة الثيوقراطية، وما إلى ذلك) أو التسكعات "المعروفة" (لا شيء أقل يقينا) في تاريخه (محاكم التفتيش، حروب الدين التي يتم تذكرها هنا طقوسا، كما لو كانت تلخص مساهمة الأديان في حضارتنا).
لذلك أصبحت العلاقات أكثر مرونة إلى حد ما (شأنا مخزيا، خاصة بين الأكاديميين الغربيين) بين الدين والفلسفة (المنتشية بحلمها بالاستقلالية)، لكننا نود أن نقول إنه في حالة الفلسفة، ثمة شكل لا يصدق من الجحود. الأمل الوحيد الذي يمكننا الاحتفاظ به (ليس لدينا وقت لتبريره هنا) هو أن هذا الجحود لن يستمر لأنه يضر بقوة الفلسفة وقدرتها على إلهام الضمائر.
إذا كان هناك حضور سري آخر للدين في الفلسفة، فهذا يرجع على وجه التحديد إلى مجال المعتقدات والالتزام وحتى الإيمان المشترك بينهما. الفرق بين الدين والفلسفة هو أن هذا البعد من الإيمان، في علم اللاهوت على الأقل، معترف به صراحة ومنعكس، في حين أن الفلسفة تريد عن طيب خاطر الاعتقاد بأنها مبنية على الحجج العقلانية فقط. يكفي قراءة أي نص فلسفي لإدراك أن الأمر ليس كذلك.
2. الفلسفة في الدين
إذا كان من الصعب التفكير في الفلسفة بدون خلفيتها الدينية، يكون العكس هو الصحيح. هذا لأنه منذ العصر المحوري على الأقل، قبل 2500 سنة، أراد الدين أيضا أن يفهم - ويجعل الناس يفهمون - هذا الذي يؤمن به.
المعرفة أو العلم الذي أنجب لليونانيين فكرة دينية عن نظام عالمي يجب أن تساعده على فهم أفضل لما هو على المحك في الدين نفسه.
منذ ظهور عبقرية الفلسفة ولأنها تتطلب أسبابا، لم يعد الدين ولا يمكن أن يكون من اختصاص مجرد وعي ساذج، فهو يريد أن يعي ذاته، الشيء الذي يستطيع إنجازه بصعوبة دون اللجوء إلى الفلسفة.
لا داعي للتذكير في هذا الصدد بأن مصطلح اللاهوت قد تم تقديمه لأول مرة من قبل الفيلسوف أفلاطون ( الجمهورية 379 أ)، الذي كان أيضا، أول من استخدم مصطلح الفلسفة، وكأن المحاسن لا تأتي فرادى.
يمكننا أن نكشف عن حضور الفلسفة في النصوص الدينية ذاتها وخاصة وأن اللغة التي حررت بها كانت، بالنسبة لكتابات العهد الجديد، حتى لا نذكر غيرها، هي اللغة اليونانية، التي كانت آنذاك اللغة العالمية للعلم والفلسفة: يبدو أن القديس بولس قد عرف جيدا الفلسفات السائدة في عصره ومصطلحاتها (سفر أعمال الرسل 17.18 يخبرنا على أي حال بأنه كان قادرا على أن يتناقش في أثينا مع "الفلاسفة الأبيقوريين والرواقيين")، حتى لو اعتبر أن حكمة هذا العالم تمثل حماقة في نظر الله.
يستحضر مدون الإنجيل الرابع لوغوس (عقلا) يبدو أنه انبثق مباشرة عن هيراقليطس، عن الرواقية والغنوص (العرفان) الفلسفي. أثبتت مساهمة الفلسفة أنها لا غنى عنها عندما كان على الإيمان أن يبرر نفسه ضد منتقديه بين المدافعين، مثل جوستين وترتليان، وآباء الكنيسة، الذين كان تكوينهم لاهوتيا وفلسفيا في آن واحد.
يرى أوغسطين، مثل كثيرين غيره، في الديانة المسيحية جواب ونتيجة البحث عن الفلسفة نفسها، وكما يعلم الجميع، من خلال قراءته "كتب الأفلاطونيين" وأفلوطين وفورفوريوس (الذي نعرف أنه كان معاديا للمسيحية بشكل عميق)، يقول إنه تحول إلى الإيمان المسيحي (اعترافات 7.10.16). يبدو أن آفاق الإيمان والفلسفة، الأفلاطونية في هذه الحالة، اندمجت فيه.
هذا التبرير الفلسفي للإيمان يصل إلى ذروته لدى طوماس الأكويني الذي، بنحو مناسب لغرضنا، هو مؤلف الخلاصة اللاهوتية والخلاصة الفلسفية (تلك التي واجه بها الوثنيين). غالبا ما يلومه الأشخاص ذوو النوايا الحسنة على جعل الفلسفة خادمة سهلة الانقياد ( ancilla ) للاهوت. كان من شأن هذا الحكم المتغطرس أن يشكك بشكل قاتل في استقلالية الفلسفة المقدسة، مما أخر ظهور الحداثة القوية. هذه القراءة الأيديولوجية والوهمية تماما لا تتوافق على الإطلاق مع ما يقوله طوماس في النص حيث تظهر صيغته التي يُفترض أنها تجرم، والمقصود به الفصل 5 من السؤال الأول من الخلاصة اللاهوتية الذي يتناول موضوع العلم المقدس (وهو اسم آخر لعلم اللاهوت).
تساءل طوماس عما إذا كانت العقيدة المقدسة تتفوق على العلوم الأخرى. من بين "الصعوبات" التي يطرحها هذا السؤال، يجادل توماس بأن العلم الذي يدين بالكثير لعلم آخر يمكن اعتباره أقل شأناً. هذا هو الحال بالتأكيد مع العقيدة المقدسة التي يعرفها طوماس ويقول إنها استعارت قدرا كبيرا من العلوم الفلسفية. ذلك ما اعترف به القديس جيروم نفسه، الذي ذكره طوماس هنا.
يقول طوماس الأكويني إن الحقيقة هي أن العقيدة المقدسة أعلى من غيرها، ولا يستطيع اللاهوتي الصارم أن يفكر بخلاف ذلك، لأنه يستمد نوره (وسلطته) من الوحي نفسه. إذا اقترض العلم المقدس من العلوم الفلسفية، فذلك، كما يقول طوماس، فلأنه يريد أن يشرح قضية العلم الإلهي. تستخدم العقيدة المقدسة العلوم الأخرى باعتبارها أقل شأنا (من الصعب ألا تكون كذلك في نظر اللاهوت) وباعتبارها خادمات. لذلك لا يقول طوماس هنا إن الفلسفة يجب أن تكون، ولا يمكن لها أن تكون سوى خادمة للاهوت. إنه يعلم جيدا أن هذا سيكون جنونا تماما وبشكل خاص لأن مصادره الفلسفية الأساسية، أرسطو وابن ميمون وابن رشد، لم يكن بها أي شيء مسيحي على الإطلاق.
هو يقول فقط أن علم اللاهوت يمكن أن يكتسب فقط من خلال استخدام الفلسفة ليُظهر لأذهاننا ما هو على المحك في هذا العلم. إن القول عن الفلسفة بأنها يمكن أن تخدم العلم المقدس لا يعني تقييد استقلاليتها، بل هو الاعتراف بشموليتها، ما يعني أن الفكرة التي تقول إن الإيمان يريد أن يكون "كاثوليكيًا" لا يمكن أن تمر.
لهذا السبب، نود أن نختتم هذا الموجز، ونأمل أن يكون ملاحظة أيقونية إلى حد ما، مفادها أن هناك حضورا للفلسفة في اللاهوت وفي الدين: إذا كان هذان يريدان إلهام العقول وجعلها تسمعهما، فلا يمكن أن يستنكفا عن استخدام اللغة التي يفهمها عقلهما والتي تستخدم في الفلسفة. هكذا توجد فلسفة في الدين تماما كما كان هناك دين لفترة أطول في كل الفلسفة.