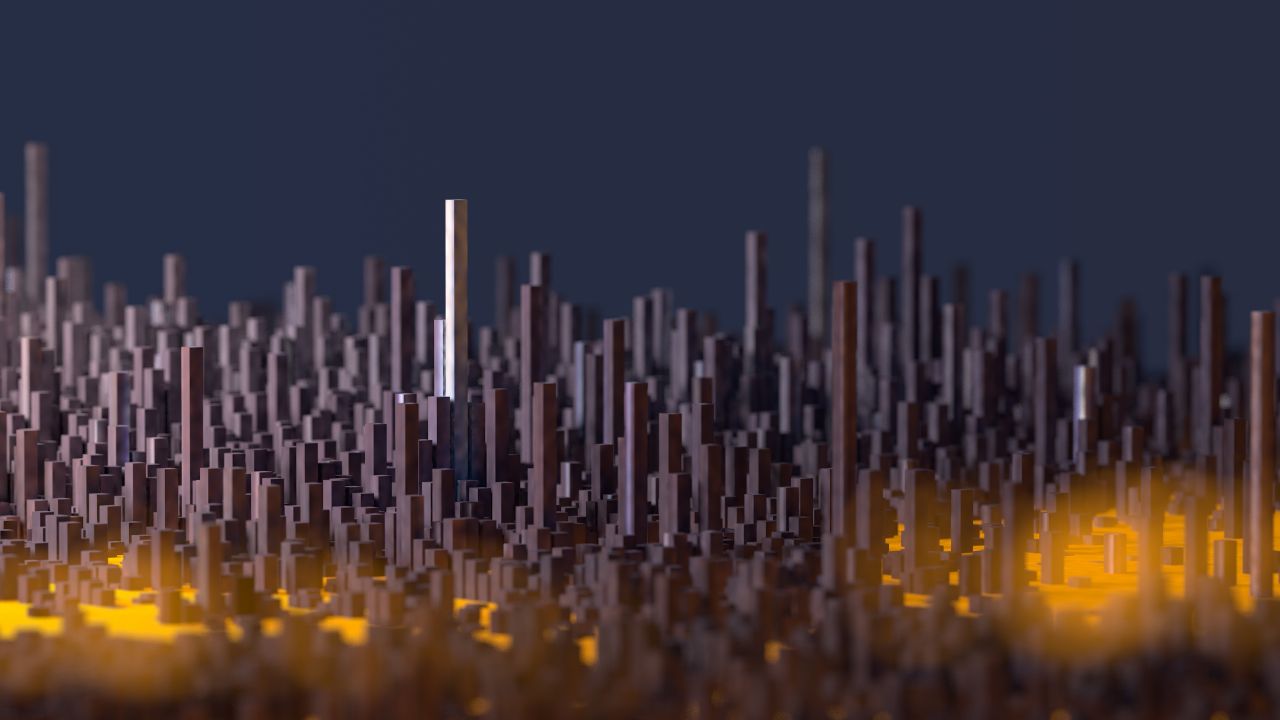تشهد بلادنا منذ سنوات حركات احتجاجية تناولتها السوسيولوجيا المغربية كظاهرة اجتماعية من خلال مجموعة من الأسئلة مثل: كيف تعبر الحركات الاحتجاجية عن ذاتها في المجتمع المغربي؟ وكيف تشتغل في ظل نسق مفتوح على الأزمة والاختلال؟ وكيف تتعامل مع معطيات النسق وردود مالكي الإنتاج والإكراه فيه؟ وكيف تدبر خطاب وممارسة الانتقال من الاحتجاج العرضي إلى الحركة الاجتماعية القوية والفاعلة في مسارات صناعة التغيير؟ وما الثابت والمتحول في صلب هذه الدينامية؟ غير أن هذا التناول يبقى ناقصا من الناحية النظرية على الأقل بحكم تغييبه للأسئلة المنصبة على علاقة هذه الحركات الاجتماعية بالأحزاب السياسية. من أجل المساهمة في ملء هذه الثغرة، أقترح هذه الترجمة العربية للمقدمة التي أفردها فردريك ساويكي لكتاب جماعي حول نفس الموضوع تم تأليفه تحت اشرافه .
الطريقة التي تم بها عموما التفكير في الحركات الاجتماعية والأحزاب السياسية داخل مجال العلوم الاجتماعية وعلاقاتها مؤشر ممتاز على آثار الجهل الناجم عن تجاوزات تقسيم العمل العلمي.وقد كتب ستيفاني ديشيزيلس وسيمون لوك في تقديمهما لهذا البحث؛ أن "المتخصصين" في الحركات الاجتماعية وأولئك المهتمين بالأحزاب، ولكن أيضا المهتمين بنقابات العمال والمجال الجمعوي، طوروا مع مرور الوقت اشكالياتهم وأدوات التحليل الخاصة بهم عن طريق التقليل شيئا فشيئا من مواجهتهم جميعا، لمغبة الافراط في استقلالية مواضيعهم البحثية.
وحيث يفضل الأوائل الامتيازات المرتبطة بمسألة تعبئة الموارد البشرية والمادية والمعرفية والرمزية اعتبارا لظروفها السعيدة وآثارها (خاصة تلك المتعلقة ب"ببنية الفرص السياسية"، فإن الآخرين يميلون إلى إعطاء الأولوية لمسألة إضفاء الطابع المؤسسي (البيروقراطية، و المهننة، والكارتيالية ...)، مع إيلاء اهتمام خاص من جانب المتخصصين في الأحزاب لاختيار القادة و"المطالب"، وبعبارة أخرى، أعمال الوساطة التي تقوم بها المنظمات السياسية.
وعلى الرغم من أنها لم تستبعد تماما، فإن مسألة إضفاء الطابع المؤسسي على هذا القطاع أو ذاك "قطاع الحركة الاجتماعية" (البيئة، والنسوية، والدفاع عن حقوق الإنسان، وما إلى ذلك) حظيت بأقل قدر من الدراسة في حالة النقابات والأحزاب السياسية. وكما تشير ماري فينسود كاتزنستين، "يقوم أخصائيو الحركة الاجتماعية عادة بإضفاء الطابع المؤسسي على التسريح"، ويرون أن "الحركات الاجتماعية تكون بالضرورة خارج المؤسسة".
على العكس من ذلك، فان عمل التعبئة المتعددة الأشكال الذي تقوم به الأحزاب لتعزيز أسنادها أو الفوز بأخرى جديدة، من أجل فرض رهانات معينة أو تعميم تمثلات محددة، قد تم التخلي عنه على نحو متزايد لصالح مماثثلة هذه الأخيرة مع مقاولات تستخدم الموارد العمومية وتتلاعب بقواعد مؤسسية من أجل ارساء وتثبيت احتكارها الجماعي للمنافسة الانتخابية . عندما تخضع للتحليل، غالبا ما يتم اختزال التعبئة الحزبية في استراتيجيات التواصل، التي شاركت في وضعها الوكالات المتخصصة في الميدان، قصد التوجه بها بعد ذلك لوسائل الإعلام خلال الحملات الانتخابية. وحتى الأحزاب التي شكلت حديثا مثل الأحزاب البيئية أو أحزاب الخضر في بلدان أوروبا الوسطى والشرقية خلال الموجة الثالثة للدمقراطة تمت دراستها على نحو أكثر تواترا من الزاوية التنظيمية أو المؤسسية بدلا من وجهة نظر المجتمع.
اجمالا، الكل يسيير كما لو أن المتخصصين في الحركات الاجتماعية، وخصوصا "الحركات الاجتماعية الجديدة" المعروفة بمناهضتها للسلطوية والتراتبية، ساهموا عن غير قصد في إنتاج تمثل مبتهج لحركات ممأسسة بشكل ضعيف تلتجئ أساسا لإجراءات احتجاجية، في حين أن المتخصصين في الأحزاب والنقابات قد تبنوا تمثل المنظمات التي تتسم بمهنية عالية، مدفوعة في المقام الأول ببقائها وباستخدام وسائل الإقناع التقليدية تقريبا. ومن الغريب بعض الشيء، في هذه الظروف، أن الاعتمادات المتبادلة بين هذه العوالم الثلاثة من العمل الجماعي تم التفكير فيها بطريقة وظيفية، وأنها أدركت على مستوى ماكرولوجي أو بنيوي. في هذا المنظور، من المتوقع أن تنمو الحركات الاجتماعية لرفع مطالب عن طريق الاحتجاج؛ مطالب لا تتبناها الأحزاب السياسية (أو النقابات وجماعات المصالح)، وتحظى بالمزيد من الفرص للاستماع لها ما دام نظام الأحزاب تنافسيا للغاية. بينما على النقيض من ذلك، يبدو أن الأحزاب أكثر تقبلا للمطالب المرفوعة من قبل الحركات الاجتماعية بحيث أن تلك المطالب يمكن لها أن تساعدها (الأحزاب) على ربح الاستحقاقات، وأنها تتفق مع مؤشرات هويتها.
كانت هذه الاشكالية محط انتقادات كثيرة على مدى العقدين الماضيين. الدور المركزي دوما في الحركات الاجتماعية، الذي يقوم به المناضلون المتعددو الالتزامات الذين استفادوا من تنشئة اجتماعية داخل المنظمات الشبيبية والمنظمات الدينية والنقابات والأحزاب السياسية، وكذلك المساعدة اللوجستية، الحاسمة أحيانا، الممنوحة لهؤلاء من قبل الأحزاب والمنتخبين والنقابات، كل ذلك جرى التأكيد عليه. وبعيدا عن دراسة التعبئات الخاصة، تميز باحثون فرنسيون يشتغلون على الأحزاب بتسليط الضوء على الدور المهيكل (بكسرة تحت الكاف) لبعض الأوساط السوسيوسياسية. وقد أدت هذا الأبحاث إلى أن يوضع في قفص الاتهام تصور مجزأ للتنظيمات الحزبية والنقابات والجمعيات ومفصول عن الحركات الاجتماعية. ان عملية تحديد شبكات الفاعلين المتعددي المواقع، التي هدت الى وضع مفهوم "الوسط الحزبي"، استهدفت بالضبط التأكيد على أن "الدوائر الاجتماعية"، بتعبير ألان دوجين، التي تنسج علاقات بين الفاعلين داخل هذه الأوساط ليست فقط علاقات تبادل أو اعتراف متبادل، ولكنها أيضا علاقات دلالية مؤسسة على معايير وقيم مشتركة في جزء منها.
وبعبارة أخرى، فإن الأحزاب السياسية في الأنظمة الديمقراطية لا يمكن أن تكون مؤسسات مغلقة، ومن الصعب أن تكون كذلك، حتى وإن كانت درجة انفتاحها غير متكافئة، كما ذكر آنجيلو بانيبيانكو. ويجب على زعمائها ومسؤوليها المنتخبين التجاوب مع المطالب التي تنادي بها المنظمات والحركات الاحتجاجية بجميع أنواعها، ولا سيما عندما تنبثق عن مجموعاتها المرجعية، وتجد لها صدى داخل الحزب - وليكن حتى داخل الفصائل التي تشكل أقليات - و / أو تضع في الصدارة نفس القيم التي يدافع عنها الحزب. تماما كما سوف يوضح ببراعة ماثيو دوبويس لاحقا في شأن موقف قادة الحزب الديمقراطي الاشتراكي من الحركة الطلابية الألمانية في سنوات ما بعد 1968، فان المطالب السلمية، والدعوة إلى دمقرطة التعليم العالي، مع زيادة المساواة بين الرجل والمرأة، كل تلك المطالب التي نادت بها هذه الحركة تم تجاهلها من قبل الحزب الديمقراطي الاشتراكي، مع أنها جاءت على لسان الاشتراكيين الشباب وأنها تتماشى مع هوية الحزب.
ومع ذلك، فإن الآليات التي يتم من خلالها صعود وترتيب "الانتدابات" هي متنوعة. ونادرا ما تؤدي (الآليات) إلى تعيين بعض أعضاء أو قادة الحركات داخل الحزب، كما يتضح مثلا من الصعوبة التي اعترضت الحزب الاشتراكي والحزب الشيوعي في فرنسا عندما أرادا أن يستضيفا على قوائمهما مرشحين ينشطون في جمعيات الشباب أو الأحياء وينتمون لعائلات مهاجرة من شمال أفريقيا. درجة تمركز الحزب، الخصائص الاجتماعية لفريق القيادة، هرمه الديموغرافي، كونه في المعارضة أو في الحكومة، نمط الاقتراع المعتمد في الانتخابات، كل ذلك يحدد جزئيا هذه الدرجة من الانفتاح. إن الأطروحة التي قدمها في هذا الكتاب كل من غريغوري هو وكليمان ديريمو حول استقلال ذاتي متزايد للحقل السياسي وفضاء الحركات الاجتماعية، وبالتالي، حول تدوير أو مهننة "علاقات الأحزاب بالحركات الاجتماعية"، تبدو لنا من الآن قابلة للنقاش إذا ما جرى تصورها كاتجاه عام لا رجعة فيه، وليس كوضع مؤقت وغير مستقر يتعين شرح أسبابه حالة بحالة.
إن التمييز بين قطاعات الأنشطة (النقابية، الجمعوية، الحراكية، الحزبية) الذي يتجلى من خلال انبثاق وتوطيد المؤسسات المتخصصة التي لها غاياتها الخاصة والمتنافسة في جزء منها هو بالطبع شيء لا يمكن إنكاره، حتى لو أخذ أشكالا مختلفة تبعا لطبيعة الأوساط الحزبية ووفقا للبلد. ما وصفه جاك لاغروي ب"التوظيف" (fonctionnalisation) هو في الواقع الطريقة الرئيسية لإضفاء الشرعية على النقابات أو الأحزاب أو بعض منظمات الحركات الاجتماعية. وباعتبارها مؤسسات، فإنها تبرر سبب وجودها من خلال محاولة جعل جماهيرها يعتقدون أنها تؤدي دورا لا يمكن الاستغناء عنه، بله حصري. وبذلك، فإن أي "خروج من الدور" يبدو انتهاكا صارخا من الصعب تبريره: كل نقابة تدعو إلى التصويت لحزب أو تتجاوز إطار الدفاع عن المأجورين لاقتراح إصلاحات أكثر شمولا، كل حزب يستخدم الانتخابات لزعزعة الأوضاع أو كل حركة اجتماعية تقدم للانتخابات مرشحين بحكم مناصبهم الا ويتعرضون لوابل من الشجب والتنديد من الناطقين باسم المنظمات المتنافسة كل في مجال اختصاصه، ولكن أيضا من قادة المنظمات العاملة في حقول أخرى الذين ينتقدون في الحالة الأولى تسييس الاقتراع العام وفي الحالتين الثانية والثالثة عدم احترامه، ما يؤدي الى الخلط بين الأدوار وغياب الكفاءة.
بالمثل، على المستوى الفردي، القادة والمناضلون الذين تجاوزوا الحدود المؤسساتية يتعرضون لفضحهم كمتصرفين بالنيابة عن مصالح أخرى ( "بخلفيات معينة")، ويفقدون هكذا كل ائتمان. ليليان ماتيو، في مساهمتها في هذا الكتاب، أشارت بدقة الى بعض المعضلات التي يتورط فيها الأخيرون عند انتقالهم من مجال إلى مجال آخر. الى أي مدى يمكن التدخل في إطار اقتراع سياسي؟ بأي شكل يتم ذلك؟ هل يجب على زعيم أو ناشط في الحركة الاجتماعية أن يستقيل من منصبه إذا كان مرشحا للانتخابات؟ هل ينبغي أن نقبل حضور ممثلين عن حزب سياسي في مظاهرة ما؟ هذه الأسئلة هي المعضلات العملية التي توجب على الفاعلين تدبيرها على أساس اعتبارات سياقية، ولكن أيضا ثقافية كما سنرى فيما بعد، كما يجدربالمؤسسات أن تستجيب لتلك المعضلات عن طريق إصدار القواعد الرسمية وتطوير مدونات قواعد السلوك الملزمة بشكل غير متساو.
بالفعل، كل نظام سياسي، ولكن أيضا كل وسط حزبي وكل مجموعة ناشطة حزبية، بسبب تاريخها الخاص ومكوناتها الاجتماعية وأهدافها، تخترع قواعدها الخاصة التي تحكم العلاقات بين مختلف الأنماط التنظيمية التي تستثمر في الغضاء العام المحلي أو الوطني. التدخل في الشأن الانتخابي للنقابات، وجماعات المصالح والمتحدثين باسم والحركات الاجتماعية، ولكن أيضا الكنائس، يتم الترحيب به كثيرا في الولايات المتحدة - حيث يمر أساسا عن طريق تمويل الأحزاب والمترشحين - قياسا لما هو عليه الحال في فرنسا المعاصرة. وهناك حاجة إلى برنامج للبحوث المقارنة هنا لمراعاة هذه التوجهات الدولية. وعلاوة على ذلك، ليس كل المنظمات، وجميع الدوائر الاجتماعية والسياسية داخل نفس النظام السياسي تعتمد نفس الموقف فيما يتعلق بالمجال السياسي، ليس لديهم نفس المفهوم لتقسيم الأدوار. ويتضح ذلك، على سبيل المثال، من خلال تنوع مواقف المنظمات النقابية في فرنسا فيما يتعلق بالقضايا الانتخابية والسياسة بشكل عام، وتطورها على مر الزمن.
دراسة كاريل يون حول القوى العاملة، استنادا إلى مفهوم "أسلوب المجموعة" المستعارة من نينا إلياسوف وبول ليشترمان، تذكر ببراعة أن رسم الحدود بين النقابي والسياسي يختلف من اتحاد نقابي إلى آخر، ويحتل مكانا مركزيا غير متكافئ كمؤشر هوياتي بسبب تاريخ وسوسيولوجيا كل واحد منها. الطريقة التي يتم بها رسم الحدود تشكل مع ذلك مؤشرا هوياتيا وعنصر أساسيا في استراتيجية تمييز الكونفدراليات عن بعضها البعض. من خلال إعادة استثمار انجازات سوسيولوجيات الالتزام و النزعة النصالية والحركات الاجتماعية والانتباه إلى كل الاعتمادات المتبادلة والعقيدة المذهبية التي تنتجها المؤسسة، يوضح كاريل يون أن أخذ مسافة بعيدا عن السياسة يجسد أولا تقادما في الأدوار. على الرغم من أن أطروحته لا تختزل فقط من خلال هذا المنظور الفريد، فإنها تثبت أنه لمن قبيل المفارقة أن يبرهن العديد من نقابيي الFO ( القوة العاملة)على مستوى عال من الكفاءة السياسية وكيف أنهم ذوو التزامات حزبية وماسونية ويحترمون حظر ذكر الأفضليات السياسية في الساحات النقابية، أو إدراج النشاط النقابي ضمن مساع استراتيجية، أو أيضا معالجة قضايا ينظر إليها على أنها غير نقابية.
من خلال الافتراض بأن أساليب المجموعات هي النتيجة التوافقية لخصائص الثقافة المدنية الوطنية، وتاريخ المنظمات الناشطة، والممتلكات الاجتماعية لأعضائها، والأدوار الاجتماعية الممأسسة التي ينسبها شركاؤهم إليهم، تمكن ن. إلياسوف وب. لشترمان في الواقع من التوفيق بين إنجازات النزعة التفاعلية الرمزية والنزعة المؤسساتية الجديدة وسوسيولوجيا الاستعدادت. الغرض من مفهومهما هو توفير أداة مناسبة لفهم الأطر التي تهيكل المقول والمفكر فيه ضمن مجموعة مع الإصرار على أن تعريف حدودها وطريقة التفكير في العلاقة بالخارج (حدود المجموعة) يشكلان، بالإضافة إلى الروابط الداخلية (الكفالات الجماعية) والمعايير الللغوية (معايير الكلام)، الأبعاد الثلاثة المكونة لأسلوب المجموعة.
ولأن البناء المؤسسي والبراغماتي للحدود بين الحقول لا يزال مجالا للبحث يجري التحقيق فيه إلى حد كبير، فإن الباحثين المشتغلين على الحركات الاجتماعية وأولئك المشتغلين على الأحزاب السياسية سيستفيدون بالتالي من الاعتماد على هذا المفهوم لتعريف الأساليب الجماعية، أو، بالنسبة للمجموعات الأكثر مأسسة، لتحديد الثقافات التنظيمية التي تسمح لعلاقاتها بأن تبنى أو بالعكس تمنعها من ذلك.
ومن النافل القول إن فكرة "بنية الفرص السياسية" تقع على مسافة بعيدة من هذا المنظور البنائي والسوسيو - تاريخي. فمن خلال تحميل صورة حقلين لا يتسرب شيء من أحدهما إلى الآخر،أعطي (المفهوم) مصداقية لفكرة عن تعارض جذري بين السياسات خارج المؤسسات والسياسات المؤسسية، بين الحركات الاجتماعية والأحزاب السياسية. لذا، فإن هذا المفهوم يؤدي إلى القيام باقتصاد التفاعلات بين العناصر الفاعلة في مختلف هذه المجالات ، والضربات التي تتبادلها فيما بينها، وتطور تصوراتها للحالات خلال عمليات التعبئة، ودور السابقين، والتحالفات التكتيكية أو الاستراتيجية، والآثار الناتجة عن تعدد مواقعهم.
ومن خلال التسليم بأنه من الممكن تحديد المتغيرات التي تفسر بطريقة سببية ظهور أو نجاح أو فشل كل حركة اجتماعية، ولكن ليس فقط حركة اجتماعية معينة، يجد أتباع هذا المفهوم في كثير من الأحيان أنفسهم أمام نمذجات تتلاعب بالواقع التاريخي وتظهر في الأخير على أن قدرتها على التفسير غير كافية.
نحن نعتبر أن الباحث، عندما يهتم بتعبئة معينة ويبذل مجهودا لإدراك المعاملات والتواطؤات بين مختلف الفاعلين في الحقول المعنية، ليس له من خيارر سوى الاكتفاء ب" سوسيولوجيا الحادث" واتباع تعليمات وويليام سيويل، أي قبول "فرضية الأحداث الراديكالية" وايجاد مسلك بديل بين " الاستراتيجية التاريخية" و" الاستراتيجية السوسيولوجية" . بالفعل، فبقدر ما تغرق التعليمة الأولى "السيرورة السببية الحاسمة (...) تحت سيل من التفاصيل دون عزلها بطريقة كافية حتى تظهر ديناميتها الخاصة بشكل واضح"، بقدر ما تميل التعليمة الثانية، "اذا ما سمحت بأن تميز على نحو فعال الديناميات السببية لعامل ما"، (تميل) "إما الى إرجاع العوامل السببية الأخرى الى السبب الوحيد المختار (...)، وإما الى النظر اليها باعتبارها مجرد خلفية".
يمر هذا المساك البديل، حسب وليام سيويل، عبر رفض أي تفسير غائي، ولكن يمر أيضا من خلال اللجوء الى "سرد متعدد الأسباب" يلتزم بأن يدرك في آن واحد التحولات البنيوية الأساسية التي جعلت الحادث ممكنا، وما أسماه، تبعا لمارشال ساهلينز، ب"بنية المصادفة".
وعن طريق سلوك نهج قريب من نهج ميشال دوبري، رافع وليام سيويل من أجل النظر بعين الاعتبار الى الطابع المؤقت للحادث، الضروري بالنسبة للصراعات التأويلية الهادفة الى منحه معنى، مصالحة هكذا بين البنوية والتفاعلية المتبادلة.
وبهذه الروح، فإن التحليل المموضع والمقارن، "التهايؤي" الذي اقترحه كليمان ديريمو و غريغوري في الصفحات التالية من أجل تحليل العلاقات بين أحزاب ومنتخبين وتعبئات جماعية، يوضح أهمية تحويل النظرة من المستوى الماكروولوجي إلى المستوى الميكرولوجي، من الاعتمادات المتبادلة إلى التفاعلات. فمن خلال تسليط الأضواء على حسابات الفاعلين، مقاولي التعبئة مثل محترفي السياسة، عبر وضع الأواخر في سياق معين، يتبين إلى أي مدى تكون حظوظ تعبئة ما في ادراج مطلبها ضمن الأجندة السياسية وفي إيجاد دعامات داخل الحقل السياسي غير قابلة لأن تختزل في سلسلة من المتغيرات (تواطؤ بين الفاعلين، شساعة، وساطة وشكل التعبئة، نوع القضية).
ولكن عملهم يشير أيضا إلى أهمية الأفق والإيقاع الانتخابين. في مقال لي منشور منذ مدة طويلة، كنت قد استوحيت ميشال دوبري من أجل تحديد، كما فعل الأخير في حالات الأزمات السياسية، الخصائص البنائية للحظات الانتخابية في الأنظمة الديمقراطية، من خلال مماثلتها بمراحل الاعتماد المتبادل الموسع الذي تحدده ثلاث سمات رئيسية تشكل نسقا:
1- اضفاء الطابع الدرامي على الضربات المتبادلة كلما اقتربت لحظة الافراج عن نتائج العملية الانتخابية؛
2 - الميل إلى "فتح مواقع المواجهة" أو الساحات؛
3. الحذر المعمم من الجهات الفاعلة.
ورغم أن التحليل أشار إلى الطبيعة المسامية للظروف الانتخابية، إلا أنه لا يزال منصبا على جماعات المصالح وعلى عمل الممثلين المنتخبين والأحزاب لأجل توقع طلباتهم أو إدراجها أو الاستجابة لها. ومن الضروري الآن أن نعكس وجهة النظر هاته ونشجع تطوير الأبحاث عن كيفية توقع الاستحقاقات الانتخابية من قبل مبتكري القضايا الذين يجب على الفاعلين السياسيين أخذهم بعين الاعتبار لضبط أجوبتهم التي يوافونهم بها. إلى أي مدى يتوقع مقاولي ومبتكري التعبئة المواعيد النهائية للانتخابات؟ إلى أي مدى تكبح الأخيرة حساباتهم وتلك التي يقوم بها الفاعلون السياسيون وتؤثر على الاهتمام والمعنى الذي يعطيه الصحفيون للتعبئة؟ هناك العديد من الأسئلة البحثية من هذا القبيل التي ينتظر استكشافها على أحر من الجمر.
وللقيام بذلك، ينبغي النظر الى الإیقاع الانتخابي (تاریخ الموعد الانتخابي المقبل، نمط الاقتراع، الرهان المؤمل من الانتخابات ...) والى الأفق الانتخابي (التوقعات التي یستخلصھا الفاعلون) لا كمتغیر ولا ك"اكراه خارجي" على شاكلة بنية من الفرص السياسية، ولكن يتعين النظر اليهما كبنية بالمعنى الذي قصده أنتوني جيدنز. دعوني أذكر بأنه بالنسبة لهذا الباحث السوسيولوجي البريطاني تكون "الخصائص البنائية للأنساق الاجتماعية هي في نفس الوقت هذه الظروف ونتائج الأنشطة التي يقوم بها الفاعلون الذين هم جزء لا يتجزأ من هذه الأنساق"، وأن " القواعد والموارد المرصودة بشكل متكرر داخل المؤسسات هي أهم عناصر الجانب البنائي ". وبعبارة أخرى، "البنائي ليس فقط إكراها، بل هو في نفس الوقت مكره (بكسرة تحت الراء) ومؤمل [...] [و] وليس له وجود مستقل عن معرفة الفاعلين بما يفعلونه من أنشطة في حياتهم اليومية". ومن هذا المنظور، يجب إدراك مواعيد الاستحقاقات الانتخابية على حد سواء باعتبارها أفقا للعمل وقاعدة في اللعبة السياسية البناءة التي تشكل في ذات الوقت إكراها ومصدرا للفاعلين. ويتم إنتاج الأفق الانتخابي بشكل مشترك من قبل جميع الجهات الفاعلة المعنية بالانتخابات التي تمنح لهذا الإقتراع أو ذاك معناه، عن طريق الرجوع في أغلب الأحيان إلى الماضي؛ الذي ما فتئ يعاكسها متى عاد في صورة مؤسسة.
إن تحليل الحركة التي قادها باحثون فرنسيون، والمعروفة تحت تسمية "Sauvons la recherche"، خلال 2005/2004 بقدم لنا نمودجا مثاليا عن الكيفية التي يؤثر بها الأفق الانتخابي في الفاعلين المنخرطين في التعبئة. وهذه العملية هي من القابلية لأن يعبر عنها بحيث تكون هذه التعبئة قابلة لأن تقارن بتعبئة السنة السابقة وبتلك التي جرت في السنوات اللاحقة، في ارتباط بالمجال المهني نفسه.
في ديسمبر 2003، صاغت مجموعة من الباحثين، معظمهم علماء أحياء باريزيون ينتمون لمعاهد Cochin, Necker, Curie ،Pasteur عريضة بعنوان "صمت الحملان". تطالب هذه العربضة الحكومة بإعادة 550 وظيفة قانونية تحولت إلى عقود محددة المدة، وإعادة فتح مختبرات بحثية ألغيت ائتماناتها لأسباب تتعلق بالميزانية وتنظيم نقاش وطني كبير بشأن البحوث. هذا، وقد تم نشرها في 7 يناير 2004 على شبكة الإنترنت. شهذت هذه المبادرة نجاحا غير متوقع. انتشرت الحركة بسرعة في المدن الجامعية الرئيسية حيث تم تشكيل جمعيات محلية وتنظيم اجتماعات عامة، وجمع التوقيعات والقيام بمظاهرات. بقاء موقع « Sauvons la recherche »مفتوحا على نطاق واسع، وإعداد قائمة المواد المنشورة يسرا التبادلات وأزال الحواجز بين مختلف التخصصات، وساهم في نشر اسم الحركة، وكذا شعاراتها وحججها.
نجاح التعبئة، الذي سيؤدي إلى الاستجابة للمطالب الثلاثة المنادى بها في أبريل 2004، فسر قدرة محركيها الأوائل على تحقيق الاستفادة القصوى من الإيقاع الانتخابي. وفعلا، قبل عام من ذلك، كان الإعلان عن تجميد الإنفاق العام على البحث وإصلاح المنظمات الكبيرة قد أثار بالفعل العديد من ردود الفعل العدائية والأعمال الاحتجاجية. ولم تجد هذه الأخيرة آذانا صاغية. ثم صدرت الانتقادات من الهيئات الممثلة لمجال البحث العلمي: من جهة، هناك أعضاء من اللجنة الوطنية للمركز الوطني للبحث العلمي (CNRS) ورؤساء الشعب في المجلس الوطني للجامعات (CNU)، ومن جهة أخرى، هناك النقابات الرئيسية الأخرى : النقابة الوطنية للباحثين العلميين (SNCS)، النقابة الوطنية للتعليم العالي (SNESUP)، وكلتاهما عضو في الاتحاد النقابي الوحدوي (FSU)، والنقابة العامة للتربية الوطنية (SGEN) التابعة لمركزية CFDT والنقابة الوطنية لعمال البحث العلمي (SNTRS) التابعة لمركزية CGT. على هامش النقابات، أطلقت مجموعة صغيرة من علماء باريس بهذه المناسبة مبادرتين لاقتا نجاحا باهرا، خاصة بين علماء الأحياء الذين تأثروا بالتخفيض ببنسبة 30٪ من الائتمان في المعهد الوطني للصحة والأبحاث الطبية (INSERM).
في مرحلة أولى، تم في مارس 2003، تأسيس موقع "البحث في خطر" من طرف عالم الرياضيات برتراند مونثيبير بالتعاون مع هنري أودييه، عالم كيمياء وعضو في المكتب الوطنى ل(SNCS)والأحيائي آلان تروتمان، مدير الأبحاث في (CNRS). وفي مرحلة ثانية، جرى يوم 4 أبريل 2003 إطلاق نداء تبناه الجمع العام للعاملين في مختبرات البحث العلمي بمعهد كوشين حيث تضمن إدانة ل"للموت المعلن للبحث العمومي." هذا النداء، المسمى ب"نداء كوشين" في إشارة ساخرة إلى نداء جاك شيراك في ديسمبر عام 1978، والذي نشره موقع "البحث في خطر"، وقع عليه 7500 شخص وسبق بأيام قلائل عملية الدفن الرمزي للبحوث الفرنسية التي نظمتها نفس المجموعة يوم 10 أبريل 2003 أمام البانتيون في باريس، تمكن من حشد ألفي شخص. في اليوم نفسه، دعت تنسيقية نقابية مكونة من الباحثين المنتمين ل(CFTC, SGEN-CFDT, SNIRS-CGC, SNCS-FSU, SNTRS-CGT) إلى تظاهرة أمام المقر الباريسي لINSERM. لم يكن لهذه الاحتجاجات بعد ذلك سوى تأثيرهامشي ولم تقوض قرار حكومة رافاران لتنفيذ مشاريعها الرامية لاصلاح CNRS وINSERM وإزالة الوظائف القانونية لتحل محلها العقود المحددة المدة. وقد ظهر في الأخير أن الحكومة الفرنسية اتخذت ازاء احتجاجات الباحثين نفس الموقف الذي تبنته حيال النقابات التي نددت في نفس اللحظة بإصلاح نظام التقاعد الذي جاء به وزير الشؤون الاجتماعية، فرانسوا فيون.
هذا الموقف الحكومي لم يكن له بالتأكيد أثر لا يذكر في اتساع دائرة السخط التي شملت أوساط البحث العلمي طيلة سنة 2003 وفي الحاجة المسيسة للباحثين الأكثر تعبئة إلى تغيير التكتيكات . أصبح إذن منظور الاستحقاق الانتخابي حجة قوية في أيدي هرلاء الأخيرين لإقناع زملائهم باللجوء إلى أشكال عمل أكثر راديكالية أو على الأقل أكثر إثارة. هذا ما أدى بالمبادرين بعريضة "صمت الحملان"، إلى أن ترفق بدعوة لمديري المختبرات والفرق بالاستقالة محددين (9 مارس 2004) كآخر أجل، ما يعني عمدا اثني عشر يوما قبل الجولة الأولى من الانتخابات الجهوية. استراتيجية الأيدي المتشابكة هاته، التي أجاد وضفها طوماس شيلينغ، على الرغم من مخاطرها، تسمح بشكل رمزي للباحثين بالكشف عن قراراتهم؛ كما أنها تعطي للنشطاء الوقت لتوسيع التعبئة وإقناع مديري المختبرات بالانضمام إلى الاحتجاج، كما أن من نتائجها أيضا حمل الحكومة على محاولة تهدئة الحركة عن طريق اقتراح تنازلات قد يعرض تقديمها مصداقيتها للخظر.
لكن منظور الانتخابات الجهوية الذي تننته المعارضة والصحافة كاختبار لحكومة وصل مستوى شعبيتها إلى الحضيض - وخاصة بسبب السخط الناجم عن إصلاح أنظمة التقاعد في عام 2003 - أثر أيضا على حسابات قادة الأحزاب اليسارية. لقد دفعهم إلى أن يساندوا الحركة بهمة ونشاط. هؤلاء لم يكتفوا بشجب القرارات الظالمة للحكومة التي "تفضل أصحاب المطاعم على الباحثين"، وتوثر"الزبونيةية" على "النفقات المستقبلية"، لكنهم ساندوا كذلك الحركات والاجراءات الاحتجاجية.
أبانت هذه الاستراتيجية عن فعاليتها. استحوذت على اهتمام وسائل الإعلام الوطنية والإقليمية التي خصصت الكثير من افتتاحياتها وروبورتاجاتها للظروف التي يشتغل فيها الباحثون، وذلك ابتداء من فبراير إلى مارس 2004. كما قادت رئيس الجمهورية إلى الخروج عن صمته يوم 17 مارس 2004، في شكل رسالة موجهة إلى آلان تروتمان، المتحدث باسم الحركة. التزم فيها بمعالجة "مسألة المنافذ للباحثين الشباب" من خلال اعتماد قانون للتوجيه والبرمجة يحدد "مستوى توظيف الباحثين النظاميين في المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والتقني شأنهم في ذلك شأن أساتذة الجامعات والباحثين ".
وهكذا، فإن الإيقاع الانتخابي قد أثر على نتائج الحركة باعتبارها أفقا تحكم في حسابات مجموع الفاعلين: باحثون، فاعلون سياسيون، صحافيون. من الممكن لنا ايجاد حجة مصادة من خلال ملاحظة أنه على الرغم من تعبئة بنفس القدر من الأهمية، لم يسمح عدم إجراء الانتخابات في عامي 2005 و 2006 للباحثين بمحاصرة المظاهر التي يعتبرونها مخالفة لاقتراحاتهم في القانون الإطار المعتمد في متم 2005 باسم" الميثاق من أجل البحث"، ولم تسمح التعبئة في أوساط الطلبة والأساتذة الجامعيين بعد أشهر قليلة من الانتخابات الرئاسية سنة 2007 بمساءلة قانون الاستقلالية الذاتية للجامعات الصادر خلال فصل الصيف.
عاب ويليام سيويل على أنطوني غيدنز الخاصية غير الدقيقة والفضفاضة لتعريفه للبنيوي بوصفه مجموعة من القواعد والموارد المتاحة للجهات الفاعلة. حاول توضيح ملامح الحدود عن طريق تمييز الموارد عن القواعد مع التركيز بالخصوص، ضمن هذه الأخيرة، على أهمية الخطاطات الثقافية المعتبرة بالمعنى الأنثربولوجي "ليس فقط كمجموعة من التعارضات الثنائية التي تزود المجتمع بأدوات التفكير الأساسية، ولكن أيضا كمواضعات مختلفة، وصفات، سيناريوهات، مبادئ عملية وعادات لغوية وسلوكية تم اكتسابها باستخدام تلك الأدوات ". وبالنسبة له، فإن التوزيع الملموس للموارد المختلفة (البشرية وغير البشرية) هي وسائل عمل تتشكل قيمتها ونطاقها من خلال هذه الخطاطات الثقافية. بعض هذه الخطاطات خاص بقطاعات محددة من المجتمع، وبعضها الآخر يشترك فيها الجميع على نطاق أوسع.