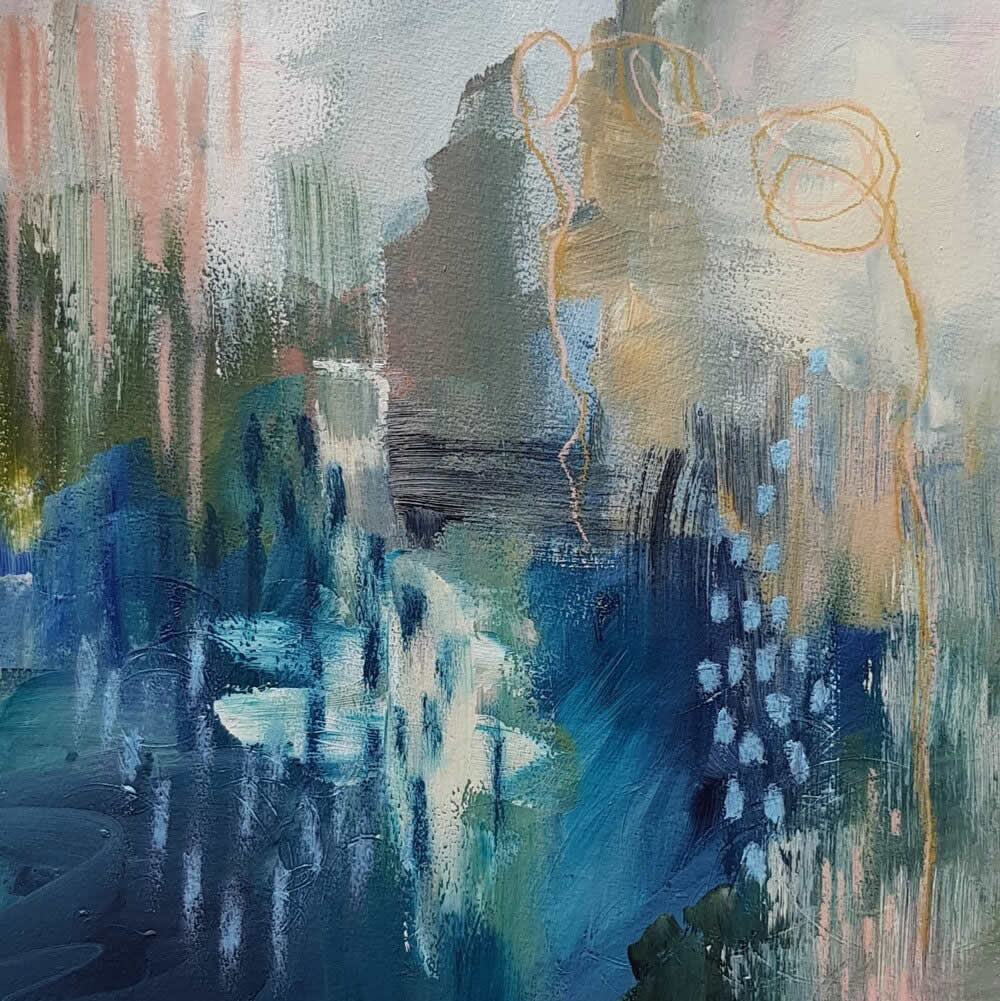الملخص:
لقد توجهت اهتمامات عالم النفس ستاليسناس دوهين [i]Stanislas Dehaene، على وجه التحديد إلى تحليل ميكانيزمات فكرنا، استناداً إلى العلوم العصبية. أما هدفه من ذلك فهو فهم، دروب تفكيرنا الأكثر ذاتية وحميمية، بأكثر ما يمكن من الدقة العلمية. على هذا الأساس توجهت أسئلة محاوره بالتحديد إلى كشف بعض المفارقات الإبيستيمولوجية التي من شأنها أن تنجم عن التقاء حقل علم النفس بالحقول المعرفية والعلمية الأخرى التي يتوجه نحوها ستاليسناس دوهين، كالعوم العَرفَنِية Sciences cognitive والعلوم العصبية Neurosciences.
الكلمات المفتاحية: علم النفس؛ فلسفة؛ العلوم العَرفَنِيَّة؛ العلوم العصبية.
متن الحوار:
ترغب في إنشاء علم جديد للحياة الذهنية، لماذا؟
بداية ً، وحتى أسجل مقاربتي في تاريخ علم النفس الطويل أصلا: فهذا تعريفٌ سبق أن اقترحه أحد مؤسسيه إبان القرن التاسع عشر، ألا وهو وليام جيمس William James. إضافة إلى ذلك، أعتقد أن علم النفس يشكل أحد الحلقات الأساسية لعلم الحياة الذهنيةLa vie mentale. فهذا العلم العابر للتخصصات Pluridisciplinaire يأخذ على عاتقه تفسير كيفية تفكيرنا، استنادا إلى سلسلة من القوانين المتتالية، مع مراعات جوانب مختلفة من بيولوجيا الدماغ إلى البعد الثقافي. فالرهان ها هنا هو جعل قوانين علم النفس كونية Universelles كتلك الخاصة بالفيزياء. بالنسبة لي، فالفكر على الرغم من كونه ذاتي Subjective وحميمي Intime، إلا أنه قابل للدراسة العلمية، خاصة وأن خصائصه مُتشاركة على نحو رحب في جميع أنحاء العالم. إذ أعتقد أن كل تمثل من تمثلاتنا الذهنية هو أيضا موضوع عصبي Un objet neuronal، حتى وإن ضلت القوانين الرابطة بين المستويين قيد التأسيس. لذا فأبحاثنا في المختبر متمفصلة أصلا بين السلوك ونمو الطفل، وكذا علم النفس العصبي والتصوير الدماغي..
أليست هذه المقاربة اختزالية Réductionniste بطبيعتها؟
لا، أنا لست من أولئك الذين يثيرون علم الأعصاب الإقصائي Neuroscience éliminativiste، الذي يجعل علم النفس متواريا خلف علم الأعصاب الخالص، باختزاله لكل شيء في البيولوجيا، كما هو حال الفيلسوفة باتريسيا تشيرشلاند Patricia Churchland. بل على العكس من ذلك، أعتقد أن علم النفس له قوانينه على نحو يجعلها في تمام الصلاحية في مجالها، كما هو حال قوانين اللسانيات وعلم الاقتصاد. فهناك مستويات عديدة لوصف التعقيد المبهر للوجود الإنساني. لذلك، كلما استطعنا فهم المستوى النفسي بشكل أفضل، تيسر علينا فحص أسسه العصبية بشكل أدق.
بالمقابل، فالاكتشافات المتعلقة بالدماغ، تقود إلى بروز إشكالات ونظريات جديدة في علم النفس، لذلك أعتقد أن هناك الكثير من الأخذ والرد بين المجالين.
لقد سبق أن افترض علم النفس الوظيفي La psychologie fonctionnaliste، أن أي تطبيق Programme يمكن تفعيله على الدماغ، بنفس كيفية تشغيل أي برنامج Logiciel على وسيط مادي للحاسوب. أنت ترفض هذا التصور، لماذا؟
إن استعارة دماغ-حاسوب هاته، المستلهمة والمعززة بهذا الانشطار Dichotomie الاصطناعي الصارم بين الدماغ والفكر، هي استعارة محدودة للغاية. فالدماغ لا يعمل بهذه الطريقة على الإطلاق: إذ تعتمد معظم العمليات الذهنية على شبكات عصبية محددة (لتلقي الأشكال والألوان، على سبيل المثال). إذ أوضحت أبحاثي وأبحاث زوجتي غزلان دوهين لامبيرتز Ghislaine Dehaene-Lambertz، أن هناك بنيات دماغية منظمة، لمعالجة اللغة المنطوقة، موجودة بالفعل لدى الرضيع في شهره الثاني. فعلى سبيل المثال، عندما يتلقى الطفل عبارات من لغته الأم، تَنشُط في دماغه باحة بروكا L’aire de Broca في ارتباطها بمناطق زمنية أخرى.
ومع ذلك، لا تبدو متحمسا لمفهوم الوَحَدة الفطريةModule inné؟
لا أحب لفظ "فطري"، الذي لا يُنصف تعقيد العلاقة الرابطة بين البيولوجيا وعلم النفس. حقا هنالك بنيات مُسبقة في الدماغ. ومع ذلك، فهذه الأخيرة ليست "وَحَدات Modules" جاهزة للاستخدام، لاستكشاف الوجوه أو الكتابة. بل على العكس من ذلك، فهذه البنيات الدماغية تنضج بتفاعلها مع المحيط. فعلى سبيل المثال، فعندما تقوم بدراسة التشابكات العصبية Circuits cérébraux لفعل القراءة في كل أرجاء العالم، والتي تقوم على استخدام الكتابة الأبجدية أو المُخَططات Idéogrammes، فذلك يُنشط نفس المناطق الدماغية على الدوام. ذلك أن مُرونة الدماغ تفسح المجال أمام المتغيرات الثقافية.
عادة ما يتردد في مؤلفاتك لفظ: الشِفرة العصبية Code neural، ما دلالة ذلك؟
إن الشِفرة العصبية هي ما يسمح بالربط بين التمثلات الذهنية والعصبية. في الواقع، لا توجد شِفرة وحيدة، بل إنها متعددة بتعدد المناطق الدماغية التي تنتمي إليها. دعنا نأخذ مثالا، وليكن مثال القراءة. إذ ينطلق التشفير من شبكة العين مع بضعة ملايين من المستقبلات الضوئية Photorécepteurs، والتي تعمل على رصد انبعاث الضوء من نقطة محددة. فمن خلال هذا الانبعاث يتمكن الدماغ من إعادة تشكيل الكلمة، لكن كيف ذلك؟ إننا نفكر عبر تراتب التمثلات المرئية، المتعاقبة والمتداخلة مع بعضها البعض. فنحن نعرف أنه عند الإنسان والحيوان، توجد مستويات متراتبة في التعرف على الأوجه على سبيل المثال. فأحيانا تتجاوب بعض الخلايا العصبية neurones مع شخص ما عبر مستوى عالٍ من التجريد. فعلى سبيل المثال، استطاع بعض الباحثون في سان دييغو San Diego، من تحديد هوية خلية عصبية مسؤولة عن تشفير تمثلنا لنجمة هوليود "جينيفر أنستون Jennifer Aniston"، حين يتم النظر إلى وجهها أو النظر إليها من الجانب أو من الخلف، أو كذا عند سماع صوتها أو اسمها. لكن هذا العمل لا تقوم به خلية عصبية وحيدة، بل الملايين منها، بالرغم من كون التقنية المستخدمة في تسجيل الخلايا، لا يمكنها أن ترصد إلا خلية واحدة في كل مرة. هكذا فإدراك "جينيفر أنستون" هو إذن عبارة عن تجميع عصبي، تم تشكيله عن طريق التعلم، وتوزيعه عبر مناطق دماغية متعددة، كل منها تشكل حجرة جوهرية من مراحل تشكل التعرف البصري.
علينا أن نتقبل أننا عبارة عن آلات صغير مبهرة.
كيف يمكننا فهم هذا التشفير؟
من الآليات المفيدة جدا في هذا الأمر، تلك المتعلقة بتقنية التصوير بالرنين المغناطيسي (IRM)، والتي يمكن استخدامها لتعلم القراءة على سبيل المثال. والمثير للدهشة حقا، هو أن النتائج المُحصل عليها الآن، تتفق مع الملاحظات التي دونها طبيب الأعصاب "جول ديجيرين Jules Déjerine" خلال القرن التاسع عشر، حول أشخاص مصابين بآفات على مستوى الدماغ. فتلك الباحات المفقودة عند مرضى العمى القرائي Alexiques، هي نفسها التي تنشُط عند عملية القراءة. فبفهمنا لعملية تشفير الموضوعات الذهنية، نكون قادرين على عكس الإجراء: إذ بناءً على النشاط العصبي نعمل على استنتاج المحتوى الذهني. وهو ما عملت على ايضاحه رفقة برتراند تيريون Bertrand Thirion، حين بينا أنه عندما نتخيل حرف ما (وليكن س، على سبيل المثال)، فإن طوبوغرافيا التنشيط على مستوى الباحات البصرية، تعيد إنتاج شكل نفس الحرف المَرئي. وعليه، فإذا شئنا أن نتخذ مسارا معاكسا، فبناء على هذا التنشيط نفسه، يمكننا استنتاج الحافز الذي صور هذا الموضوع. طبعا هناك العديد من القيود: على سبيل ضعف دقة التحليلات المتوفرة حاليا، فهذه الطريقة لا تسير إلا وفق الترتيبات الماكروسكوبية للنشاط. إذ بإمكاننا على سبيل المثال تمييز تمثُل الوجه عن تمثُل المنزل، ذلك أن مناطق القشرة الدماغية المطابقة لكل منها، متباعدة بسنتمتر واحد على أقل تقدير. لكننا الآن، من حيث أننا لم نلج بعد إلى باطن هذه المناطق الدماغية، فليس بمقدورنا رصد الفرق بين لفظ "منزل" ولفظ "وجه".
يبدو أن العلم بدأ يقترب من الخيال. أيمكن أن تصبح قراءة الأفكار ممكنة؟
من الناحية النظرية لا أعرف أي حجج ضد ذلك. لكن، من الناحية العمَلية، فنحن في حاجة إلى جهاز تصوير أكثر قوة مما تعرفه الصناعة الآن، بالإضافة طبعا، إلى ذات متعاونة وأكثر رزانة. فلا يجب إذن أن نتوهم كثيرا، إذ لا وجود لأخ أكبر Big Brother في الأفق. بالمناسبة، ليس قراءة الأفكار ما يهمنا هنا. بل ما يشغل بالنا بالتحديد هو فهم ميكانيزمات عملية التفكير، أي الطريقة التي تتمفصل بها الباحات الدماغية، والتي من خلالها تتدفق المعلومات. فإيجاد قانون للترابط النفسي العصبي إذن، من شأنه على سبيل المثال أن يُتيح لنا الفهم الجيد لحالة المرضى الفاقدين لوعييهم مع تجويد إمكانية رعايتهم. هذا بالإضافة إلى إمكانية رصدنا لنوايا الذات، وترجمة هذه النوايا إلى أوامر واقعية، بناءً على التدفقات الكهربائية للدماغ Eléctrodes cérébrales، وهو ما يُتيح لنا إمكانية توجيه الأعضاء الصناعة على سبيل المثال. إنه أمل كبير بالنسبة لمرضى الشلل الرباعي، ومرضى الاحتباس الحركي (أو بتعبير حرفي "المنغلقين على أنفسهم")، أي الذين لا يستطيعون التحدث أو القيام بأدنى حركة. فالمرونة الدماغية تُتيح للمرضى تكييف شِفرتهم العصبية مع الآلة. فمع نهاية سنة 2006، تمت زراعة أول ذراع صناعية مُتحكم فيها من طرف الدماغ، لامرأة كانت تنتمي إلى البحرية الأمريكية سابقا.
في نظركم، حضور تقنية التصوير الدماغي، أمر بالغ الأهمية. أليس في ذلك خطرا من حيث سيطرته على علم النفس؟
إطلاقا لا: فعلم النفس يضل مركزيا. ففي مختبري، يعمل علماء النفس على تحديد جميع التجارب، للضفر بشروط التحفيز الخالصة الممكنة، وبالتالي الوصول إلى عمليات التفكير الأولية. إن التصوير الدماغي وغيره من الطرق الأخرى، والتي تدخل ضمن الفيزياء، أو العلوم العصبية، بالنسبة لنا، ليست سوى أدوات، لكنها أدوات جوهرية. بل أكثر من ذلك، أعتقد أن مختبرات علم النفس التي لا تملك هذه الآليات ستكون في ورطة حقيقية. لذلك فنحن في مركز نوروسبين Neurospin، بصدد العمل على تطوير شَراكات واستضافة الخبرات الخارجة بقدر الإمكان.
ما الذي يُحفزك على صنع نماذجك السيكولوجية؟
في نظري، يجب أن تلعب النمذجة دوراً أساسياً في النفس، سواء لصياغة تلك القوانين الشهيرة، التي تُعبر عن الترابط النفسي العصبي، أو كذلك للتعبير عن هذه القوانين بشكل دقيق معلوماتيا أو رياضياً. لكن بالرغم من ذلك، إلا أن تطوير النظريات التفسيرية الكبرى في علم النفس، لازال أمراً عسيراً. فالنماذج المتواضعة التي اقترحتها، تستطيع تفسير بعض الوظائف النفسية الكلاسيكية. إنها تنبني على ثلاث لبِنات أساسية: تنطلق من تنظيم الخلايا العصبية الواقعية، مرورا بالهندسة الدماغية الواقعية، لتنتهي إلى محاكات وظيفة حقيقية، تربط النموذج بالبيانات التجريبية الواقعية.
أجد أنه من الهام جدا في لحظتنا هذه، أن تتخثر معارفنا المختلفة على شكل نظرية موحدة. فعلى سبيل المثال، يتشكل حاليا ما يسمى "بعلم القراءة"، والذي ينطلق من تفسير كيف نتعلم القراءة، وماهي الشبكات المسؤولة عن ذلك، وكذا ما الذي يجعل من "المنهج الشمولي" غير فعال.
هل تعتقد كما هو حال "جون بيير شونجو Jean-Pierre Changeux" أن هناك "توافق تام بين الحتمية المطلقة، وعدم القدرة على التنبؤ الواضح بسلوكاتنا"؟
مهما تمكننا من تشريح أدمغتنا، إلا أن ميكانيزماتها معقدة بدرجة كافية لتجعل نتائجها غير قابلة للحساب والتنبؤ المسبق بها. إنها فكرة اسبينوزا إلى حد ما، عندما قال إن الناس يُؤمنون بحريتهم، فقط لأنهم يعون أفعالهم في الوقت الذي يجهلون فيه الأسباب التي تحدد أفعالهم هذه. إذ علينا أن نتقبل أننا عبارة عن آلات صغيرة ومبهرة. إذ حتى لو استطعنا تحديد سلوكاتنا، إلا أنه لا يمكننا التنبؤ بها. يبدو لي أنه في مجال المقارنة بين الإنسان والآلة، ليس الإنسان هو ما يصبح دونيا، بل الآلة هي التي تُصبح سامية. إذ شرعنا حصرا في فهم قدرة الآلة العصبية على محاكاتها للتعلم، وقريحتها فيه. فمن شأن هذه المعرفة أن يكون لها إسقاطات عديدة على مجال المعلوميات وكذا مفاهيم الأنظمة الصناعية، وهو ما من شأنه، أن يُساعدنا على تجاوز حدود الدماغ البشري.
أنت تقارن علم النفس بفيزياء الثلاثينيات... لماذا ذلك؟
إن مجالنا هو انفجار تام، كما هو حال فيزياء ذلك العصر. إنه عالم جديد تم اكتشافه حديثا. إذ يعيش علم النفس على المستوى العالمي فترة إبداع واكتشاف مبهر، مع مد جسوره -بكل ما تحمله الكلمة من معنى- نحو العلوم العصبية، إضافة إلى علم الاقتصاد والفيزياء والرياضيات... فهذا الطابع العابر للتخصصات والمتلامس مع بعضه البعض، يصير محيرا أحيانا: إذ من الواجب أن نحافظ على هذا التناسق. إنه بمعنى ما "عصر بطولي".
[i] ولد ستانيسلاس دوهين، سنة 1965، هو عالم نفس عَرفَنِي Cognitiviste وعالم أعصاب. بعد تكوينه الرياضي بالمدرسة العليا، صار طالباً لدى عالم النفس جاك ميهلر Jacques Mehler، ثم بعد ذلك التحق بعالم الأعصاب جون بيير شونجو Jean-Pierre Changeux، حيث تعلم على يده العلوم العصبية. خلال سنة 2007 عند التقائنا به، ترأس وحدة إينسيرم Inserm/CEA المتخصصة في التصوير العصبي العَرفَنِي، ثم تعيينه في نفس الفترة كأستاذ بكوليج دوفرونس. من هنا بدأ علم النفس بالانفتاح على العلوم العصبية. ومنذ سنة 2018، ترأس دوهين المجلس العلمي للتربية الوطنية. تنصب اهتماماته البحثية على وجه الخصوص على الأسس العصبية لشعورنا بالأعداد، والقراءة، وكذا اتخاذ القرار والوعي. من بين أهم منشوراته، كتاب "نحو علم للحياة الذهنية" (Collège de France/Fayard, 2006)؛ وكتاب "عصبونات القراءة"(Odile Jacob, 2007)؛ التعلم: مواهب الدماغ، وتحديات الآلة (Odile Jacob, 2018).
** Une nouvelle science de la vie mentale, Rencontre avec Stanislas Dehaene, Sciences Humaines, Hors-Série, n°25, Juillet- Août 2020,P.41-43.
* حاوره رينود بيرسيو Renaud Persiaux، وقد نُشر هذا الحوار في عدد خاص في مجلة العلوم الإنسانية الفرنسية، عدد 25.
------
محمد الحاجي EL-HAJJI Mohamed (باحث في الفلسفة والفكر المعاصر، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة سيدي محمد بن عبد الله، ظهر المهراز، فاس).
(مصدر النص المُتَرجم: Sciences Humaines, Hors-Série, n°25, Juillet- Août 2020)