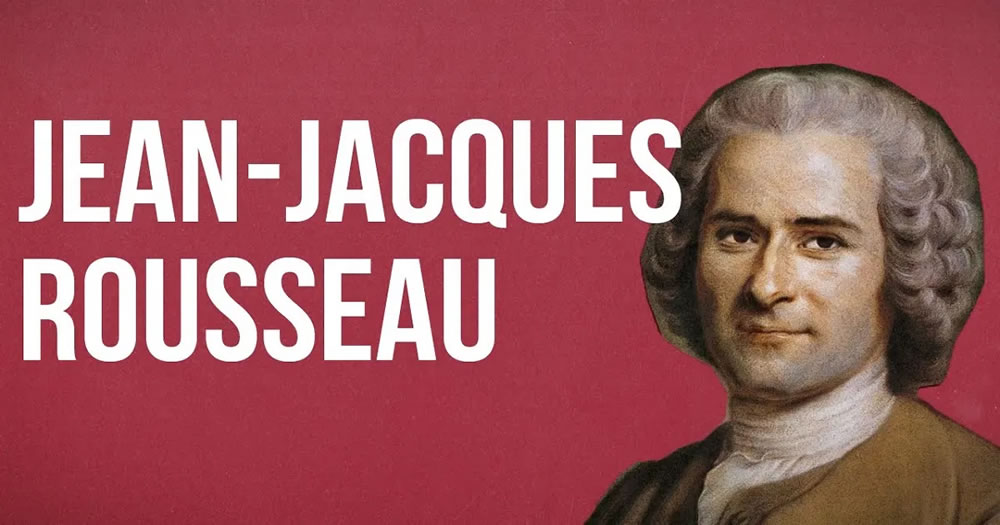تتمحور الحياة المعاصرة حول فكرة التقدم، والتي تعني أننا كلما كنا نعرف أكثر، ولا سيما حول العلوم والتكنولوجيا، وبينما تنمو الاقتصادات بشكل أكبر، فنحن سائرون في درب سوف يقود في نهاية المطاف لأن نصبح أكثر سعادة. وفي القرن الثامن عشر على وجه الخصوص، عندما أصبحت المجتمعات الأوروبية واقتصاداتها معقدة بشكل متزايد، كانت وجهة النظر التقليدية هي أن الجنس البشري وُضع بحزم على مسار إيجابي، مبتعداً عن الوحشية والجهل نحو الازدهار والكياسة والتحضر. ولكن كان هناك فيلسوف واحد على الأقل من القرن الثامن عشر على استعداد للتشكيك بقوة في "فكرة التقدم"، كان لديه أفكار جوهرية للغاية ليقولها لأبناء عصره وعصرنا الراهن.
ولد جان جاك روسو - ابن إسحاق روسو - وهو صانع ساعات متعلم، في جنيف في عام 1712. وتقريباً على الفور، عانى روسو من أول ما أطلق عليه لاحقاً "مصائبه"، إذ بعد تسعة أيام فقط من الولادة، توفيت والدته سوزان برنارد من المضاعفات التي نشأت بسبب مخاض الولادة المؤلم والمعقد. وعندما كان روسو في العاشرة من عمره، دخل والده في نزاع قانوني وأجبرت الأسرة على الفرار إلى مدينة برن حيث تزوج إسحق في وقت لاحق للمرة الثانية. ومنذ ذلك الحين، تميزت حياة روسو بعدم الاستقرار والعزلة. طوال سنوات المراهقة وسن البلوغ، كان قد غيّر المنازل بشكل متكرر، أحياناً بحثاً عن الحب والاستحسان، وفي بعض الأحيان للهروب من الاضطهاد فحسب.
عندما كان شاباً، ذهب روسو إلى باريس، وشاهد فيها الرخاء والرفاهية التي كانت النسق المعاصر في النظام القديم في باريس؛ حيث بذلت البرجوازية الطموحة قصارى جهدها لمحاكاة الأذواق والأساليب التي أبدها كل من الملوك والأرستقراطية التي لفت لفهم، مما زاد من الروح التنافسية بين الأثرياء للبذخ الفاحش، والذي أصبح محرك المشهد الاجتماعي الباريسي آنذاك. كان روسو الباريسي محزوناً بعيداً عن مسقط رأسه في جنيف، والتي كانت مدينة رصينة و بسيطة، وتتعارض بشدة مع نمط البذخ والتبذير السائد في باريس.
تشكلت حياة روسو من خلال بعض نقاط تحول رئيسية في صيرورة حياته اليومية والفكرية، ومن أحد أهم هذه الأحداث ما حدث في عام 1749، بينما كان يقرأ نسخة من إحدى الصحف - وهي ميركيور دي فرانس - التي احتوت على إعلان عن مسابقة لكتابة مقال حول موضوع ما إذا كانت التطورات الحديثة في الفنون والعلوم قد ساهمت في "تنقية الأخلاق". لقد صدمه - على ما يبدو لأول مرة - أن الحضارة والتقدم و التمدن لم يحسنا في الواقع من واقع و طبيعة حياة و سلوك البشر؛ بل لقد أفرزوا تأثيراً مدمراً فظيعاً على أخلاقيات البشر الذين كانوا في السابق طيبين. ولقد أخذ روسو هذه الرؤية، وحوّلها إلى أطروحة محورية لما أصبح مقاله الشهير "بحث علمي في الفنون والعلوم"، والذي فاز بالجائزة الأولى في مسابقة الصحيفة السالف الذكر. في مقاله، قدم روسو نقداً قاسياً للمجتمع الحديث، بشكل تحدى المفاهيم المركزية لفكر التنوير. وكانت حجته بسيطة: كان الأفراد في الماضي يتمتعون بالخيّر والسعادة، لكن مع خروج الإنسان من حالته المتناغمة مع البساطة و الطبيعة، أصبح يعاني من الرذيلة وانخفض إلى الفقر الروحي.
ومضى روسو في رسم تاريخ للعالم ليس كقصة للتقدم من الهمجية إلى ورش العمل والمدن الكبرى في أوروبا، ولكن بالعودة إلى نهج الحياة في عصور غابرة عندما كنا نعيش فيها ببساطة، وكان يتاح لنا الفرصة للاستماع إلى احتياجاتنا الطبيعية. في عصور ما قبل التاريخ المتخلفة تقنياً، في "حالة الطبيعة" لدى روسو، عندما عاش الرجال والنساء في الغابات ولم يدخلوا متجراً أو يقرأوا صحيفة، كان يحدوهم السمات الأساسية لحياة راضية: حب الأسرة، واحترام الطبيعة، و التبجيل لجمال الكون، وتذوق المتع الطبيعية، والترفيه البسيط. وكانت حالة طبيعة سلوك البشر أيضاً أخلاقية، يوجهها الشفقة والتعاطف والتعاضد مع الآخرين ومعاناتهم. من هذه الحالة حيث الطبيعية سحبتنا "الحضارة" التجارية الحديثة، وتركت لنا الحسد والشوق لعالم الوفرة والمعاناة فيه.
لقد كان روسو على دراية بمدى عمق الموضوعة الخلافية التي قدمها في استنتاجه، ولقد توقع "صرخة عالمية" ضد أطروحته، وبالفعل أثار بحثه العلمي بالفعل عدداً كبيراً من الردود، وكان البوابة التي ولج منها روسو إلى الشهرة.
ماذا الذي كان في حركية التمدن، واعتقد روسو أنه أفسد الإنسان وأحدث هذا الانحطاط الأخلاقي؟ من جذور عداء روسو للتمدن المعاصر كان تصوره أن المسيرة نحو الحضارة قد أيقظت في الإنسان شكلاً من أشكال "حب الذات"، وكان هذا مصطنعاً ويتركز على التباهي، والغيرة، والغرور، والمتع الباذخة. وقال إن هذا الشكل المدمر من حب الذات قد ظهر نتيجة انتقال الناس إلى مستوطنات ومدن أكبر حيث بدأوا في التطلع إلى الآخرين من أجل اكتساب شعورهم بتفوق الذات. توقف الناس المتحضرون عن التفكير فيما يريدون وما شعروا به، وقلدوا الآخرين، ودخلوا في مسابقات مدمرة مع أقرانهم للتفوق عليهم، وللحصول على المكانة والمال.
وقد لاحظ روسو أن الإنسان البدائي لم يقارن نفسه بالآخرين، بدلاً من ذلك قد ركز فقط على نفسه، فهدفه كان ببساطة البقاء على قيد الحياة. وعلى الرغم من أن روسو لم يستخدم فعلياً مصطلح "وحشية نبيلة" في كتاباته الفلسفية، إلا أن روايته للإنسان الطبيعي أطلقت العنان لهذا المفهوم. وبالنسبة لأولئك الذين قد يرون هذا كقصة رومانسية مستحيلة سوف يتم تفسيرها بفرادة على أنها خيال لمؤلف بارع، ولديه ضغينة ضد الحداثة، يجدر بنا أن نفكر في أنه إذا كان القرن الثامن عشر قد استمع إلى حجة روسو، فذلك يرجع في المقام الأول إلى أنه كان أمامه مثال صارخ على حقائقه الواضحة في شكل مصير السكان الأصليين الهنود في أمريكا الشمالية.
وصفت التقارير البحثية والصحفية المجتمعات الهندية الحمراء في أمريكا الشمالية، والتي تم إعدادها في القرنين السادس عشر و السابع عشر، بأنها مجتمعات بسيطة من الناحية المادية، ولكنها مجزية نفسياً، إذ كانت المجتمعات صغيرة، ومتماسكة، ومتساوية، ودينية، ومرحة، ومتكاتفة. وكان الهنود الحمر بلا شك متخلفين من الناحية المالية والعمرانية، فلقد عاشوا على الفواكه والحيوانات البرية، وكانوا ينامون في الخيام، وكان لديهم القليل من الممتلكات. كل عام، كانوا يرتدون نفس الجلود والأحذية. حتى الرئيس فيهم قد لا يمتلك أكثر من رمح وعدد قليل من الأواني. ولكن كان هناك مستوى متميز من الرضا العميق في كل منهم، و هم يعيشون في لج من البساطة والسعادة الطبيعية.
ومع ذلك، وفي غضون بضعة عقود فقط من وصول أول الأوروبيين، تم إحداث ثورة في حال المجتمع الهندي الأحمر في أمريكا الشمالية من خلال الاتصال مع التكنولوجيا والرفاهية الخاصة بالصناعة الأوروبية. ولم يعد ما يهم هو الحكمة أو الفهم لطرق الطبيعة، ولكن ملكية الفرد للأسلحة، والمجوهرات، والكحول. إن الهنود الآن يتوقون إلى الأقراط الفضية، والأساور النحاسية الحمراء، والنحاسية الصفراء، وخواتم الإصبع المصنوعة من القصدير، والقلائد المصنوعة من زجاج مدينة البندقية، والأزاميل الحديدية، والبنادق، والكحول، والغلايات، والخرز، والمرايا.
هذه الاندفاعات الجديدة لم تتحقق بالصدفة. فقد حاول التجار الأوروبيون عن عمد تعزيز الرغبات في الهنود، وذلك لتحفيزهم على اصطياد فراء الحيوانات التي تطلبها السوق الأوروبية. وللأسف، لا يبدو أن ثروتهم الجديدة جعلت الهنود أكثر سعادة. بالتأكيد عَمِل الهنود بجد، فبين عامي 1739 و1759، تُشير التقديرات إلى أن 2000 محارب من قبيلة الشيروكي قد نجحوا في اصطياد ربع مليون من الغزلان لتلبية الطلب الأوروبي. لكن معدلات الانتحار وإدمان الكحول ارتفعت في مجتمعات الهنود الحمر، وتفتت المجتمعات من داخلها، وظهرت صراعات بين بنى المجتمعات نفسها. لم يكن زعماء القبائل بحاجة إلى روسو لفهم ما حدث، لكنهم مع ذلك توافقوا تماماً على سلامة تحليله.
توفي روسو في عام 1778، عن عمر يناهز 66 عاماً، بينما كان يمشي خارج باريس. لقد أمضى السنوات الأخيرة من حياته مشهوراً، وهو يعيش مع زوجته غير الشرعية، وتم دفنه الآن في البانثيون في باريس، ويحتفل به أبناء مدينة جنيف كأبنهم الأصلي الأكثر شهرة.
في عصر مثل عصرنا، عصر تعدّ فيه الفخامة والرفاهية ضالة الغالبية شبه المطلقة من بني البشر، تواصل تأملات روسو صداها. إنه يشجعنا على تجنب الغيرة والمنافسة وبدلاً من ذلك ننظر إلى أنفسنا فقط في تحديد قيمتنا الذاتية. لقد أخبرنا روسو أنه فقط من خلال مقاومة شر المقارنة، يمكننا أن نتجنب مشاعر البؤس والقصور؛ وعلى الرغم من صعوبة ذلك، فقد كان روسو واثقاً من أن هذا لم يكن مستحيلاً، وبالتالي فقد ترك وراءه فلسفة نقدية عميقة، ولكنها كانت أيضاً ذات تفاؤل بنيوي أصيل. فهناك طريقة للخروج من البؤس والفساد الناجم عن أعراف وعادات ومؤسسات الحضارة الحديثة، والجزء الصعب هو أنه ينطوي على النظر إلى أنفسنا وإحياء الخير الطبيعي فينا، وإعادة الاعتبار لمبدأ حق الإنسان في الحرية الحقة التي لا بد دائماً من النضال لتأصيلها وتوطيدها والدفاع عنها، و لا يزال قوله الشهير مجلجلاً بكلماته الثاقبة: "يولد البشر أحراراً ولكن حيثما أبصرتهم فهم في أصفاد".