 مساء الثاني والعشرين من أكتوبر 2013م، شمسٌ خريفيَّة تسطع على ميادين بوخاريست المزدحمة بالعائدين من أعمالهم، وزحام المبنى رقم (7) يدفعنا إلى الانتظار وقوفًا على السلَّم الدائري الضيِّق الذي يؤدي إلى العيادة، كانت عيادة العيون تغصُّ بمراجعين أغلبهم من كبار السنِّ. في منتصف السلِّم وعلى عتبتين متجاورتين اجتمعنا: سيِّدة رومانيَّة تجاوزت الخمسين، وأنا، لا أتذكَّر السؤال المفتاح الذي طرحتـُه لكنـَّه كشأن المفاتيح الصالحة قادني إلى حيث ينبغي، ردَّت بإنجليزيَّة متقنة، وعرفت – لاحقًا – أنـَّها تدرِّس اللغة الإنجليزيَّة في إحدى ضواحي بوخاريست، كانت العيادة ضيَّقة وتشغل مبنى قديمًا في وسط المدينة، وحين قالت – بعد حديث قصير عن الازدحام – : "إنَّ على الطبيب أن يبحث عن عيادة أخرى كي تستوعب هذا العدد الهائل من المراجعين" قلت: إنَّ الأمر سيكون محزنـًا؛ لأنَّ المبنى جميل، وأنا أحبُّ أن أتأمل هذه المباني العريقة التي تملأ وسط المدينة.
مساء الثاني والعشرين من أكتوبر 2013م، شمسٌ خريفيَّة تسطع على ميادين بوخاريست المزدحمة بالعائدين من أعمالهم، وزحام المبنى رقم (7) يدفعنا إلى الانتظار وقوفًا على السلَّم الدائري الضيِّق الذي يؤدي إلى العيادة، كانت عيادة العيون تغصُّ بمراجعين أغلبهم من كبار السنِّ. في منتصف السلِّم وعلى عتبتين متجاورتين اجتمعنا: سيِّدة رومانيَّة تجاوزت الخمسين، وأنا، لا أتذكَّر السؤال المفتاح الذي طرحتـُه لكنـَّه كشأن المفاتيح الصالحة قادني إلى حيث ينبغي، ردَّت بإنجليزيَّة متقنة، وعرفت – لاحقًا – أنـَّها تدرِّس اللغة الإنجليزيَّة في إحدى ضواحي بوخاريست، كانت العيادة ضيَّقة وتشغل مبنى قديمًا في وسط المدينة، وحين قالت – بعد حديث قصير عن الازدحام – : "إنَّ على الطبيب أن يبحث عن عيادة أخرى كي تستوعب هذا العدد الهائل من المراجعين" قلت: إنَّ الأمر سيكون محزنـًا؛ لأنَّ المبنى جميل، وأنا أحبُّ أن أتأمل هذه المباني العريقة التي تملأ وسط المدينة.
يوميات ـ قصة : مأمون أحمد مصطفى
 اليوم الأول...
اليوم الأول...
(داخل الزمن)
الخروج من بين أربعة جدران- كما كنت أرى- تقترب من بعضها، تلغي المسافات الفاصلة، تمحوها، تتمرد عليها بكل ما فيها من موت وسكون. كنت أرقب الجدران وهي تقترب من بعضها، بتصميم، بعزم متوقد، بزحف يبحث عن التوحد، التلاصق، الاندماج، الذوبان في تيار الذرات المكونة لها. وأنا، وأنا عيناي تطفحان بالرعب، بانخلاع القلب والعقل، بالدهشة. أنكمش على نفسي انكماش قطعة مطاط تداعبها حرارة النار.
أنا وسقف الغرفة في مأزق واحد، تلاصق الجدران، توحدها، اندماجها، ذوبانها، انصهارها في بعضها. بالنسبة لي، هذا يعني موتاً محققاً، زوال، اندثار، خروج من رحم الحياة، دخول في رحم الموت. في النهاية الممتدة في خيال الفلاسفة، المفكرين، الشعراء، في نهاية رحبة، رحابة الأفكار التي انبثقت من عقول وقلوب مجموعات هائلة من البشر. بالنسبة للسقف تعني الانهيار، التشظي، التناثر، التفرق، تفرق الذرات في سماء وهواء، في فضاء وأثير، انفصال التماسك، تداعيه.
جرافيتى ـ قصة : ماهر طلبه
 حين شعرت أن النهاية على الأبواب، قررت أن أترك للتاريخ بعض تفاصيل حياتى.. حتى لا تضيع كما ضاع الكثير من أحداث زماننا الهامة.
حين شعرت أن النهاية على الأبواب، قررت أن أترك للتاريخ بعض تفاصيل حياتى.. حتى لا تضيع كما ضاع الكثير من أحداث زماننا الهامة.
ولدت في بيت عادي لم تكن به إلا نافذة واحدة تطل على شارع ضيق جدا بالكاد كنت أستطيع - حين كبرت- أن أعبره بالنظر لأسقطه على صدر بنت الجيران - طائرا جارحا- والتي لم ترني أبدا رغم قرب المسافة وحرارة النظرات.
كانت مدرستي الأولى قريبة من بيتنا، في يومي الدراسي الأول تعرفت على صديقي الأول، كنا نشترك في خصال كثيرة، المريلة التي بالكاد تخفي الجسد، الحذاء الذي تعبره الأصابع بلا خجل، والدموع التي ترفض ترك حضن الأم، جاءت جلستي بجانبه كأن القدر كان يعدنا لذلك الأمر الهام الذى حدث، لكني في حينها لم أنتبه، رغم ذكائي المتقد وعبقريتي التي تفجرت منذ اليوم الأسود الذي انفصلت فيه عن حبل أمي السري، وجدت على وجهه نفس الدموع فشاركته بأن جعلت صوتي مصاحبا لدموعه، وانتصرنا معا على المدرسة - أو هكذا اعتقدنا- فذهبنا إلى البيت عند انتهاء اليوم الدراسي.
رصاصة في... الهواء ـ قصة : مصطفى حدريوي
 ذرعه القيء ، فاستجمع ما بقي من قوته الخائرة، وقصد الحمام. مشى على رؤوس أصابع رجليه وهو يضع جماع يده على فمه حتى لا يُسمع، ولا ينسكب شيء من عصارة أمعائه على الارض ، كم استطال المسافة بين غرفة نومه والحمام ! رغم، أن بيته في غاية الصغر: صالة وغرفتان و ...
ذرعه القيء ، فاستجمع ما بقي من قوته الخائرة، وقصد الحمام. مشى على رؤوس أصابع رجليه وهو يضع جماع يده على فمه حتى لا يُسمع، ولا ينسكب شيء من عصارة أمعائه على الارض ، كم استطال المسافة بين غرفة نومه والحمام ! رغم، أن بيته في غاية الصغر: صالة وغرفتان و ...
لا ريب أن مرضه استغول و بلغ مرحلة متقدمة عما كان عليه فالتعب تضاعف والالم استفحل. انكفأ على المغسل ، و أفرغ ما جاد به جوفه ذاك الصباح ، ثم غسل فمه بماء دافق غسلا حتى لا يعود شيء مما أفرغ إلى بطنه ، فيظل يتمطق مرورته، وصب على وجهه قدرا سخيا منه ، عل برودته تنعشه ، وإن لم تفعل فقد تلطف شيئا من الحرارة التي تتأجج بين حناياه .
استوى ونظر في المرآة فعكست له عينين متعبتين بالسهر والمرض، ووجها تلفه صفرة فاقعة ، تلمسه بيد مرتعشة فهاله نتوء عظمتي وجنتيه وغور محجريه.
المرايــــا ـ قصة : سهام العبودي
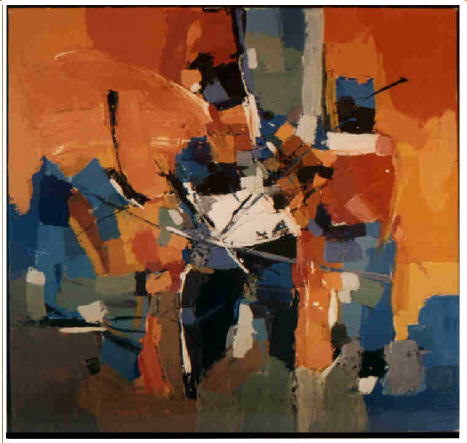 استيقظت اليوم باكرًا.
استيقظت اليوم باكرًا.
ربما كانت الساعة السابعة، أو قبل السابعة بقليل، لم يكن أمر الوقت مهمًا؛ فقد كنت في حلٍّ من أي ارتباط، كنت حرَّة: صنعت شاي الصباح على مهل، تأمَّلت بخار الماء المغلي وهو يلتصق بمربَّعات البورسلان التي تغطي جدار المطبخ، ورسمت فوقها أشياء كثيرة: رسمت قلوبًا، وورودًا، وابتسامات، ورسمت إمضاءاتي الكثيرة، كان الإبريق يقذف البخار بشدة، فتختفي الخطوط الأولى سريعًا، وأعود إلى الرسم من جديد، لا أعرف كم استغرق الأمر مني لكنـَّني رسمت أشياء كثيرة مبهجة. كان مزاجي رائقـًا إلى هذا الحدِّ، إلى حدٍّ جعلني أعيد اكتشاف بخار الماء العالق بالأشياء: طواعيته، عمره القصير، جماله الذي لا يحصل على قدرٍ كافٍ من الإطراء.
كنت مملوءة برضا فيَّاض، ولوهلة تملَّكني هذا الشعور: أنَّ السعادة لا يمكن أن تكون شيئـًا غير هذا الهدوء، وغير هذه السكينة، هذا الصفاء النادر الذي يجعلني أكتشف جمال الأشياء الخفي، وتلك التفاصيل التي ينضب العمر دون أن يتدفـَّق فيها، قبل أن أنهض من السرير – مثلاً – صرفت بعض الوقت في مراقبة ستارة الغرفة؛ كنت قد تركت قسمًا من النافذة مفتوحًا قبل النوم، ظلَّ هذا القسم المفتوح يبعث هواء معتدلاً طوال الليل، ولم يكفَّ الهواء عن مداعبة الستارة، كانت الستارة تمتلئ بالهواء فترتفع، ثمَّ تهبط، وهكذا مع كلِّ هبَّة هواء تأتي من الخارج، أتصوَّر أنَّ هذا كان يحدث كلَّ يوم، وكنت – لسبب ما – لا أراه، هكذا فيما يبدو كانت الستارة تبدأ يومها: لا قهوة، ولا جرائد، ولا إنترنت، لا شيء إلاَّ أن يغدو هذا الموسلين الحليبي اللون كرةً لوهلة، ثمَّ ينسدل، هكذا حتى تصمت النافذة!
ليلة قدر ـ قصة : ماهر طلبه
 حين استمع إلى خطبة إمام المسجد؛ عادت له طفولته.. مدرس التربية الدينية.. التى مازالت علامات عصاه تلون روحه وذاكرته.. كثيرا ما حدثهم عن ليلة القدر، وكثيرا ما قال لهم انتظروها فى العشر الأخيرة من رمضان، وكثيرا ما ظل ساهرا..
حين استمع إلى خطبة إمام المسجد؛ عادت له طفولته.. مدرس التربية الدينية.. التى مازالت علامات عصاه تلون روحه وذاكرته.. كثيرا ما حدثهم عن ليلة القدر، وكثيرا ما قال لهم انتظروها فى العشر الأخيرة من رمضان، وكثيرا ما ظل ساهرا..
لم يكن يومها قد فتح بعد صفحة الأحلام.. لكن هذا المدرس فتح له بابها.. فكان يتمنى أن يقابل ليلة القدر ليطلب من الله أن يختفى مدرسه من حياته، أو يُدخل آياته فى قلبه فلا ينساها ويهرب من مصير دائما ما يقابله فى كل حصص الدين... ذكره إمام الجامع بالحلقة المدورة فى السماء.. الضوء الذى ينير فجأة.. باب الأحلام الذى يُفتح فتتحقق كل الأمانى والامنيات...
ضجيج الصمت ـ نص : مأمون احمد مصطفى
 وحيدا تجلس كعادتك، ترنو للسماء المتناثرة بها النجوم لآلئا في ظلام الوجود والعدم. وتارة ترنو للأفق البعيد بعينيك الذابلتين المرهقتين. فأحس وأنا أنظر إليك من شرفتي المقابلة أنك تلقي حبالك على المدى الذي تحيطه عيناك لتدنيه إليك أكثر، لترى ما هو بوضوح أكثر، لكن حبالك كانت تنزلق في كل مرة جارحة بكلاباتها نسيم الصيف الناعم الطري. فيداهمك إحساس بالفشل والإحباط، ودون شعور يتقدم رأسك للأمام، مع اتساع ملحوظ بالعينين، ليستشرف أبعد من المدى المحاط بإشعاعات عينيك، ولكن حين يرتد رأسك، وتستوي عيناك، كنت أعلم أن الفشل واليأس كانا جزءا مما علق بأهدابك وشعرك في رحلة العودة.
وحيدا تجلس كعادتك، ترنو للسماء المتناثرة بها النجوم لآلئا في ظلام الوجود والعدم. وتارة ترنو للأفق البعيد بعينيك الذابلتين المرهقتين. فأحس وأنا أنظر إليك من شرفتي المقابلة أنك تلقي حبالك على المدى الذي تحيطه عيناك لتدنيه إليك أكثر، لترى ما هو بوضوح أكثر، لكن حبالك كانت تنزلق في كل مرة جارحة بكلاباتها نسيم الصيف الناعم الطري. فيداهمك إحساس بالفشل والإحباط، ودون شعور يتقدم رأسك للأمام، مع اتساع ملحوظ بالعينين، ليستشرف أبعد من المدى المحاط بإشعاعات عينيك، ولكن حين يرتد رأسك، وتستوي عيناك، كنت أعلم أن الفشل واليأس كانا جزءا مما علق بأهدابك وشعرك في رحلة العودة.
سطر الخلاص ـ قصة : سهام العبودي
 أنا – على الأغلب – كائنٌ ميْت، وموتي يتجدَّد بعللٍ تافهة؛ كأن لا يرد عامل النظافة الغاضب تحيَّتي لي، أو أن يقع زرُّ قميصي في فتحة تصريف الماء، أو حين ينتهي – بي – عدُّ حجر الرصيف إلى عدد لا يقبل القسمة على اثنين إلاَّ بباقٍ، وأحيانـًا حين أصادف تاءً مربوطةً عاريةً عن غمَّازتيها.
أنا – على الأغلب – كائنٌ ميْت، وموتي يتجدَّد بعللٍ تافهة؛ كأن لا يرد عامل النظافة الغاضب تحيَّتي لي، أو أن يقع زرُّ قميصي في فتحة تصريف الماء، أو حين ينتهي – بي – عدُّ حجر الرصيف إلى عدد لا يقبل القسمة على اثنين إلاَّ بباقٍ، وأحيانـًا حين أصادف تاءً مربوطةً عاريةً عن غمَّازتيها.
كنت أموت بمعدَّل مرَّة كلَّ شهر تقريبًا، وفي الحالات الضاغطة كنت أموت مرَّتين، في الأوان الأخير أصبحت أموت كثيرًا، صرت أموت بفرطٍ مُقلق. الناس يربكهم أمري؛ صاحب محل الفاكهة شطبني نهائيًّا من قائمة المشترين بالأجل، وقبل أيَّام وصلتني دعوة حفل زفاف وكُتب اسمي على ظهرها بهذا الشكل: "السيِّد: فلان الفلاني ما لم يكن ميتـًا في هذا الوقت"!
أنشغل في القسم الحيِّ من حياتي بتهيئة وضعية مريحة لميتتي المحتملة التالية؛ فتكرار الموت – شأنه شأن تكرار نوع من الطعام، أو اللباس – أمرٌ مرشَّحٌ لأن يكون مُمِّلاً، وحيث يعتني الناس بمسألة الطعام، واللباس بشكل كافٍ يسهل معه أن تجد أنواعًا من الطعام، وأشكالاً من الثياب، فإنَّ الموت لا يلقى هذه العناية، تصبح المسألة – حينئذٍ – مسألة اجتهادٍ شخصِّي، حيث لا يمكن أن تجد من تلوم على سوء الوضعية إلاَّ نفسك!












