 أعلنها أرنولد توينبي صريحة : إن الحضارات لا تفنى بالقتل و لكن بالانتحار الذاتي ! ولعل الاحتفاء الشاذ للحضارة الغربية بتيمة الجنس يؤكد أنها سائرة على خطى سابقاتها في درب الانحلال و التفسخ الحضاري .
أعلنها أرنولد توينبي صريحة : إن الحضارات لا تفنى بالقتل و لكن بالانتحار الذاتي ! ولعل الاحتفاء الشاذ للحضارة الغربية بتيمة الجنس يؤكد أنها سائرة على خطى سابقاتها في درب الانحلال و التفسخ الحضاري .
لكن بين الفينة و الأخرى تنبعث صرخة حادة تفجر المسكوت عنه , وتفضح الوضع المؤلم لمجتمع إنساني انفصل عن بنائه القيمي , وبالغ في الوثوق برؤى شوهاء .
ضمن هذا السياق يندرج كتاب "الإباحية ليست حلا " للدكتورة و المستشارة النفسية الأمريكية ميريام جروسمان , والذي يتضمن وصفا مؤلما لما آل إليه شباب أمريكا على مستوى الجنسانية , والمزالق الاجتماعية الخطيرة الناشئة عن الاختراق الإيديولوجي لحقل الصحة الجنسية . اختراق تشبهه جروسمان بالزلزال الذي ينقض دعائم الحقائق العلمية و الحضارية ويهدف إلى إنتاج ثقافة مخنثة , يتم عبرها التبرؤ من الاختلافات بين الرجال و النساء أو تُستبعد من الحسبان بحيث يتلاشى تفرد كل منهما .
الخطاب النسوي المعاصر قراءة في خطاب نوال السعداوي وفاطمة المرنيسي ـ تركي الربيعو
 1 ـ قراءة في خطاب نوال السعداوي
1 ـ قراءة في خطاب نوال السعداوي
ينطوي فعل القراءة على تأويل للمقروء يجعله ذد معنى في آن واحد. وذا معنى بالنسبة لمحيطه الفكري والاجتماعي والسياسي وأيضا بالنسبة لنا نحن - القارئين - فمن جهة تحرص هذه القراءة على جعل المقروء معاصرا لنفسه من جهة على صعيد الاشكالية والمحتوى المعرفي والمضمون الايديولوجي ومن هنا معناه بالنسبة لمحيطه الخاص، ومن جهة أخرى تحاول هذه القراءة أن تجعل المقروء معاصرا بالنسبة لنا نحن بإضفاء صفة الفهم والمعقولية على النص المقروء. (محمد عابد الجابري، نحن والتراث، ص 6) كان الجابري يرى أن أية قراءة للتراث يجب أن تقوم على خطوتين منهجيتين الفصل والوصل فجعل المقروء معاصرا لنفسه معناه فصله عنا.. وجعله معاصرا لنا معناه وصله بنا.
أطروحة عبد الله حمودي ومنتقدوها ـ عبد الفتاح أيت ادرى
 تعتبر أطروحة عبد الله حمودي المتضمنة في كتابه الشيخ والمريد، من أهم الأطروحات التي درست النظام السياسي المغربي، والتي أثارت نقاشات بين الباحثين سواء المغاربة أو الأجانب . فما هي أهم مضامين هذه الأطروحة ؟ وما هي أبرز النقاشات التي أثيرت حولها؟
تعتبر أطروحة عبد الله حمودي المتضمنة في كتابه الشيخ والمريد، من أهم الأطروحات التي درست النظام السياسي المغربي، والتي أثارت نقاشات بين الباحثين سواء المغاربة أو الأجانب . فما هي أهم مضامين هذه الأطروحة ؟ وما هي أبرز النقاشات التي أثيرت حولها؟
إن أطروحة عبد الله حمودي تنطلق من فرضية أساسية مفادها تسرب خطاطة ثقافية من مجال الصوفية والولاية إلى المجال السياسي، هذه الخطاطة التي استندت عليها علاقات السلطة واستمدت منها ديناميتها هي في نظره علاقة الشيخ بالمريد [1]. وهدفه من خلال هذه الأطروحة تفسير أسباب استمرار النظام المغربي بعد الاستقلال بعيد عن العوامل الاقتصادية التي تبدو له غير كافية لوحدها .
اقتصر حمودي على ذكر سيرة رجل واحد، تلك التي جاء بها المختار السوسي عن أبيه الشيخ علي الدرقاوي، أحد شيوخ الزاوية الدرقاوية ، هذه الزاوية التي هيمنت على السجال الديني والسياسي خلال القرن التاسع عشر ، وتميزت بدفاعها المستمر ضد الاستعمار [2].
الإعاقة والتمثلات الاجتماعيّة في المجتمع التونسي ـ د.الحبيب النّهدي
 الإهداء إلى أبني يُمْنْ جعلت اسمه لمقاماتي وحركاتي وسكناتي
الإهداء إلى أبني يُمْنْ جعلت اسمه لمقاماتي وحركاتي وسكناتي
‘‘الوصم المتصل بالإعاقة يؤدي إلى القمع الاجتماعي والاقتصادي في جميع أنحاء العالم’’[i] بيثاني ستيفنر
تقديم عام:
هل يمكن حل التناقض بين وصم الشخص بالإعاقة ومحاولة إدماجه في نفس الوقت؟ فهذا التساؤل يحيلنا إلى لبّ المشكل المتمثل في محاولة إدماج من هو غير قادر على ذلك. فكأنّما هي مفارقة تدعو للاستهجان والسخرية ولا سبيل إلى حلّ الإشكال والخروج من مأزق المفارقة إلاّ إذا مررنا إلى مستوى أعمق في التفكير والبحث عن رمزية عميقة فيها نتاج المعنى مما يساعد على بناء العلاقات التفاعلية بين معنى الإعاقة من جهة وقدرة المجتمع على تمثل معاناة المعوق ومساعدته على أن يتأقلم مع الحياة اليوميّة من جهة ثانية. فليست المسألة إذن في وجود وسائل متطورة مساعدة للشخص ذي الإعاقة على الاندماج وإنما لا بدّ من تجاوز المحيط المعيق للتواصل التفاعلي.
المجتمع بوصفه حقلا للصراع عند ميشال دو سارتو ـ محمد شوقي الزين
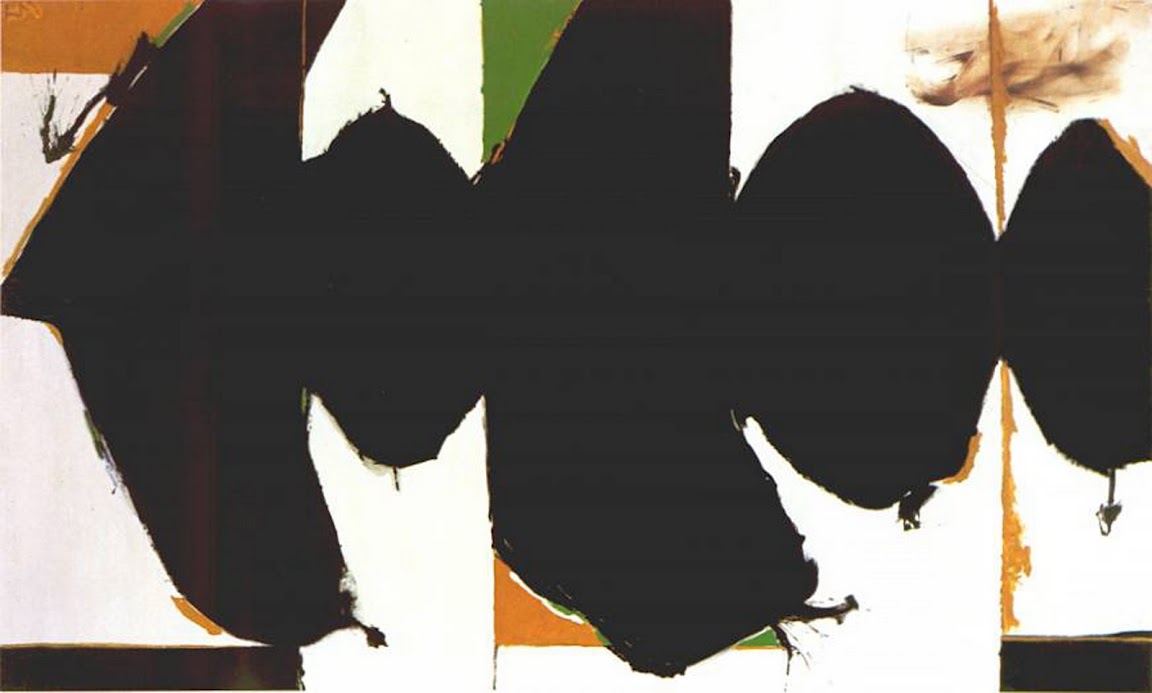 أحد الإبتكارات الأصيلة عند ميشال دو سارتو (مفكر ومؤرّخ فرنسي 1925-1986) هو بلورته المفهومية لثنائية «الإستراتيجية» و«التكتيكية» في قراءة المجتمع المعاصر. هذه الثنائية ليست جديدة لأنّها تركّب المعجم التقني للعمليات الحربية والمناورات العسكرية. لكن الأصالة المفهومية التي تحلّى بها دو سارتو هي إزاحة المصطلح من نظرة «حربية» إلى نظرية «إجتماعية» و«سياسية» دون التخلّي عن الدلالة الصراعية التي تنطوي عليها.
أحد الإبتكارات الأصيلة عند ميشال دو سارتو (مفكر ومؤرّخ فرنسي 1925-1986) هو بلورته المفهومية لثنائية «الإستراتيجية» و«التكتيكية» في قراءة المجتمع المعاصر. هذه الثنائية ليست جديدة لأنّها تركّب المعجم التقني للعمليات الحربية والمناورات العسكرية. لكن الأصالة المفهومية التي تحلّى بها دو سارتو هي إزاحة المصطلح من نظرة «حربية» إلى نظرية «إجتماعية» و«سياسية» دون التخلّي عن الدلالة الصراعية التي تنطوي عليها.
تتضمّن الإستراتيجية في بعدها الاشتقاقي ما يسمّيه الإغريق «بوليموس» (polemos) بمعنى الصراع والذي كان يرى فيه هيرقليطس «أب الأشياء جميعاً» (polemos pantôn mèn pater) ومنه انحدر مصطلح السجال أو الجدال (polémique) لما يحتمله من أخذ وردّ، الفعل وردّ الفعل، المناظرة، إلخ. فهو لا ينفكّ عن نمط صراعي في التعامل أو التداول.
مقاربات علم الاجتماع الوظيفي والنقدي لوسائل الإعلام ـ آمال موسى
 يصنف علماء الاجتماع وسائل الإعلام في خانة تصنيف أطر التنشئة الثانوية خلافا لمؤسستي الأسرة والمدرسة اللتين تنتميان إلى أطر التنشئة الاجتماعية الأوليّة والأساسيّة. وبذلك تكون وسائل الإعلام محدّدا مهما من محدّدات تنشئة الأفراد اجتماعيا حتى وإن كانت هذه الأهمية ثانوية وتشترك في الدور والوظيفة مع أطر اجتماعية أخرى مثل أصدقاء الجيل ودور العبادة وغيرهما. ونفترض أن قوة البعد الاجتماعي للعملية الاتصالية والإعلامية والوظائف الاجتماعية المهمة، التي تقوم بها وسائل الإعلام على غرار التنشئة الاجتماعية (la socialisation) والاندماج الاجتماعي (lصintégration sociale) ، هي التي أعطت المشروعيّة العلميّة السوسيولوجيّة لقيام فرع داخل علم الاجتماع العام يسمى: علم اجتماع الإعلام.
يصنف علماء الاجتماع وسائل الإعلام في خانة تصنيف أطر التنشئة الثانوية خلافا لمؤسستي الأسرة والمدرسة اللتين تنتميان إلى أطر التنشئة الاجتماعية الأوليّة والأساسيّة. وبذلك تكون وسائل الإعلام محدّدا مهما من محدّدات تنشئة الأفراد اجتماعيا حتى وإن كانت هذه الأهمية ثانوية وتشترك في الدور والوظيفة مع أطر اجتماعية أخرى مثل أصدقاء الجيل ودور العبادة وغيرهما. ونفترض أن قوة البعد الاجتماعي للعملية الاتصالية والإعلامية والوظائف الاجتماعية المهمة، التي تقوم بها وسائل الإعلام على غرار التنشئة الاجتماعية (la socialisation) والاندماج الاجتماعي (lصintégration sociale) ، هي التي أعطت المشروعيّة العلميّة السوسيولوجيّة لقيام فرع داخل علم الاجتماع العام يسمى: علم اجتماع الإعلام.
ولكننا إذا أضفنا إلى هذا الاعتبار، تلك الحيرة المعرفية التي انطلقت مع بداية القرن العشرين والتي شهدت تساؤلات جديّة حول الماهية الجديدة للمجتمعات وأثر وسائل الإعلام الجماهيرية في التغييرات التي عرفتها ماهية المجتمع الحديث وما مصداقية ما يسمى المجتمع الجماهيري ثم وصف مجتمع المعلومات، إذا ما أضفنا عامل هيمنة وسائل الإعلام اليوم على الحياة اليومية للأفراد والمجتمعات، إلى أي حدّ يمكن القبول بالتصنيف السوسيولوجي لوسائل الإعلام الجماهيرية كمؤسسات للتنشئة الاجتماعية الثانوية؟
عن تطور مفهوم الصراع من أجل البقاء..2 ـ فاتن نور
 في أواخر القرن المنصرم برزت حركة طوعية داعمة لفكرة انقراض الجنس البشري لمنع الانحلال البيئي وانقراض السلالات غير البشرية، تسمي نفسها Voluntary Human Extinction Movement) )
في أواخر القرن المنصرم برزت حركة طوعية داعمة لفكرة انقراض الجنس البشري لمنع الانحلال البيئي وانقراض السلالات غير البشرية، تسمي نفسها Voluntary Human Extinction Movement) )
وقد أثير حولها الكثير من الجدل لحداثة الفكرة وطرافتها، فيما يرى مؤسس الحركة أن جذورها تمتد الى عصور ما قبل التاريخ، ويشير الى سفر التكوين| الاصحاح السادس| 1-22. ندرج منه النصوص 5-7:
5- وَرَأَى الرَّبُّ أَنَّ شَرَّ الإِنْسَانِ قَدْ كَثُرَ فِي الأَرْضِ، وَأَنَّ كُلَّ تَصَوُّرِ أَفْكَارِ قَلْبِهِ إِنَّمَا هُوَ شِرِّيرٌ كُلَّ يَوْمٍ.
6- فَحَزِنَ الرَّبُّ أَنَّهُ عَمِلَ الإِنْسَانَ فِي الأَرْضِ، وَتَأَسَّفَ فِي قَلْبِهِ.
7- فَقَالَ الرَّبُّ: أَمْحُو عَنْ وَجْهِ الأَرْضِ الإِنْسَانَ الَّذِي خَلَقْتُهُ، الإِنْسَانَ مَعَ بَهَائِمَ وَدَبَّابَاتٍ وَطُيُورِ السَّمَاءِ، لأَنِّي حَزِنْتُ أَنِّي عَمِلْتُهُمْ.
رضاعة التسلية.. الطريق نحو التخدير!! ـ عبد القادر ملوك
 "رضاعة التسلية" هو مصطلح بالغ الدلالة أبدعه أحد كبار منظري النظام العالمي الجديد زبغنيو بريجنسكي[1]، و قد أورده مصطفى حجازي في مؤلفه ذائع الصيت "الإنسان المهدور" في سياق حديثه عن هدر الوعي الذي أمسى يتعرض له شباب العالم في عصرنا الراهن، و الشباب العربي بشكل خاص، بفعل برامج التسلية، أو برامج صناعة النجوم، التي تبثها شاشات القنوات التلفزية المتعددة.
"رضاعة التسلية" هو مصطلح بالغ الدلالة أبدعه أحد كبار منظري النظام العالمي الجديد زبغنيو بريجنسكي[1]، و قد أورده مصطفى حجازي في مؤلفه ذائع الصيت "الإنسان المهدور" في سياق حديثه عن هدر الوعي الذي أمسى يتعرض له شباب العالم في عصرنا الراهن، و الشباب العربي بشكل خاص، بفعل برامج التسلية، أو برامج صناعة النجوم، التي تبثها شاشات القنوات التلفزية المتعددة.
لقد شهد العالم المعاصر طفرة إعلامية و تكنولوجية هائلة ألقت بظلالها على نمط حياة الناس إيجابا كما سلبا؛ أما المنحى الايجابي فهو مما لا نجد وسيلة لنكرانه إذ باتت ملامحه بادية على جميع المستويات؛ إغناء الجانب التواصلي، رفاهية الحياة..الخ و ما يهمنا هنا هو المنحى السلبي ما دامت قراءتنا هذه قراءة نريد لها أن تكون متأزمة لنمط العلاقة السائدة بين التقدم التقني الإعلامي من جهة و بين المتلقي الشاب على وجه التحديد من جهة ثانية.












