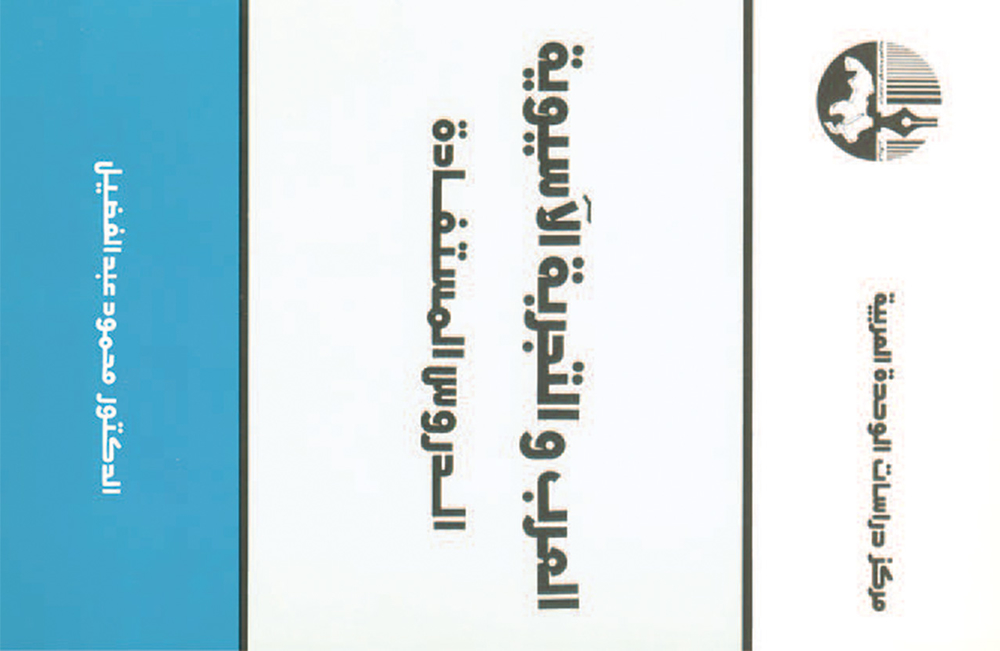كتاب من تأليف الباحث الاقتصادي المصري محمود عبد الفضيل، صدر عن مركز دراسات الوحدة العربية ببيروت في العام 2000، إذ انصرف موضوعه إلى تناول جملة من التجارب الآسيوية الناجحة في النهوض الاقتصادي، وتحديدا في دول سنغافورة، ماليزيا، كوريا الجنوبية، تايلاند، الصين، وذلك بغرض الوقوف على محددات النجاح التي يمكن الاسترشاد بها عربيا، فضلا عن بعض مواطن القصور في تلك التجارب، والتي يجدر بنا تلافيها عند الحديث عن أي أفق نهضوي عربي.
أولا: مقومات نجاح تجربة التنمية الآسيوية
يذهب المؤلف إلى أن تلك التجارب الآسيوية في الإقلاع الاقتصادي استندت إلى مجموعة من المقومات والدعامات في وسعنا تحديدها كما يلي:
* الدور المحوري الذي اضطلعت به الدولة في رسم التوجهات التنموية وتحديد الأولويات الاقتصادية، من خلال سياسات التخطيط المركزي الحكومي، بالموازاة مع إعطاء حوافز للقطاع الخاص من أجل الإسهام في العملية التنموية، الأمر الذي يتنافى مع الطرح النيوليبرالي المتوحش الذاهب إلى إلغاء أي دور تدخلي للحكومة والقطاع العام باعتباره عائقا أمام التنمية، بحيث لعب التخطيط الاستراتيجي طويل الأمد دورا أساسيا في إنجاح تلك التجارب الناهضة، وآية ذلك استمرار السياسات التنموية رغم تبدل القيادات والنظم السياسية.
* البعد الثقافي والقيمي من حيث هو محرك للتجارب التنموية في دول شرق آسيا، إذ ليس يخفى إسهام قيم معينة مثل الإخلاص والمثابرة في العمل (قوة عمل منضبطة ومؤهلة)، وشيوع ثقافة الادخار لدى الحكومات والأسر، في النهوض التنموي لتلك التجارب، وهنا تلعب الأخلاق الكونفوشيوسية وظيفة حيوية في هذا المضمار.
* نجاح استراتيجية التصنيع كمدخل للطفرة التنموية بالدول الآسيوية، إذ يشدد الكاتب على التحول الذي عرفه الهيكل الصناعي لجهة التحول من صناعات خفيفة إلى صناعات ثقيلة، ومن صناعات تقليدية (كالنسيج) إلى صناعات حديثة ذات قيمة مضافة عالية (كالصناعات الإلكترونية). وهنا وجب التشديد على أهمية قطاع التصدير من خلال الاستثمار في الصناعات التصديرية، إذ نجحت منتجات تلك الدول في اختراق أسواق استهلاكية متقدمة (كالسوق الأمريكية) بفضل سلعها الرخيصة من حيث التكلفة، وجودتها القريبة من السلع الأصلية المقلدة.
* دور المأسسة والتنظيم، بالإضافة إلى اعتماد طرق الإدارة الحديثة في النجاح التنموي لتجارب النمور الآسيوية، فضلا عن الالتقائية والتكامل بين مختلف فروع وقطاعات ومؤسسات الاقتصاد الوطني.
* استراتيجيات التطوير التقاني (العدد الكبير من براءات الاختراع)، فقد اتسم النموذج التنموي في تلك الدول، مثلما يلحظ المؤلف، بسلوك "مسار مختلط"، إذ تميز في مراحله الأولى (1970- 1985) ب "تعبئة الموارد" (التوسع في التوظيف، الاستثمارات الكبيرة... إلخ)، ثم طفق ينحو شيئا فشيئا منذ نهاية الثمانينيات إلى الاعتماد على التراكم التقاني والمعرفي.
* نموذج اجتماعي ناجح إلى حد ما، يتصف بتحقيق حد أدنى من العدالة التوزيعية، مقارنة بتجارب أخرى فاشلة في هذا الباب كتجارب أمريكا اللاتينية.
* تراكم وتطور الرأسمال البشري بفضل نظام تعليمي متقدم، أمسى يتفوق في بعض الجوانب على النظم التعليمية في الدول الغربية.
ثانيا: الدروس المستفادة عربيا من التجربة الآسيوية
يرى صاحب الكتاب أن مسببات الفشل العربي لا تعزى إلى نقص في المدخرات المالية بل إلى "تبديدها"، ولا إلى قلة الاستثمارات بل ل "سوء توزيعها"، وليس إلى قلة رأس المال البشري وإنما إلى هجرة الكفاءات وعدم استثمارها، فضلا عن ضعف المأسسة وعدم إيلاء البحث العلمي المكانة التي يستحقها. ومن بين الدروس المستخلصة من التجربة الآسيوية أن المال لوحده لا يكفي لتحريك عجلة التنمية إذا لم يقترن بالكفاءة التنظيمية والتقدم التكنولوجي والرؤى الاستراتيجية، وذلك في معرض حديث المؤلف عن السر الكامن وراء الإسهام الفعلي للاستثمارات اليابانية في نجاح تجارب دول جنوب شرق آسيا، مقارنة بالأثر التنموي المحدود للاستثمارات الخليجية في الأقطار العربية.
كما يبسط الباحث عوامل أخرى تقف حائلا أمام تنمية الوطن العربي، وفي جملتها النزعة الاستهلاكية الجامحة التي ترجع إلى ضعف ثقافة الادخار لدى الأسر، علاوة على دور الحروب والصراعات الكثيرة بالمنطقة في استنزاف الموارد، وصولا إلى معطى مهم يتمثل في دور "العقلية الريعية" (من بين مظاهرها الاستهلاك المفرط واللهاث وراء الربح السريع) التي فاقم منها تراكم الثروة النفطية، مقارنة بالعقلية التنموية الإنتاجية في دول آسيا الناهضة، والاعتماد على "النفس الطويل" بدل استعجال الربح والمكسب.
على أن الكاتب لا يجنح إلى العدمية والتمادي في جلد الذات، إذ يشير إلى أن مجموعة من التجارب التنموية الآسيوية (بما في ذلك اليابان) استفادت من ظروف الحرب الباردة والدعم المالي الغربي السخي، بحيث كان لدول الغرب – وفي مقدمتها – أمريكا مصلحة في قيام تجارب رأسمالية جذابة في آسيا، في ظل التهديد الشيوعي الزاحف إلى آسيا وقتئذ، والصادر من الاتحاد السوفييتي وشيوعية ماو قبل تحول الصين إلى اقتصاد السوق وفق منظورها الخاص. وبالمقابل لم تتوفر ظروف موضوعية مشجعة للنهوض التنموي بالوطن العربي، الذي طالما ظل مطمعا للقوى الإمبريالية الدولية.
كما كرس الباحث محورا للحديث عن الأزمة المالية التي طالت بلدان جنوب شرق آسيا منذ صيف 1997 بفعل هشاشة قطاعها المالي، ومن بين مسببات تلك الأزمة: انتشار المضاربات العقارية والمالية، ارتفاع مديونية المصارف بالعملات الأجنبية، مظاهر فساد مالي من قبيل قروض المجاملة لأفراد من النخبة السياسية دون ضمانات فعلية... إلخ، مع الإشارة إلى أن تلك الأزمة لم تؤثر على القطاع العيني (الإنتاج، التصدير) الذي يشكل عضد الاقتصاد القومي لتلك البلدان، والذي يقوم على أسس وطيدة، ولذا سرعان ما استعادت اقتصادات تلك الدول توازنها تدريجيا مع حلول عام 2000 بعد التداعيات التي ألمت بها من جراء الأزمة المالية (انكماش اقتصادي، بطالة... إلخ). وعليه، فإن الدرس المستخلص هنا بالنسبة للعرب والدول النامية عموما هو وجوب ضبط حركة "الأموال الساخنة"، والتي ترمز إلى رؤوس الأموال قصيرة الأجل الباحثة عن الربح السريع، وبالتالي ضرورة الانفتاح الحذر والمحسوب على السوق العالمية، وتدفقات رؤوس الأموال الأجنبية، التي يجب أن تتركز على الاستثمار في القطاعات الإنتاجية التصديرية.
وفيما يخص السؤال المتعلق بمدى إمكانية استنبات تلك التجارب في التربة العربية، يرى الكاتب أن تجربة "النمور الأربعة الأوائل" (كوريا الجنوبية، سنغافورة، تايوان، هونغ كونغ) يصعب استنساخها، بالنظر إلى استفادتها من ظروف الحرب الباردة كما سبق الذكر، وصغر حجمها (باستثناء كوريا) الذي ييسر لها إشباع الحاجات الأساسية لمواطنيها، بالإضافة إلى أن تلك التجارب التنموية لم تكن نابعة من دينامية تصنيع وتطوير داخلية، إذ استفادت من إقامة الشركات دولية النشاط منصات تصدير في بلدانها، ومن ثم عمدت مباشرة إلى التصدير دون المرور بمرحلة "الإحلال محل الواردات". وبالمقابل يعتقد الباحث بأن التجارب التي في وسعنا الاقتداء بها تتمثل في: كوريا الجنوبية في طبعتها الثانية من مسار تطورها التنموي، ماليزيا، الصين، الهند، وهي التي شرعت أولا في بناء قاعدة صناعية قوية قبل أن تفلح في اختراق الأسواق العالمية.