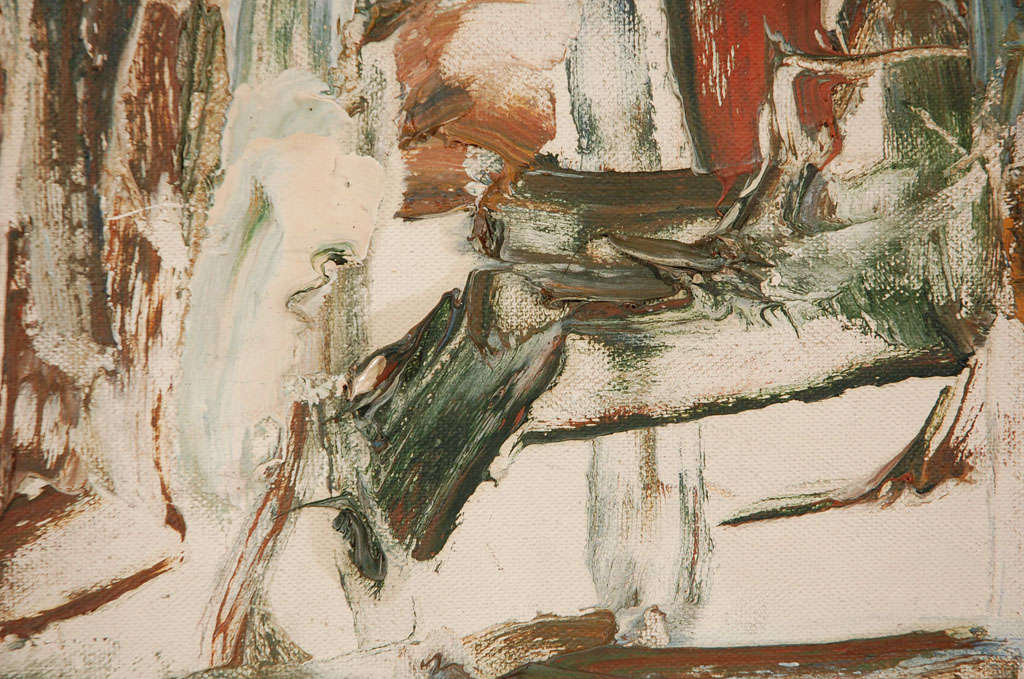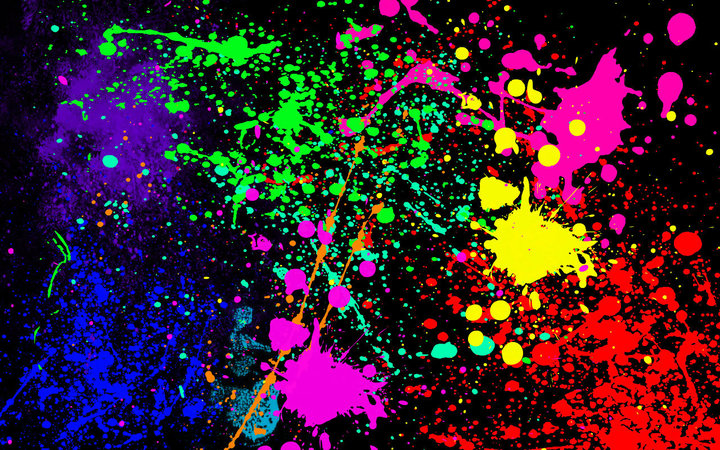أناخ قلمي رحاله في أراض عجاف، شاب فوده وخبا صوته المبحوح، ليتوارى بزيه المهترئ بعيدا عن الأضواء، عن بهرجة الأقلام الصداحة للقلوب الماجنة...بين يدي الراعشة كف عن الأنين، وبقلب مكلوم من طول الرحلة حدقت مليا في الأنف المعقوف المكرمش، والجسد النحيل الذي ارتخى على كفنه في البياض المهيب، وباحتفاء وحنين للانتشاء رحبت الورقة بغازيها، لكنها فوجئت بسكونه، لذا تمايلت يمنة ويسرة مستمدة أنفاسا من الريح المتسللة من نافذتي ..
الرياض العنبري –قصة : عبد الرحيم اجليلي
بساط من شقائق النعمان و زهور الياسمين، تحضن شمس الأصيل و تراقصها. أطفال من علية القوم بأزيائهم البهية، يتسلقون شجرات التوت الوارفة الظلال، المتناثرة كعساكر تحرس الحقول على طريق سلا. يتطلعون في أمهاتهم و هن يتكلفن في الكلام و يتصنعن ما يليق بالسيدات، زوجات العمال و القضاة و قادة الجيش. في مثل هذا الوقت من كل عام، يخرجن إلى الحقول المترامية قرب الرياض العنبري للنزهة مع أولادهن، يحرسهن بعض العبيد، يفترشن قطائف زيانية تزينها موزونات تتلألأ كالمرايا و تبهر النظر.
كانت تتحاشى لقاء نظرتيهما، تحاول في كل مرة إخفاء ارتباكها بالحديث عن جمال الورود المختلفة الألوان. كلما كلمتها سيدتها، اصطنعت ابتسامات كاذبة و ارتسم الوجوم على وجهها و عادت إلى شرودها. أخبرها رودريغ أن السلطان يدبر مؤامرة على مدينة أخواله، و أن ضربته ستكون قاسية. لا تدري، إن هي أفشت سر المؤامرة، ماذا يكون مصيرها و مصير فارسها و من معه من نصارى الجيش السلطاني.
انكسار ـ قصة : الحسين لحفاوي
ذاكرة مدينته عقيمة كأرحام بعض النساء، حين عاد إليها يوما يبحث عن خلاص من ذاكرته الموبوءة، احتضنته أسوارها، فوأد خلفها أفراحه و كتب وصيته على شاهدة قبرها. مد إليها يده مصالحا فاعترضته فوهات البنادق المتمترسة خلف بقايا صور كانت و لا تزال تسكن ركنا من روحه، وجوه الصبايا المطلة من خلف النوافذ، و أصوات الصبية اللاعبين بين الأزقة و في الباحات و صوت المؤذن الصادح...كل ذلك تهاوى و وُئِدَ تحت ركام صومعة و تناثر مع دموع اليتامى و الأرامل. و صَمَتَ الجميع، فلا صوت يعلو فوق صوت الأزيز.
الضوء و السراب - نص : بلفقيه رشيد
في اللحظة التي تتلو ضغطة زر الكهرباء و انطفاء النور ، في تلك اللحيظة القصيرة جدا و الحاسمة ، خيل إليه أنه رأى شخصا يحدق فيه ببرود مخيف من بين طيات الظلام المنسكب. أعاد إشعال المصباح بسرعة و أرخى السمع مترقبا أي حركة تدل على وجود ذلك الشبح المتخيل ، لكن لاشيء .
أعاد إطفاء النور و بدأ يحس بتلك القشعريرة الغريبة تسري في جسده ، سرت كالتيار الكهربائي انطلاقا من رأسه نازلة عبر شرايين جسده متدفقة مع الدم لتصل إلى مفاصله، انتصب شعره و شدة هواجسه تزداد شيئا فشيئا . سبح خياله في الظلام الدامس متخيلا العفاريت و الجثث و الجنيات المتعطشة للدم و الأعضاء البشرية تحوم حوله ، أحس بعيون ما ترمقه في الظلام و أحس كأن أياد مجهولة تحاول لمسه و الامساك به ، زاد تحفزه و ارتفعت حدة سمعه حتى صارت أدق حركة تبلغه و كأنها تبت عبر مكبر صوتي .
ما وراء هديلك يا حمامة؟ - نص : أحمد العكيدي
حمامة بيضاء تتنقل من غصن إلى أخر، تعزف أحلى الألحان وأشجاها، ترقص أجمل الرقصات وأروعها، ترسم لوحات الحب على إيقاعات نسمات الرياح الهادئة، تسبح في الفضاء بدون هموم تثقلها...
توقف عن الكتابة فجأة وأخد يعبث بقلمه، تارة يمرره من يد إلى أخرى بخفة ويدحرجه على الطاولة تارة أخرى، ثم تأمل أخر ما كتب :" بدون هموم تثقلها ". رفع رأسه وتتبع حركاتها حتى سكنت واستقرت على جدار يقابل غرفته، استمع من جديد إلى هديلها كأنه يسمعه أول مرة، تصورها تعزف سمفونية الحب لحبيبها حينا وتشتكي حزنها ورتابتها أحيانا، ربما تفكر في الغد المجهول أو في الماضي القريب...
إبريق القهوة الثاني - قصة : إيفان بونين - ترجمها د. جودت هوشيار
إنها موديله ، وعشيقته ، وربة بيته . تعيش معه في المرسم الخاص به في شارع زنامينكا : صفراء الشعر ، ليست طويلة القامة ، ولكنها حسنة القوام. ولا تزال في ميعة الصبا ، جميلة حانية . هو الآن يرسمها في الصباح في لوحة " المستحمة " وكأنها واقفة على منصة صغيرة ، عند جدول في الغابة ، مترددة في النزول الى الماء ، حيث الضفادع التي تحدق بعيونها الجاحظة. أنها عاربة تماماً بجسمها الناضج ، نضوج أجساد الفتيات من عامة الشعب ، وهي تغطي الشعر الذهبي في الأسفل بيدها . بعد ساعة عمل انحرف الفنان عن حامل اللوحة واغمض عينيه قليلا واخذ يتمعن في اللوحة من هذه الجهة او تلك ، ويقول ساهماً :
حسناً ، لنأخذ فترة إستراحة . سخّني ابريق القهوة الثاني .
ملابس سهرة!! ـ قصة : ندى بوخبزة
عبثا حاولت ان أنسج قماش قصيدة، أكسو به جسد أحزاني، فكانت صنارة القلم تنكسر أمام قسوة صوف الألم وتعجز آلة الحياكة الأدبية عن الترصيف في جلدي.
يختنق صوتي ويتلاشى في غرفة لا هواء فيها، فأقع اسيرة الصمت، واكتفي عن مخاطبة هذه الدنيا.
وبعد فترة أتذكر صوتي فأستيقظ مذعورة واصرخ بكل ما أوتيت من قوة، لا للتنفيس عن الغضب الكامن في داخلي، بل لأتأكد فقط إن كان صوتي لا يزال موجودا.
وبعد التأكد أعود لصمتي..
تدخل أزرار الآهات لتملأ فراغ عروة الصمت، وتقفل قميص معاكسات القدر، وتشد ربطة عنق الانتظار....
أسماء العنوسة ـ نص : أسماء العسري
كنت في الخامسة عشرة عندما سمعت أن للنساء أسماء عدة، وذاك بسبب أعمارهن، وأن الأسماء ليست واحدة، حينها لم أفهم ما سمعت كل ما أذكره أنني خفت كثيراً وتساءلت قائلة: هل سيتغير إسمي حسب كل مرحلة من عمري؟ وكيف سأتقبل هذه المفارقة و أنا من أحبت إسمها حتى قبل تشكله في الألسن.
وبعد برهة من الزمن سمعت جارتنا تنادي ابنتها:
- يا أنت، فقلت هل بدأ سُلم السنون.
ومع ازدياد سنوات عمري بدأت أفهم قصة الأسماء
اسم الطفولة: طفلتي.
اسم المراهقة: حبيبتي.
اسم الشباب: أ، ب، ت، م، ع، ر ...كل الحروف.
واسم لمرحلة الأربعين، اسم العنوسة: عانس، لست أدري بعد من اخترع هذا الاسم، لنذهب جميعا إلى خانة الألغاز لفك شفرات هذا اللغز.