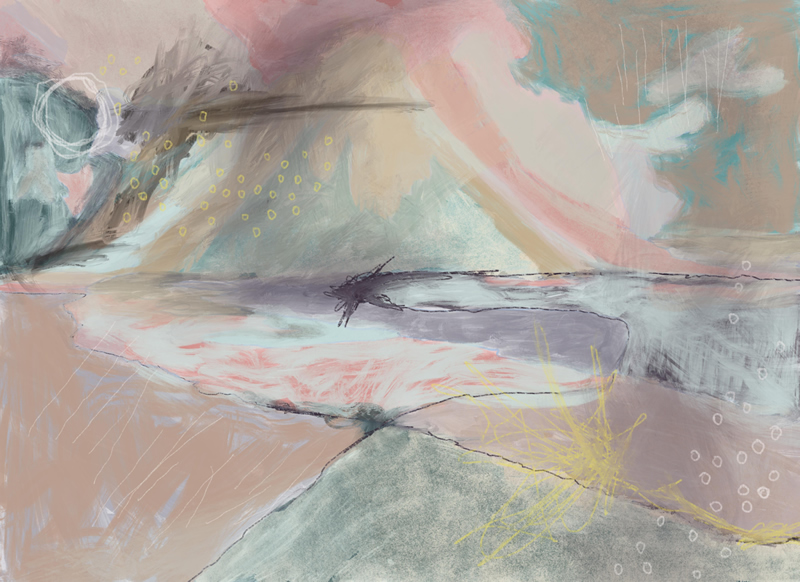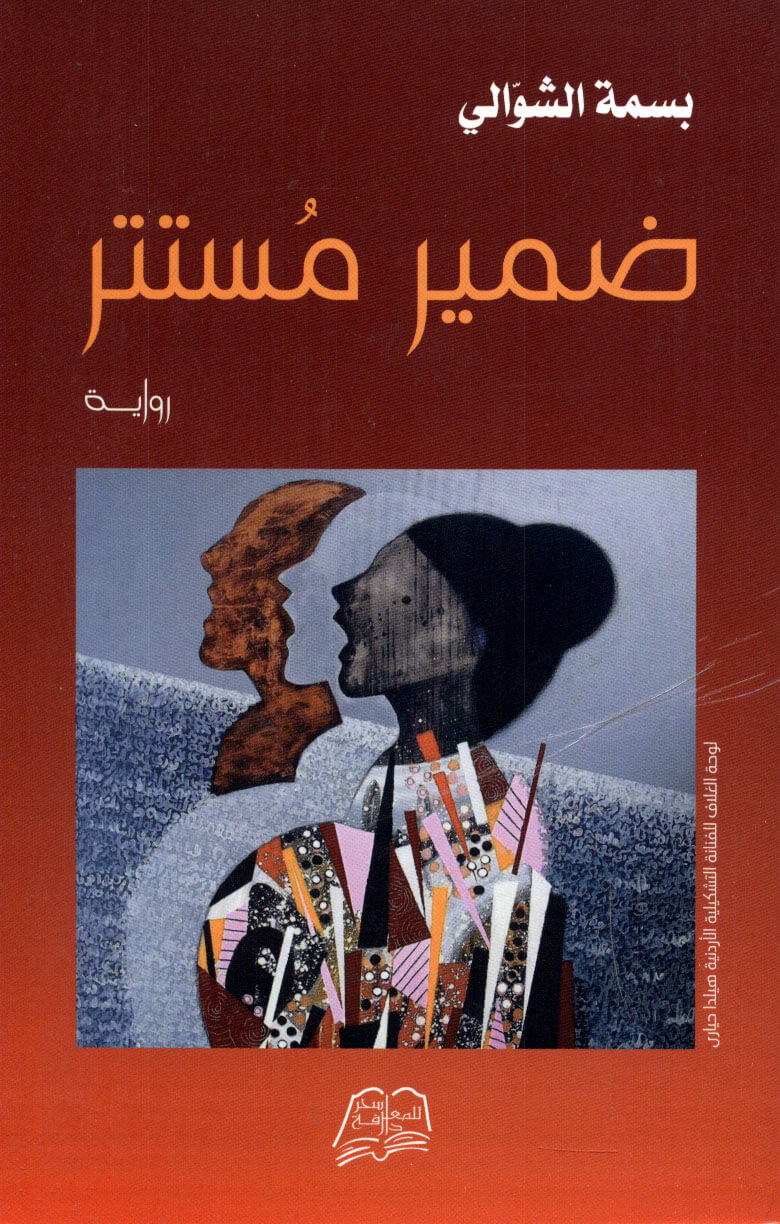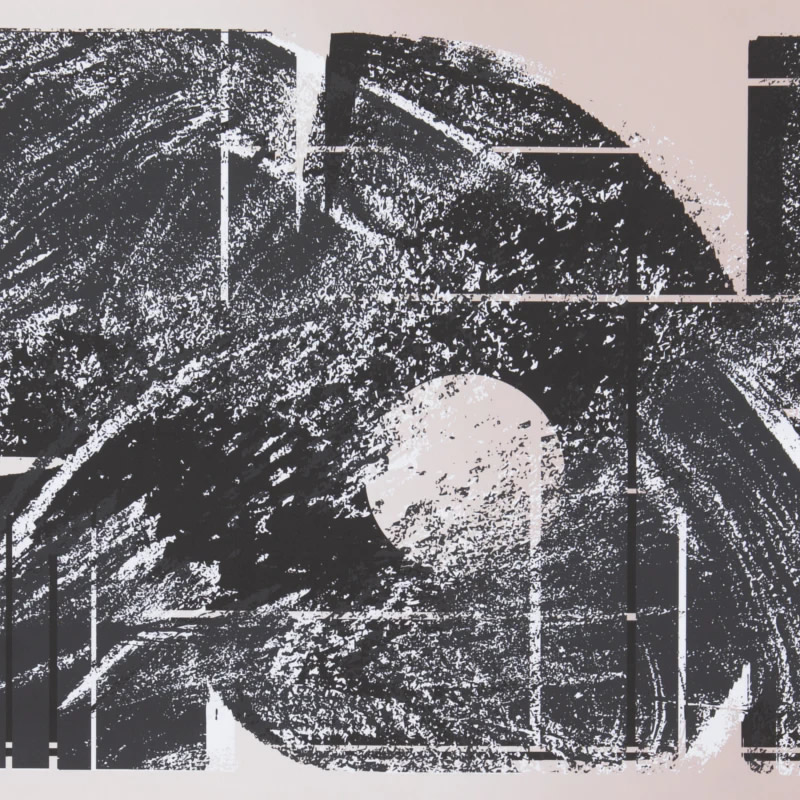دخل يجتر خطواته بخجل، نظرات مترددة وتائهة. كعزيز قوم ذل. يحمل بيده كيسا صغيرا من البلاستيك يحتوي على بعض الأوراق. يظهر على ملامحه التعب والخوف. نظر الي، ثم حول نظراته المضطربة اتجاه الموظف القابع وراء مكتبه. فعاد وجلس الى جانبي. وسألني بصوت خافت:
-هل هذا الرجل هو المسؤول هنا؟ سألني بكل عفوية وهو يتأمله.
-انه المسؤول عن مكتب المدير.
رفع رأسه بالإيجاب، وظلت نظراته تراقبه كأنه يبحث بين ثنايا مكتبه عن شيء ضائع منه. ثم قال لي:
- هل أنت أيضا تبحثين عن عمل؟ فنظر الى الكيس الذي بين يديه واختضنه كطفل عزيز وغالي.
أجبته دون أن أفهم مغزى سؤاله. وقلت له:
- أنا هنا لغرض آخر.
ابتسم بكل صدق. فجأة، قام واقترب من باب سكرتير المدير وطلب الاستئذان بالدخول، كان مؤدبا وخائفا. يقدم رجلا ويؤخر أخرى كمن سينفذ فيه حكم بالإعدام.
سأله سكرتير مكتب المدير:
- ماذا تريد؟
رضوض الذاكرة – قصة: الحسين لحفاوي
نهضنا معا وغادرنا المقهي وتركنا وراءنا الجدران الصماء والزبائن وخيوط الدخان وقرقعة النراجيل وأصوات ارتطام الفناجين بالطاولات. تقدمنا يتبع أحدنا الآخر حتى عبرنا الباب وقهقهات النادل تعلو على كل الأصوات.
احتوانا الشارع الطويل الممتد الذي لا ينتهي ومشينا صامتين موقِّعين بأقدامنا مثل جنديين أتقنا تدريبهما. وراح كل منا يغازل أهداب ذكرى ويلج أنفاق روحه التي لم يتسن للآخر الدنو منها.
سرنا. لست أدري أطال بنا المسير أم قصر. تحيط بنا من الجانبين أشجار باسقة متشبثة بالتراب تعاند الأعمدة والجدران المحاذية وترتفع هاماتها لتلامس أسلاك الهاتف. احتمينا بظلها من لفح الهاجرة واتقينا بأغصانها الوارفة أشعة الشمس المنهالة فوق رأسينا بلا رحمة مثل حديد مُذاب.
أصوات متداخلة تكاد تثقب آذاننا، منبهات سيارات، أزيز فرامل، نداءات باعة جوالين، تغاريد بلابل، عربدة أطفال طائشين يعاكسون فتاة، هدير طائرة تعبر الجو، صفير قطار منهك يعلن انتهاء رحلة شاقة ومضنية...تمر من أمامي قطة بفروها البني اللامع تحمل بين فكيها صغيرها باحثة له عن مكان آمن.
الشارع الطويل الممتد لا ينتهي وهذه الأصوات المتداخلة تنسج أنغاما يعجز عن وضع نوتاتها أمهر العازفين. كنا نسير معا جنبا إلى جنب، لكن روح كل منا تخوض عباب يم بعيد عن الآخر. يمتطي كل منا صهوة جواد محمحم فُكَّ لجامه وأُطلِق له العنان فانطلق يعدو لا تكاد حوافر تلامس الأرض، كلما بلله العرق ازدادت سرعته حتى كاد يحلق في الفضاء، يجوب فيافي موحلة ويجوس خلال آفاق بلا حدود، يطأ أرضا ملغومة حينا وقفرا حينا لا شجر ولا ماء، وحدها الرياح تتناوح فيها يعلو فحيحها وينخفض، يتسربل بين الفجاج والشعاب المقفرة المميتة.
تطبيع – قصة: حميد بن خيبش
رأيت في المنام أني أذبحه. كان جارا طيبا وصغاره ودودون للغاية، أما الزوجة فلا تظهر إلا صبيحة الأحد لنشر الغسيل. في المرات القليلة التي تقابلنا على الدرج أظهر تواضعا وأدبا جما. يسأل عن الصحة والأولاد ثم يلج شقته بسرعة كأنما يخشى مزيدا من الكلام.
تعودت على هذا الصنف من الجيران الذي يُنشئ حدودا وهمية للإبقاء على الود في نطاق ضيق، فقصص الأسر التي خرّبها تطفل الجيران ودخولهم بين الظفر واللحم عديدة. قدّرت حرصه وأبقيت على تحية خفيفة، وتهنئة بحلول العيد؛ لكن شيئا ما بداخلي كان يهمس بأن خلف جاري ذي الملامح الجنوبية قصة ستنكشف خيوطها يوما ما.
يومها مالت الشمس إلى المغيب بينما كان اللغط في شقة الجار يرتفع. تظاهرنا باللامبالاة لولا أن صراخ زوجته بأن يُعتق أحد روحها دفعنا لطرق الباب. كانت اللحظة اختبارا لأدبه الجم، غير أنه بدا هادئا كأن شيئا لم يكن. شكرنا على حرصنا واهتمامنا، ثم قال بأن الأمر شأن داخلي ولا داعي للتدخل.
-هل نتصل بالشرطة؟ سألَت زوجتي. أجبت بأن حضور الشرطة قد ينزع فتيل الحرب مؤقتا، لكنه سيكهرب علاقتنا مع الجار لأمد طويل.
- لنتريث قليلا إذن، فإن عادت إلى الصراخ مجددا فلا مناص من إحضارهم.
رواية "ضمير مستتر" : الفصل الثاني - بسمة الشوالي
-1-
Je creuserai la terre/ Jusqu'après ma mort/ Pour couvrir ton corps/ D'or et de lumière/ Je ferai un domaine/ où l'amour sera roi/ où l'amour sera loi/ où tu seras reine/
جاك بْرالْ، يرقرق صوته الفضيّ ما بين الأرض والسّماء. سماء تضيء كلّ أصابعها شموعا احتفالا بليلة الميلاد السّبعين لميسيو رينيه رجل الأعمال التونسيّ الفرنسيّ ومالك سلسلة محلاّت الأحذية وحقائب اليد النسائيّة الحاملة للماركة العالميّة: RenéBOO
ليل مصاب بأرق صيفيّ مزمن، كلّما راود غفوة عن نفسها باغته العشاق. سرير من رمل نديّ يغمّس أصابعه في بحر متهيّج على خلاف الهدوء الوقْر الذي يلبس قامة السّاعة، متضرّمٍ كحقل أحوى تركض فيه الأمواج قطيعا من الجياد البّريّة ترجّع الجوانب الصخريّة صهيلها المحموم، وتغتسل في رغوة أنفاسها الرّمال. قطعة من ساحل مسوّر بمقاطع صخريّة متفاوتة الأحجام رُصّفت بذائقة طبيعيّة ساحرة حتى الرّهبة وانشداه الحواسّ، حدّ الرّغبة في اختلاق سبب ما للبكاء الجنائزيّ علنا يفضي بنا رأسا إلى ضحك عبثيّ يغسل جراحاتنا بمحلول ملحيّ لطيف، حدّ افتعال فجيعة استثنائيّة تليق بذلك الحزن العتيق الغامض المتلألئ فينا كطبقة جوفيّة من الكوارتز تقع على حدود المدّ البحريّ للخيبة..
عودي – قصة: أسماء العسري
في يوم من أيام الصيف الحارة، أيام الفراغ التي تراودني بين الفينة و الأخرى، رن جرس الهاتف، وكالعادة بقي لحظة صمت؛ قبل أن ينطق كلماته، قال صباح الخير، هل يمكننا أن نشرب فنجان القهوة معا هذا المساء؟ قبل أن أجيب أغلق الخط؛ من دون حتى كلمة وداع.
انفتحت جروح الذكريات من جديد، وبدأت الأفكار الإيجابية و السلبية في الصراع على سلطة الفكر، فما كان مني إلا أن قطعت هذا الحبل، حتى لا يتدلى بعيدا، بدأت في الاستعداد قبل الموعد بساعات؛ كأنني سأقابل قيصر روما، ارتديت فستاني المخملي المطرز من الذيل، وتعطرت بأفضل العطور عندي، وانتعلت كعبي العالي، ووضعت قبعة رأسي، وتركت شعري منسدلا بين ضفاف كتفي، ولم أضع لمسة الكحل فضلت أن أترك عيوني تظهر بريقها تحت أشعة الشمس؛ عيون تحمل حضارات الحزن القديمة من بغداد إلى آخر العصور.
خرجت مسرعة لا أدري هل من لهفة شوقي أم من لهفة فضولي، أخذت سيارة أجرة، وصلت إلى الموعد المحدد قبله بساعة، دخلت المقهى وأخذت طاولتي، وبدأ توقيت هذه اللحظة في العد التنازلي، وصل في الموعد المحدد، وكان قد مر بون من الزمن على آخر موعد لنا؛ ومع ذلك اكتفى بكلمة مرحبا من دون حتى النظر في وجهي.
رماد من نوع خاص - قصة: محمد محضار
احترقت أفكاره هذا الصباح وصارت رمادا ،حاول أن يعيد لها الحياة ،تخيّلها طائر فينيق ينبعث من رماده ،لكن خَياله لم يسعفه ..لم يحدث شيء ،ظلت أفكاره رمادا وظل هو حائرا، مترددا خائفا ،اقترب من كوم الرماد، أقعى ثم حفّن مدّاً ،قربه من أنفه كانت رائحة الرماد زكية ذكرته بعطور فرنسية كانت تضعها زوجته، مثل ايف سان لوران ،أو لولو كاشريل، وربما أيضا " رِيف دور " عِطر أمه وجدته المفضل، أيّ صاعقة لئيمة هذه التي استأثرت بأفكاره فأحالتها على هذا الحال؟
أهو تفريط منه أم هي صدفة لعينة؟ تساؤلات رهيبة تَشج رأسه ولا يجد لها جوابا.
رِزق – قصة: حميد بن خيبش
بعد أن غسّلوه كفّنوه، ثم حملوا النعش بخفة إلى مسجد الحي للصلاة عليه. كبّروا أربع تكبيرات، تخللها دعاء بأن الحاج يستحق من ربه ما لاعين رأت ولا أذن سمعت. وعلى الأكتاف مرة أخرى سارت به جموع المصلين إلى حفرته وديدانه، وما قدم في صحيفة أعماله.
تعشوا عشاء المفارق لخليله. بين اللقمة والأخرى تنهيدة واستغفار، وتحذير للعباد من الوثوق بدنيا بنت كلب. رددوا آمين بينما آذانهم تسترق السمع لهذا اللغط المتزايد في حجرة أخرى. لعلها قريبة تبدي لوعة الفراق، وتذكر محاسن الفقيد. بدا صوت ابنه البكر واضحا وهو يؤكد أن الوصية بخط يد المرحوم، لا شك في ذلك، لكنه لن ينفذ منها شيئا ولو على رقبته.
بعد أن تعشوا سار كل منهم إلى حال سبيله وهو يترقب انبلاج الصبح. خبر كهذا قد يصيب الحومة بالأرق، فنصف دورها من عرق الحاج وكدحه في الغربة. مربع سكني صار يعرف باسمه في مكاتب المقاطعة، ويلهج السماسرة بالثناء على ولد "ماما" الذي حل أزمة الكراء في ثلث البلدة، والسعيد من جاور دار الحاج العامرة.
إلى جوارهم طوت ماما عقدين من عمرها دون مشاكل. وحين أظهر رجولته يوما بركوب البحر إلى بلاد الصبليون، طمأنوه بأنهم الأهل والكنف إلى أن تستقر أحواله. يعانقها وتودعه كل صيف، لكنها تأبى غربة ثانية في بلاد لايعرفون الوضوء ولا القِبلة. يرجوها وترجوه ثم يفترقان. وفي عامه الثامن كان للحي الذي يوشك أن يتداعى، قصة أخرى مع ولد ماما.
أظهروا تأففهم من رزمة الأوراق التي يتأبطها ابنه البكر، متنقلا بين القيادة وسرية الدرك الملكي. عش نهار تسمع اخبار. وما هي إلا ساعات حتى ولجوا مقر الدرك للرد على اتهام بتزوير عقود كراء طويلة الأمد. تنهيدة واستغفار، ثم تنديد بقبح العالم الذي أخرج من ظهر الحاج فاسقا.
- هذا رزقكم، قال الحاج مصرا على أن يحضروا يومها إلى مكتب العدول. سومة كراء رمزية للأحباب الذين آنسوا وحشة "ماما"، وملأوا عليها الدار في غيابه. عليهم أن يكرموا جميله بالوقوف في وجه الورثة. تزوير؟ ألهذا الحد ترخص العِشرة والمودة؟ تريكة الصبليون، لا دين ولا مروءة. ارتسمت على شفاههم ابتسامة وهم يذكرون سخرية الحاج من حفاظات صغارهم:
ضربة في الهواء.. – نص: عبد القادر القادري
يوجد في حالة مضطربة لا يحسد عليها ..لم ينم قاسم هذه الليلة ، وبات يتقلب في الفراش، والرأس تتصارع فيه آلاف الهواجس والأسئلة.. ولقاؤه بالمديرصار يؤرقه منذ أيام..
إن قاسم حديث العهد بمدرسة القرية التي عين بها قبل شهرين، وهو الآن يرغب في مقابلة مدير المدرسة، ليعتذر له عن سوء الأدب الذي بدر منه في حفلة جمعته بالتلاميذ في بداية هذا الموسم الدراسي..
حاصره التردد ولكنه قرر أخيرا مقابلة المدير« سأشرح له دواعي اللقاء..كنت كثير الشرود خلال الحفل ..وسهوت عن تقديم واجب التحية احتراما..»، بذلك حدث نفسه وهو يشق طريقه نحو ادارة المدرسة..
في مكتب المدير كانت الموظفة المكلفة بالاستقبال منشغلة في ترتيب أوراق على الطاولة، حين بادرها قائلا:
- أريد مقابلة السيد المدير.. لوسمحت..
- ما موضوع الزيارة يا أستاذ؟
وتلعثم قاسم .. فهو لم يكن ينتظر مثل هذا السؤال..
- موضوع خاص..