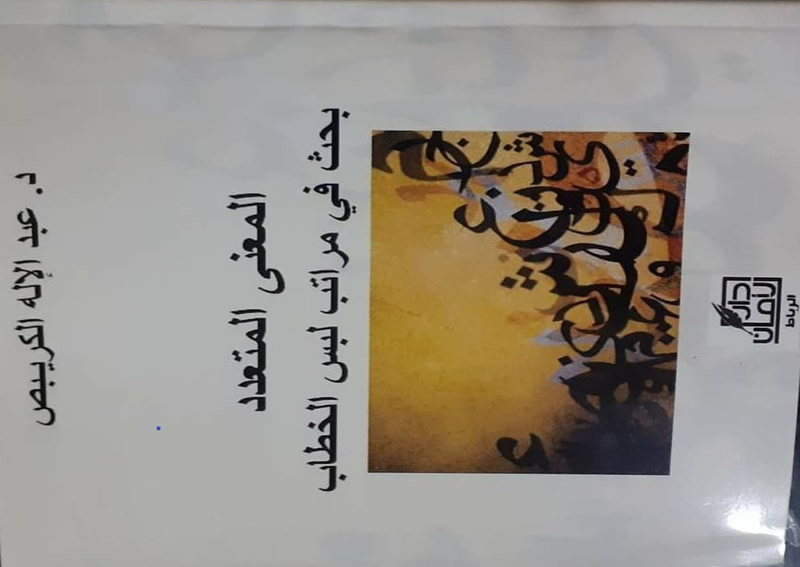- فـي البدء كان اللَّـبس
يُــشكّل سُؤال المعنى أسَّ الوجودِ الإنسانيِّ. إنَّ ما يميّزُ الإنسانَ عن بَـــاقِي الكائناتِ هو قدرتهُ على خلقِ عالمٍ رمزيٍّ قوامهُ علاماتٌ متعدّدةُ الأشكالِ والأنواعِ والمظاهر؛ عالم مفتوح على تعدُّد الدّلالات والمعاني. ولعلّ هذا التعدُّد عائدٌ، حسب "إرنست كاسرير"، إلــى حركةِ الوعي الإنسانيّ -بما هو فاعِليةٌ تتأسّس على المفهمةِ والسميأةِ- المتناوسة بين قانونيْ الجبذِ والنبذِ.[1] جبذٌ يتجهُ نحو الــمرجعِ في محاولةِ رسمهِ على شاشةِ الذهن، ونبذٌ يستنسخُ رسوماً يُدمنها الذهن فتصيرُ نموذجَ قياسٍ )أو بنية تعرّف بتعبير "أمبرتو إيكو"( تحضرُ من خلالهِ الوقائعُ في الذهنِ. وتأتي الــلّغة، على امتداد هذه الــمسافةِ، لــتُغطيَ، ما ارتسمَ في الــعقلِ صوراً، بلباس لفظيّ يظلُّ، دوماً، منذوراً لــقصورِ الـتّمثيل: فالكلمة ليست واقعاً، بل هي صيغةٌ رمزيةٌ عنه. كان أرسطو يقولُ: "أنْ نقول شيئاً عن شيءٍ ما، معناهُ أن نقولَ شيئاً آخر".
بهذا المعنى، تنشرخ صدوع اللَّبسِ- بعدِّه خصيصةً نسقيةً مُحايثةً للغة/ الخطاب- مُشْرِعَةً المجالَ أمام تعدُّد الــمعاني. وبكلماتِ "ش.س.بورس" سيظلّ الــماثول* اللسانيُّ عاجزاً عن تدثير الـمعطى الخارجي على نحوٍ كليٍّ؛ فعملية التمثيل تتمّ، أولاً، استناداً إلى حدودِ عمادٍ** محكومٍ برؤيةٍ قطاعيةٍ للمُمَـثَّـــل، وتتمّ، ثانياً، وَفق مقتضياتِ التوسّط الإلزاميّ الواقعِ تحتَ قانونِ الــمؤول***. بعبارةٍ أُخرى، لا تستطيعُ الكلمةُ أن تغطيَ المرجعَ من كلّ جهاتهِ، بل تكتفي بتغطيةِ جزءٍ منهُ، وتتركُ الباقي للترادفِ، الذي يعتبرُ، في هندسة اللغة، سدّاً لنقصٍ نسقيّ أصليّ في عملياتِ التمثيل، وليسَ ترفاً دلالياً زائداً.
ضمن هذه الآفاقِ المعرفيّة المتشعّبة، ووفقَ تصورٍ سميو لسانيّ مركّب، يتنزّلُ كتابُ الباحثِ المغربيّ " عبد الإلــه الكَريبص": "المعنى المتعدّد: بحثٌ في مراتبِ لَبسِ الخطابِ"، لـيقدّمَ مقترباً نظرياً وتطبيقياً، مبني على آلياتٍ وأدواتٍ لسانيّـة وتداوليّة ودلاليّة وفلسفيّة متسقة ومنسجمة، تمتحُ نُسوغها من النظريّة اللغويّة العربيّة والغربيّة القديمة والحديثة. يسمحُ هذا الــمقتربُ، أولاً، بتمييز اللَّبسِ عن باقي الظواهرِ اللغوية المشابهةِ له. ويمكّن، ثانياً، من توقّع مواقعهِ وتحديدِ كثافته وسُمكه، ويتيحُ، بعدَ هذا وذاك، وضعَ ضوابطَ واضحةٍ تأمنُ الوقوعَ في اللَّبسِ وتَضَمَنُ صفاءَ الـمعنى جَهد الإمكانِ (لا صفاءَ مطلقَ في اللغة؛ هناكَ، دوماً، مناطقُ معتمةٌ، ومغبّشةٌ، وزلقةٌ...).
سنحاولُ في هذه الورقةِ، بإيجازٍ سريعٍ، إبرازَ أهميّة هذا الـمقترب النظريّ والتحليليّ بالتركيز على أهمِّ القضايا الواردةِ في الكتابِ، والوقوف عند الرؤية المناهجيّة المعتمدة في التصميم والبناءِ، مع تحديدِ الرهانات والآفاق المنشودةِ.
- الـــتّـصميم المنهجيُّ: تماسكُ البناءِ، وضوحُ الــرؤيةِ، وثراءٌ المضامين
ينهض كتابُ "المعنى المتعدّد" على خطةٍ منهجيّةٍ قوامُها الأبواب المشدودةُ تنظيراً وتطبيقاً إلى النظريّـة اللغويّـة وسؤال المعنى المتعدّد. وقد أَفْضَى القَلَقُ العلميّ-وهو قلقٌ يشفّ عن عمق الإحساسِ بإشكال التعدّد الدّلالي ومنابته وطرق ضبط حركته داخل الخطابِ -بالباحث إلى تنظيم مادّته المعرفيّة تنظيماً متماسكاً، ومترابطاً منطقياً ودلالياً؛ إذْ قسّم الباحثُ كتابه إلى أربعةِ أبوابٍ تنضوي تحتها، بشكلٍ متدرجٍ ودقيقٍ، مَجمُوعةٌ مِن الفُصولِ الـمُتفرّعة، بدورها، إلى محاورَ صُغرى. فضلاً عن ذلك، اُسْتُهلّ الكتابُ بتقديمٍ عامٍ، حُدِّدَت فيه قيمة المشروع وامتداداته التاريخيّة وأهدافه والإشكالات الكُبرى التي تؤطّره، مع بيانِ مسارات بنائه نظرياً ومنهجيًا. بينما اُختُتِم الكتابُ بخاتمةٍ استجمع فيها الكاتب كلّ الخلاصاتِ التي توصّل إليها، بعد بحثٍ دقيقٍ في سؤال المعنى المتعدّد داخل النظرية اللغويّة على أصعدة مختلفة.
في البابِ الأوّل الـموسومِ بــ"تحصيل المعنى"، تناولَ الباحثُ ظاهرة اللَّبس – من حيثُ علاقتُها بمحتوى الملفوظات- عبرَ فصلين متكاملين: أفردَ الفصل الأوّل للحديث عن المباحث الدّلاليّة في التراث العربيّ المتبديّةِ، توالياً، في قضية تكامل الرؤى بين الحقول المعرفيّة، وقضية الدّليل والمرجعِ، واستراتيجية الفهم والـإفهام، ثم قضية تصنيف الدلالات. فمعلومٌ أن المنظومةَ اللغويّة العربيّة القديمة، بمختلف مصادرها وعلومها واتجاهاتها، انصهرت ضمن مجالٍ تحليليٍّ غايتهُ فهم النّص القرآني والإلحاف بأبعاده الدينيّة والأنطولوجيّة والكونيّة. وقد صاغت هذه المنظومةُ متصوراتٍ لغويّة بالغةِ الأصالةِ والعمق، كانت، بفضلها، سبّاقة لفكِ شيفرة مجموعةِ من القضايا اللسانيّة والتداوليّة والدلاليّة: فما قدّمه الغــزالي والسيوطي والجاحظ والشاطبي وغيرهم في مسائل الدليل والمرجع وتصنيف الدلالات واستراتيجيات الفهم والإفهام وغيرها من القضايا، يمكنُ عدُّه، بحقٍ، ثورة لغويةً لها موقع متميز في مجال الدراساتِ اللغويّة عالمياً. في الفصل الثاني المعنون بـ" علم الدّلالة في الفكر الغربي"، يوضّح الباحث أنّ الـدّلالة، باعتبارها نسيجاً علميًّا مُستقلاً، لـم تظهر إلا في منتصف القرن التاسع عشر، وقد ظلّت، ردحًا طويلاً من الزّمن، رازحةً تحتَ رؤية الخطابِ الفلسفيّ الذي ما انفكّ ينظرُ إليها بصفتها مَعْبَراً ضروريا لبناءِ خطابه. الأمرُ نفسهُ سيعادُ، بصيغة أخرى، مع اللسانيات البنيوية واللسانيات التوليديّة اللتين أقصيتا مُشكل الدلالة من مجال بحثهما؛ نظراً لإيمانها بأن البحثَ اللغويّ ينبغي أن يكون تقنياً وصفياً مُرَكِّزاً على القواعد الكليّة البانيةِ للغةِ. ولـم يُعترف بأهمية المكون الدّلالي إلا انطلاقاً من سنتي 1963-1964، حينَ عجزَ التركيب عن تقديم إجاباتٍ عن الكثير من الأسئلة وعلى رأسها سؤال اللَّبسِ.
خصّص الباحثُ الباب الثاني، الموسوم بـ "ظواهر لغوية ملتبسة" للحديث عن الظواهر المعجميّة والتركيبيّة الملتبسة باعتماد رؤية تحليليّةٍ تطبيقيةٍ. في الفصل الأوّل عرضَ الظواهر المعجميّة الملتبسة ممثلةً في الاشتراك والتضاد والمجاز، مقدِّماً مقترحاتٍ عمليّة لقراءات دلاليّة ممكنة للملفوظاتِ استناداً إلى ما تمّ التوصُّل إليه في النظريّة الدلاليّة خاصّة في النموذج التوليديّ. في حين أفردَ الفصل الثاني لتتبّع الظواهر التركيبية التي تُعَرِّضُ الخطاب للالتباس حاصرًا إياها في الـمستويات التّالية: المستوى الأول مرتبطٌ بــ"اللَّبس الاصطناعيّ"؛ حيث تتعدّد دلالات بعض المقولات الوظيفيّة، فيترتب عليها تعدّد المضامين على قدر إمكانات الاستعمال المتاحةِ. المستوى الثاني يتعلّق بــ"البنيات الإضافية الملتبسةِ" والمتجلي، على نحو رئيس، في التباس بنية الإضافة ثم اللّبس المتعلق بعود الضمير. ويكشف هذا البابُ إلمامَ الباحثِ بقضايا علوم الآلة العربيّة، نحواً وصرفاً وإعراباً وتركيباً وبلاغةً، وقُدرته على وصلها بالدّرس اللساني والدّلالي الحديث، ما مكّنه على صياغة تصورٍ سميو لسانيّ ذي كفاءةٍ تفسيريّة عاليةٍ في معالجة قضايا اللّبس والتعدّد الدّلاليّ.
في البابِ الثالث الـمعنون بــــ" من اللَّبس إلى الغموضِ: التصوّر النقديّ لإشكال المعنى"، انطلق الباحث، في الفصل الأوّل، من تحديد سؤال المعنى ضمن الموروث النقديّ. موروثٌ بُنيَ على مطلبِ الوضوحِ في المعاني الشعريّة، وكل شعرَ انزاحَ عن الإبانة باللفظِ المبينِ الجليّ عُدَّ إفساداً وإغراباً. أما الفصل الثاني فخُصِّصَ لعرضِ التصور النقديّ للغة الشّعرِ من منظور المدارس النقديّة الحديثة (الشعريّة البنيويّة، الشعريــّة التوليدية، نظرية أفعال الكلام... ) التي استثمرت المقولات اللسانيّة والشعريّة (Poétique) في النّظر إلى لغة الشّعر وتعرُّف مسار تُبَنْيُنِها وتشكّلها ورصد مواقعِ الانزياح فيها. وقدّ وضّح الباحثُ أن غموضَ الشّعر لم يكن بسبب لَبْسِ الملفوظِ، وإنما الأمرُ راجعٌ إلى غموضهِ. والفرقُ بين اللّبس والغموض بادٍ؛ فاللَّبسُ خصيصةٌ نسقيّةٌ ملازمةٌ للملفوظاتِ بحكم قوةٍ النسقِ، أما الغموضُ فتقنيةٌ مقصودةٌ يلوذُ بها المتكلم بدافعٍ مقاميّ، يَفرضُ عليه، هذا الدّافعُ، بناءَ خطابٍ غامضٍ غموضاً غيرَ تامٍ يكتفي بالإلماع والإيماضِ والإبراق.
ويأتي الباب الــرّابع من الكتابِ لتحديد الروافد والعناصر المؤثر في تشكُّل المعطى الدلاليّ في الشعر العربيّ الحديث وظيفةً ومحتوى. في الفصل الأوّل من هذا البابِ يرصدُ الباحث ما يجمعُ القول الصوفيّ والقول الشعريّ. فمعروفٌ أن المتصوفةَ جمحوا باللغة صوبَ ظلالٍ هاربةٍ منفلتةٍ يَعسرُ ضبطُ سريان دلالاتها. هذا الهروب المنفلتُ المقصودُ للدّلالات ولّد تعدّداً يصعبُ حصرهُ، فكان الغموض وليدَ استراتيجيّة محكمةٍ غايتها الإخفاء. وقد وجد الشعراءُ المحدثون في هذه التقنية أداةً مثلى لتفجير طاقات القول الشّعريّ وتجنبِ المتابعات السياسيّة. في الفصل الأخير يقترحُ الباحث منظورين يسمحان بضبط العناصر المحدّدة للغموض الشعريّ، وهما: الغموض المسقط والغموض المحايث. يرتبطُ الغموضُ المسقَطُ بالخلفياتِ الثقافيّةِ والرمزيّةِ والأنثروبولوجيّةِ والميثولوجيّةِ التي يغترف منها الشاعر فتتردّد أصداؤها في جسد القصيدة. في حين يرتهن الغموض المحايث بجوهر التجربة الشعريّة وجوانيّة النص، وقد حصره الباحث في أربعة عناصر هي: الإخلال بمبادئ العقل الأساس، وغموض الإحالة والإسناد، ثم الحذف والاستعارة والتشاكل. ولـم يتوقف الباحث عند هذا الحدّ بل اعتمدَ متناً شعرياً متنوعاً ومختلفاً لاستيضاح كل هذه العناصر تطبيقيا مُقدّما بذلكِ طريقةً في الفهم والتحليل.
نستشفّ، بناءً على ما تقدّم، أنّ كتابَ " المعنى المتعدّد" ينبني على هندسة منهجيّةٍ واضحةٍ، مترابطة، ومتدرّجةٍ في عرضِ المعطى العلميِّ. فلا يغيب عن النظر، أنّ الكتاب مُنَضَّدٌ على شكلِ وحداتٍ متسقةٍ، منسجمةٍ، يرتبط سابقها بلاحقها. وهذا أمرٌ دالٌ على تحكّم الكاتب بالمجالِ المعرفيّ قيد الدّراسة تصوراً ورؤيةً ومنهجاً.
- الـرؤية المناهجيّة: نحو تصوّر سميو لسانيّ مركّب لفكّ لَبس الخطاب
لا يعزب عن نظرِ قارئِ كتابِ "المعنى الــمتعدّد" اعتمادُ كاتبهِ ترسانةً مناهجيّةً مَكِينَةً؛ سِمتُها الأساس التفاعلُ بين الأنساقِ المعرفيّة وفقَ رؤيةٍ إدماجيّة عَالِمةٍ. لقدَ أدركَ الكاتبُ، وهو جالسٌ إلى مِنْضدته التأمليّةِ، أنّ سؤال المعنى متشعبٌ ومركّبٌ ويقعُ في صلبِ تقاطع علومٍ وتخصّصاتٍ لسانيّةٍ ودلاليّةٍ ونقديّةٍ. لهذا كانَ الإلحافُ به يقتضي بلورةَ نموذجٍ تحليليٍّ مركّب يغترفُ أدواته، بوعي وخبرةٍ وحذقٍ، من حقولٍ معرفيّةٍ متنوعةٍ ومتعدِّدةٍ، تتراءى، ترتيباً، داخل الكتابِ في ما يلي: النظرية اللغويّة العربيّة القديمة، وفلسفة اللغة، واللسانياتِ البنيوية، واللسانيات التوليديّة، وعلم الدّلالة، والشعرية البنيويّة، ونظرية أفعال الكلام، ثمّ السّميائيات البنيوية ممثلةً في مدرسة باريس لتحليل الخطاب والسّرد. كلّ هذه المرجعياتِ المناهجيّة وظّفت عبرَ استيحاءِ آلياتها التحليليّـة ذاتِ القوةِ الإنتاجيّةِ بغية فكّ لَبسِ الخطابِ وتحديدِ مراتبهِ وتعرُّف مساربِ الهروب الدّلاليّ نحو التعدّد والتنوّعِ.
وقد تنزّلت هذه التّوليفة المناهجيّة المعتمدة، في معالجة إشكال المعنى المتعدّد، ضمن مستويين تحليليين متعانقين ومتساوقين: مستوى تاريخيٌّ استعرضَ فيه الباحثُ مسار نمو الظاهرة والوعي بها والطرق النّظر إليها، ومستوى نسقيٌّ يلامس الظاهر من خلال تحقّقها النصيّ في اللّغة العادية كما في اللغة الإبداعيّة. وهذا ما يعني بعبارة أخرى، أن الفهم السّانكروني (الآني) للظاهرةِ يظلّ قاصراً؛ دونَ مردوديّةٍ تحليليةٍ، ما لم يأخذِ بحسبانهِ الوعيَ الدياكروني (التعاقبي) لهذه الظاهرة. فاللغة تتحركُ على ركحِ التّاريخ وفي كلّ مرحلةٍ تَعْرُوهَا تغيُّرات نسقيّة لا يمكن فهم كنهها دونَ إصاخة السمعِ لأزيز الزمن في طواياها.
وبالمحصّلة فإنّ كتابَ "الــمعنى المتعدّد" يعدُّ إسهاماً نظرياً وتطبيقياً مُهماً في مجال دراسةِ سُؤال المعنى المتعدّد؛ فهو يعيدُ النّظرَ إلى هذا السؤال من موقع الجمعِ والوصلِ والإدماجِ لما تفرّق في غيره من الكتب التي طرقت الموضوع في زوايا نظرٍ مغايرةٍ. ويبقى هذا الإسهامُ، بتعبير صاحب الكتابِ، مُشرعاً على المراجعةِ والتوسيعِ والتعميقِ.
- رهاناتُ الكتابِ وآفاقهُ: نحو مجتمعٍ إنسانيّ يؤمن بالاختلاف والعيش المشتركِ
إلى جانبِ الرهانِ المعرفي الذي ينطوي عليها كتابُ "الـمعنى المتعدّد"، نلفي رهاناتٍ أُخرى -بعضها معلنٌ وبعضها مضمرٌ- لا تبعدُ عن المعرفة ومقتضياتها. إن الكتابَ يقرّ بكون اللغةِ منبعاً دفّاقاً بالدّلالات والمعاني التي لا يمكن، قطعاً، حصرها، لأنّها تنتسبُ إلى الزمنِ الإنساني في امتدادهِ وشُسوعه وأعماقه الموغلة في التاريخ. وستظلّ اللغة، دوماً، على ثرائها الباذخِ منذورةً لاستيلادِ الصورِ والتصوراتِ والأفكارِ. فهي الحوضُ الدّلاليّ، بتعبير جيلبر دوران، الذي تخبئ فيه الإنسانيّة وعيها ولا وعيها.
وهنا يأتي كتابُ "الـمعنى المتعدّد" ليقول لنا، بلسانٍ سمحٍ، إن التعدّد أصلٌ أما الأحاديةُ فهي لحظةٌ عرضيةٌ عاريةٌ تشفُّ عن أشدّ المناطق ضحالةً في الوجود الإنسانيّ. إنّ أمن اللَّبس ليس سوى صيغةٍ أخرى للقولِ إنّ المجتمعَ مدعوٌ إلى بناءِ جسورِ التواصلِ والتّفاهم والعيش المشتركِ ضمن متاحٍ لغويّ يحفظُ تعدّده الخلاقَ تحتَ إطارٍ عامٍ قانونهُ التعاونُ والاحترامُ والوضوحُ.
صفوةُ القول إن هذا الكتابُ يقدّم رؤية فكريةً ذات امتدادٍ وجوديٍّ؛ فإلى جانبِ إمكان سحبَ تصوراته على باقي أنواعِ الخطابات الإنسانيّة، بمكنتنا، أيضاً، أن نفعّلها في تواصلنا اليوميّ لتدبير الشأن الخاصِ والعامِ.
- هوامش وإحالات:
عبد الإلــه الكَريبص: الــمعنى المتعدّد؛ بحثٌ في مراتبِ لَبس الخطابِ، منشورات دار الأمان، الرباط، 2020.
[1] - Ernest Cassirer : Philosophie des formes symbolique, le langage, éd. Minuit, 1972.
* (Représentamen): يشكّل الـماثول في مصطلحيّة بورس العنصر الأوّل في العلامةِ. ويُعتبر أداةً لتمثيل العالم الخارجيّ؛ إنــه، وَفق هذا التصور، حاملٌ لصورة ما. ويمكن مقارنته بالــدّال عند دي سوسير، إلا أن الفرقَ بين الماثول والدال يكمن في كون الأوّل ليس من طبيعة لسانيّة فقط، بل إنه مرتبطٌ بكلّ الأنساق الدّالة، في حين أن الثاني مرتبطٌ، حصراً، باللسان.
** (Fondement): والمقصودُ به عند بورس أن عملية التمثيل تتمّ داخلَ حدودٍ إقصائيّةٍ محدّدة. إن العماد هو انتقاءٌ خاصٌ يتم وفق وجهة نظر معنية، ذلك أن ماثولاً واحداً لا يستوعب المعطى الـمُمَثَّل كليًّا، بل يُغطي جزءاً منه فقط؛ وهو ما يبرر تعدّد المرادفات داخل اللغة، فهذه المرادفات لا تتساوى دلاليًّا على نحو كامل، بل إنها تُكمل نقصان بعضها البعض.
*** (Interprétant): يتحدّد المؤول- وهو ليس الشّخص الذي يقوم بالتأويل- بعدِّه آليةً داخل العلامة تسمحُ بإمكان الإحالة والتدلال. إنه، بهذا المعنى، العنصر الثالثُ في علامة عند بورس، وعبرهُ يستطيع السميوزيس، بما هو إعناءٌ وتدليلٌ، أن يخلقَ مناطق التعدّد الدلالي. (للاطلاع على تصورات شارل سندرس بورس بشكل شاملٍ يمكن العودة إلى كتابه الرائد: Ecrits sur le signe, Ed Seuil, paris 1978)