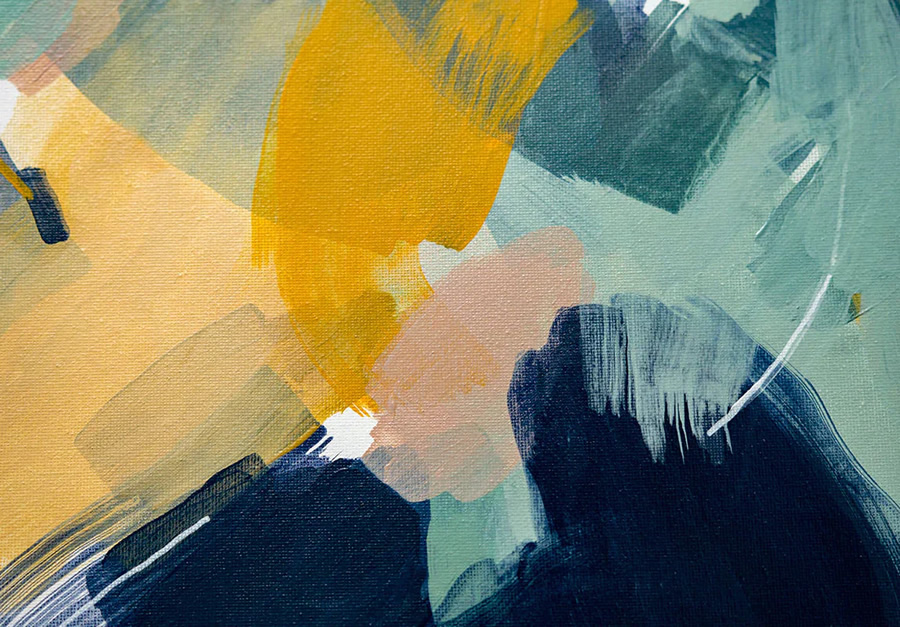يبدو أن التفكير في الأدب لا ينفصل عن الممارسة الأدبية نفسها، على الأقل حين تمر هذه الممارسة عبر الكتابة: إضافة إلى الثقافة الغربية، فإن كل الحضارات التي عرفت الكتابة، سواء أتعلق الأمر بالهند، أم الصين، أم اليابان، أم بالفضاء الثقافي الشاسع للأمة الإسلامية، قد أنتجت ثقافة محلية حول الإنتاجات الأدبية. صحيح أن طريقة التفكير التي طورها الغرب قد بدأت نتزع إلى استئصال أنماط التفكير المحلية، منذ القرن التاسع عشر، بموازاة مع التوسع السياسي والاقتصادي للحضارة الغربية: ولكن من المهم أيضا أن نؤكد على أن الحضارة الغربية لا تنفرد بالتفكير في اللغة، كما أن المفاهيم الوصفية والمنهجية المؤسسة لتقاليدها النقدية لا تشكل النمط الوحيد الوجيه للتفكير في الأدب.
ليس مجالنا هنا أن نقدم عرضا لتاريخ التفكير في الأدب عند الغربيين، والذي لم يتوقف عن مواكبة التطور الأدبي بأشكاله المختلفة ، منذ أرسطو وحتى خلال العصر الوسيط (خلافا للرأي الشائع)، (انظر كلوبش، 1980، هوغ ، 1985). سنقتصر هنا على التذكير ببعض الوقائع العامة التي يمكن أن تساعد على فهم أحسن للوضع الراهن.النموذج الكلاسيكي
منذ العصور القديمة حتى نهاية القرن الثامن عشر عموما، مورس التفكير في الأدب أساسا وفق ثلاثة محاور، مع اختلاف في التأكيد على هذا العنصر أو ذاك باختلاف العصور:
1) الشعرية: والمقصود بذلك دراسة الوقائع الأدبية من زاوية الفن اللفظي. إن التفكير في فن الشعر الذي أسسه أرسطو كشكل خاص للدراسة، قد ظل حاضرا عبر العصور، رغم أنه سيفقد بسرعة استقلاليته التي منحها له صاحب كتاب فن الشعر، وسوف يتم احتواؤه من طرف البلاغة. واقتضى الحال أن ننتظر عصر النهضة، وإعادة اكتشاف نص أرسطو لكي تستعيد الشعرية استقلاليتها.
2) البلاغة: وتعني تحليل الخطابات ، وخاصة مجموع الوسائل المستخدمة لضمان التواصل الجيد. إنها مهارة تقنية مرتبطة بالحياة العمومية أولا ( يجب أن يتعلم المرء الوسائل اللسانية المناسبة للاستخدام من أجل تحقيق الهدف المقصود)، ومع ذلك فإنها تحمل في طياتها منذ البداية مكونا تحليليا ما دام اكتساب فن الخطابة يمر عبر دراسة النماذج الخطابية الجيدة. ولأسباب تاريخية ( ومنها على الخصوص تراجع الديمقراطية في العصور القديمة)، فإن النصوص الأدبية بحصر المعنى ( الأعمال التخييلية والشعر) ستحظى بمكانة متزايدة الأهمية على مستوى النماذج الخطابية التي تشكل موضوعا للنقاش. وفي نفس الوقت، فإن الخطاب الأدبي سيحتل مكانة مركزية بين الأجناس الخطابية المدروسة. وسوف يستمر هذا التطور خلال العصر المسيحي ليؤدي إلى إفقار حثيت وعنيف للبلاغة التي سيتم اختزالها تدريجيا لتقتصر على مشاكل البيان.
3) الهرمنوطيقا: والمقصود بها نظرية التأويل. ورغم اقتصارها في الأصل على النصوص المقدسة، فإنها تناولت أيضا منذ العصر الإسكندري المشكل الفقهي اللغوي المتعلق بتأسيس النصوص الآدبية الدنيوية. أضف إلى ذلك أن النصوص المقدسة في التقليد اليهودي والمسيحي تحمل مجموعة من القواسم البنيوية مع النصوص الدنيوية الترفيهية (نصوص سردية وشعرية): فبعض المشاكل الخاصة التي تتناولها هرمنوطيقا النصوص المقدسة تتدخل أيضا في فهم النصوص الأدبية بحصر المعنى، خاصة قضية الرمز والحكاية المجازية. وفي النهاية عوض النقد الفيلولوجي ابتداء من عصر النهضة بشكل متزايد هرمينوطيقا النصوص المقدسة، رغم اقتصارها في البداية على الأعمال المنتمية للعصور القديمة.
في دراسة كلاسيكية حول تقاليد النقد الغربي، ميز أبرامس ( 1953) بين أربعة ، وليس ثلاثة ، توجهات نقدية. حسب ما إذا كان الناقد يركز على الفنان المبدع، على العمل الإبداعي، على الواقع كما يعبر عنه هذا العمل أو كما يفهمه الجمهور المقصود بهذا العمل. لقد ميز أبرامس بين : النظريات التعبيرية، التي تحدد العمل الأدبي كتعبير عن ذاتية فنية؛ النظريات الموضوعية التي تحصر العمل الأدبي في بنيته النصية المحايثة؛ النظريات المحاكاتية التي تحدد هذا العمل في علاقته بالواقع الذي يمثله؛ وأخيرا النظريات التداولية التي تحلل العمل الأدبي من زاوية آثاره على المتلقي. تنتمي الشعرية طبعا للنظريات الموضوعية، وتنتمي البلاغة للنظريات التداولية. هذا صحيح على الأقل إذا التزمنا بالحدود الكلاسيكية لهذين المجالين المعرفيين، رغم أن هذه التحديدات قد تبدو إشكالية نظرا لصعوبة الفصل بين العوامل التركيبية والتداولية ضمن تحليل الخطاب. أما النظريات المحاكاتية فإنها تنتسب للقطب الهرمينوطيقي، إذا نظرنا إليها كنموذج مميز للتحليل الدلالي ( وهو عمليا تحليل من زاوية العناصر المرجعية). أما النظريات التعبيرية فلم تتطور بشكل فعال إلا مع العصر الرومانسي.
النموذج الرومنسي:
إن حقل الدراسات الأدبية كما يتجلى حاليا قد تم تحديده بشكل أساسي خلال القرن التاسع عشر، وخاصة من طرف الرومنسية (تودوروف 1977). هناك نقط كثيرة تستحق الاهتمام لأنها تسمح بفهم أحسن للجغرافية الراهنة للنقد الأدبي، في علاقاته ونقط اختلافه عن النقد الكلاسيكي:
1) في التقليد "الكلاسيكي"، كانت النظريات التي يسميها أبرامس "تعبيرية" غائبة فعليا. وفي المقابل أصبحت تلعب دورا متزايد الأهمية ابتداء من العصر الرومنسي، إلى حد أن الاعتقاد في عصرنا هذا بأن العمل الأدبي يعبر عن ذاتية الكاتب أضحى جزءا من البديهيات التي نادرا ما يتم التشكيك فيها. هذه الفكرة تقتضي تصورا خاصا ليس فقط للعمل الأدبي، ولكن أيضا للوجدان الذاتي، الذي يبدو غير منفصل عن التطور الحديث للحضارة الغربية.
2) منافسة لهذا التصور للعمل الأدبي كتعبير، تدافع الرومنسية عن أطروحة الطبيعة الغائية للعمل الأدبي كعمل يحيل على نفسه، وهي أطروحة لا تنسجم بوضوح مع التصور الأول، لأنه إذا كان العمل الأدبي يجد غايته في ذاته، فإنه يصبح إحالة ذاتية، ومن ثمة لا يعبر إلا عن نفسه. وفي جميع الأحوال، فإن هذا التصور يمثل دون شك أصلا لتطور الشعرية ( بجميع أشكالها) خلال القرن العشرين. ونتيجة لهذا ستستغرق الشعرية وقتا طويلا قبل أن تتحرر من التداخل بين الأطروحة ( القابلة للنقاش) والمتعلقة بالغائية الذاتية للعمل الأدبي والمبدأ المنهجي المتعلق باستقلالية دراسة العمل الأدبي باعتباره مثالا للفنون اللفظية. ( ؟؟؟)
3) رغم أن جذور الهرمينوطيقا تعود إلى العصور القديمة، فقد كان لزاما علينا أن ننتظر بزوغ العصر الرومنسي حتى نرى تطبيقاتها بشكل فعال على النصوص الأدبية القروسطية والمعاصرة. انتقال الهرمينوطيقا هذا من النصوص المقدسة والنصوص القديمة إلى النصوص الدنيوية ونصوص ما بعد العصور القديمة قد رافقه أحيانا نوع من التقديس غير المباشر للنصوص الأدبية. أضف إلى ذلك أن الهرمينوطيقا ذات النفحة الرومنسية قد سارت في اتجاهين متعارضين جدا :
أ) الهرمينوطيقا المقصدية: مرتبطة خاصة باسم شلييرماخر، وأدت إلى ولادة فقه اللغة الحديث، أي فعليا إلى ولادة فن تأويلي يخدم فهم النصوص، حيث يعني هذا الفهم إعادة بناء الدلالة المقصدية، أي دلالة النص التي يريدها الكاتب. ويحدث أحيانا أن نحدد فقه اللغة بصورة ضيقة كتقنية تخدم النقد التاريخي للنصوص. عمليا، يتضمن فقه اللغة هذا جزأين، كما سجل ذلك أوغست بويخ: النظرية الهرمنوطيقية، أي نظرية إعادة بناء الدلالة النصية ( عن طريق التأويل النحوي، التأويل الشخصي، والتاريخي والتكويني)، والنقد الهرمينوطيقي الذي يتمثل موضوعه الأساسي في تأسيس وإعادة تأسيس النصوص. ويقتضي النقد طبعا صلاحية النظرية التأويلية التي تمثل تطبيقا له.
النقد التكويني الحالي يندرج بشكل ما ضمن الامتداد الفيلولوجي، ما دام يرتكز على المقارنة بين حالات نصية. ولكن، إذا كانت الفيلولوجيا تهدف إلى تأسيس وإعادة تأسيس نص أصلي انطلاقا من حالات نصية تمت طباعتها بصور غير متجانسة ( بسبب تعدد النساخ مثلا )، فإن النقد التكويني يدرس ، على العكس من ذلك، الانتقالات بين حالات نصية يمكن إرجاعها إلى كاتب واحد، دون محاولة اختزالها في قواعد. يتعلق الأمر فعلا بدراسة الإجراءات الإبداعية كما تتجلى من خلال الحالات النصية المختلفة التي تبرز تحولات فعل الكتابة: إن النقد التكويني ينتمي انتماء كليا للشعرية.
ب) الهرمنوطيقا اللامقصدية التي يعتقد غالبا أنها لم تتطور إلا خلال القرن العشرين على خطى الفيلسوف هايدغر وتلميذه هـ. ج. كادامير، ولكنها توجد في الواقع منذ القرن التاسع عشر ( في علم الجمال الهيجلي مثلا ). وتكمن نواتها المنهجية في قابلية دلالاتها المقصدية المستخلصة من فهم النص للاختزال إلى دلالات خفية لا تفرضها مقصدية المستوى "السطحي". إن الهيرمينوطيقا اللامقصدية تؤدي عمليا إلى قراءة للأعمال الأدبية باعتبارها حاملة لمجموعة من الأعراض، وهو ما تتوافق فيه مع بعض نسخ النظرية التعبيرية حول العمل الأدبي.
4) بشكل مفارق، وعلى عكس ما يتم الدفاع عنه غالبا، لم تؤد أطروحة استقلال العمل الأدبي بالرومنسيين إلى تطوير تاريخ مستقل للأدب: لقد طبقوا عليه بشكل عام هيرمينوطيقا لامقصدية مرتكزة على فكرة مفادها أن الأعمال الأدبية تكشف عن حقيقة خفية، بحيث يصبح فهم الأدب مرادفا للرجوع إلى مضمونه الخفي. وجدت هذه الطريقة من قبل عند فريديريك شليجل الذي اعتبر أن تطور الأجناس الأدبية اليونانية يجب أن يفسر بالتطور السياسي للمجتمع برمته والذي تمثل الأجناس علامات دالة عنه. وقد أضفى هيجل طابعا منهجيا على هذه الطريقة التي ساهمت بأشكالها المختلفة في تحديد توجه تاريخ الأدب على نطاق واسع، بما في ذلك فترة القرن العشرين ( انظر أسفله ).
5) تطور النموذج الهيرمنوطيقي رافقه اختفاء لما تبقى من البلاغة الكلاسيكية المتهمة بتفكيك الوحدة العضوية للعمل الأدبي: وحدها نظرية الصور (التي اختزلت غالبا في نظرية للاستعارة ) ظلت حاضرة ، وقد تمت استعادتها ضمن نطاق الأسلوبية والشعرية. وكان علينا أن ننتظر النصف الثاني من القرن العشرين كي نشهد عودة لإشكالية البلاغة العامة ، وكي تتم، في ارتباط مع ذلك، إعادة الاعتبار بشكل جدي للبعد التداولي للأدب.
الجغرافية الحالية للدراسات الأدبية
للوهلة الأولى، يبدو نطاق أنواع النقد الأدبي الممارس حاليا شاسعا جدا، بل عشوائيا، سواء أتعلق الأمر بالمناهج المستعملة أو بالأهداف المقصودة. ورغم كل ذلك ، يمكن دون شك أن نرجع هذا التعدد إلى أربع توجهات أساسية، وهي :
أ) النقد المعياري للأعمال الأدبية الذي يندرج غالبا ضمن عملية نقل الموروث الأدبي (أو موروث مضاد) بواسطة المدرسة؛
ب ) التحليل التاريخي والمؤسسي للأدب كمجموعة من الممارسات الاجتماعية؛
ج ) الدرسات التأويلية التي تندرج بشكل عام ضمن إحدى الاتجاهات الحالية للهيرمنوطيقا اللامقصدية ؛
د ) نظريات القراءة ، وبصفة عامة نظريات التلقي الأدبي؛
هـ ) التحليل الشكلي بكل صوره ( السردياتي، الموضوعاتي، الأسلوبي ، التحليل البلاغي، النقد التوليدي، دراسة الإيقاع ، دراسة المعطيات النصية، دراسة الأجناس، الخ)، سواء أكان سانكرونيا أو دياكرونيا، والتي تندرج ضمن مشروع شعرية ذات طابع أرسطي.
لن نهتم هنا بالتنويعات المتعددة للنقد المعياري للأعمال الأدبية، لأن مشروعه قائم على التأثير وليس على المعرفة: تثمين المعيار الأدبي المقبول أو هدمه باسم معايير مضادة أخرى مختلفة. أما فيما يخص التوجهات النقدية الحالية التي تندرج ضمن منظور وصفي بشكل عام، فإنها ليست على نفس الدرجة من الملاءمة من وجهة نظر دراسة الأدب كواقعة لفظية، وهي وجهة النظر التي تؤطر حقل الدراسة في قاموسنا هذا . إنها طبعا مختلف الدراسات التي يمكن إدراجها ضمن إطار التحليل الشكلي ( بالمعنى الواسع للكلمة ) للإجراءات الإبداعية - ضمن إطار الشعرية إذن - التي تهتم بالطريقة الأكثر مباشرة لدراسة الأعمال الأدبية كتمثيل للاستخدام المبتكر للغة: بما أنها توجد في صلب المداخل المختلفة لهذا القاموس المخصصة للجانب الأدبي لدراسة اللغة ، فإننا لن نأخذها بعين الاعتبار في هذه اللمحة العامة. سنقتصر إذن هنا على تحديد مختصر للتوجهات الأساسية الثلاثة الأخرى للدراسات الأدبية الحالية، التحليل التاريخي والمؤسسي، نظريات القراءة والتلقي وكذا الدراسات التأويلية.
التحليل التاريخي والمؤسسي:
1. في فرنسا، مع بداية القرن، فرض تاريخ الأدب نفسه ضد التقليد البلاغي وثقافة الآداب الراقية لصالح تعديلات عميقة في منظومة التعليم العالي والثانوي بالجمهورية. لقد كف الأدب عن الاتنماء أساسا لخطاب متعلق بمعايير الخطاب أو بأحكام ذوقية، ليصبح موضوع دراسة وضعية وتاريخية. وهكذا أصبح تاريخ الأدب، بالنسبة لـلانسون، جزءا من تاريخ الحضارة. إن التقارب مع التاريخ، المهيمن آنذاك، ومع السوسيولوجيا لا يعني تطابق وضعية النص الأدبي مع وضعية الأرشيف ( فالأدب ماض وحاضر في نفس الوقت )، ولا يعني التخلي عن فرضية علم للذاتيات الخاصة.
إن تحديد العمل الأدبي يتم بطريقتين:
أ ) يتم عن طريق "طابعه المحايث": إنه يتشكل من كل الأعمال التي لا يتم الكشف عن معناها وأثرها كشفا تاما إلا بواسطة التحليل الجمالي للشكل" (لانسون، منهج تاريخ الأدب، 1910). في الواقع، يبقى تاريخ الأدب في العمق منشغلا بتبرير معيار للأعمال الأدبية النموذجية التي سيسمح النقد النصي بضبطها، وذلك بأن يسحب على الأدب الحديث تقنيات الفيلولوجيا الكلاسيكية الألمانية التي تم إدخالها إلى فرنسا وتم تطبيقها على اللغة الفرنسية القديمة من طرف ج . باريس ( انظر ب. سيركيغليني 1989؛ م . ويرنير و م. إيسبانيا 1990- 1994). ويكرس تاريخ الأدب جهوده لخلق منشورات نقدية ، إنشاء بيبليوغارفيات ودراسة المصادر والعوامل المؤثرة.
ب ) فيما يتعلق بالجمهور: سعى تاريخ الأدب إلى وضع تاريخ للذين يقرؤون، إلى جانب تاريخ للذوات التي تكتب؛ وخطط لوضع تاريخ اجتماعي للكتابة والثقافة. لكن عمليا ، تخلى مؤرخو الأدب بسرعة عن هذا الجانب من مشروعهم ( انظر ل. لوفيفر، "من لانسون إلى مورني، التخلي"، 1941؛ معارك من أجل التاريخ، 1953)، وأصبح تاريخ "الشروط الاجتماعية لإنتاج الأعمال الأدبية" (لانسون)، تاريخ المؤسسات الأدبية وتاريخ القراءة جزءا من مجال اهتمام المؤرخين والسوسيولوجيين بفرنسا. ومن بين الدراسات الحديثة العهد التي تندرج ضمن هذا التوجه يمكن أن نذكر الأعمال المخصصة لدراسة منشأ الصورة المؤسسية للكاتب ( فيالا ، 1985) وللحقل الأدبي الحديث ( شارلز 1979، بورديو 1992)، البحوث التاريخية حول ممارسات القراءة ( شارتييه 1985، لوغ 1987) وكذلك حول تاريخ النشر ( شارتييه و مارتان، منشورات، 1982-1986). بما أن اللغة والممارسات الخطابية تشكل جزءا من الواقع السوسيو- تاريخي (بما في ذلك الممارسات الأدبية) فإنه لا يمكن لأي تحليل أدبي أن يتجاهل هذه العوامل المؤسسية والتاريخية.
2- بالولايات المتحدة - وعلى إثر الدراسات النسوية، أحدثت التاريخانية الجديدة تغييرا آخر في تاريخ الأدب، بتأثير من أنتروبولوجيا الثقافة ( ك. جيرتز) وأعمال م. فوكو. تتناول التاريخانية الأدب والنصوص الأدبية على قدم المساواة مع تشكلات خطابية أخرى من المناسب إرجاعها إلى حظيرة مجموعات ثقافية أوسع كانت هذه التشكلات في الأصل جزءا منها. وتمكن المقاربة الأنتروبولوجية من معالجة إحدى الثغرات المزمنة في تاريخ الأدب: الافتراض الذي يجعله يتعامل مع الأدب كمعطى، كمقولة ثابتة مطابقة لنفسها على مر التاريخ، وليس كقطعة فنية أو كتصور معياري. إن الدراسات النسوية ( والدراسات الأفرو- أمريكية الأحدث عهدا) تسائل تاريخ الأدب كبناء، تسائل سلطة النص الأدبي، كما تسائل المشترك بين النصوص المعيارية وغير المعيارية، وبين الأجناس التخييلية والوثائق ( إلين شوالتر 1977). اقتداء بأعمال فوكو حول الممارسات الخطابية وتراتبية السلطة خلال العصر الكلاسيكي، اختارت أعمال التاريخانية الجديدة أن تنصب على ظهور وابتكار الأدب ( خلال عصر النهضة، العصر الإيليزابيثي والعصر الكلاسيكي) كما انصبت على كشف البعد التاريخي لمفهومه ( س. غرينبلات 1988، هـ. أ. غومبرخت 1992، ت. ج. ريس 1992).
إذا كانت العقود الأخيرة قد شهدت تطورا كبيرا في مجال المعرفة التاريخية بالأدب، فإننا نلاحظ مع ذلك أن هذا التطور قد انصب خاصة على التاريخ الآجتماعي والمؤسسي. بفرنسا، يبدو أن تاريخ الأدب كتاريخ للممارسات الإبداعية وللأعمال الأدبية يوجد في حالة ثبات نسبيا ( انظر موازان 1987). والأسباب في ذلك متعددة دون شك؛ بعضها منهجي، إذ لا زال تاريخ الأدب يفضل التقطيع الزمني والتحقيب - رغم أنهما مظهران غير أساسيين ضمن المنهج التاريخي ( فاين 1971)، ولا يستفيدان من القيمة التي تتيحها أدوات التحليل الكمي المتوفرة حاليا، كما هو شأن الببليوميتري ( علم الأنشطة العلمية) ( فايان 1990)، أو علم المعاجم الإحصائي ( بروني 1990). ومن جهة أخرى، فإن تاريخ الأدب لم يفلح أبدا في أن يحدد لنفسه موضوعا خاصا، إذ اقتصر على التنقل المستمر بين تاريخ للمؤسسات الأدبية، وكرونولوجيا للأعمال الأدبية، أو سير المؤلفين، أو تاريخ للأشكال أو نقد للأعمال الأدبية ( انظر كومبانيون 1983). وأخيرا يفترض تاريخ الأدب، ودون مساءلة غالبا، أن "الأدب" معطى تاريخي يجب تحليله، بينما مفهوم "الأدب" نفسه عمل معرفي عرضي قائم على معيار حصري تم وضعه (جزئيا على الأقل)، من طرف المجال المعرفي الذي يزعم أنه يقوم بتحليله.
هناك صعوبة أساسية تكمن في الطبيعة الإشكالية للعلاقة بين تاريخ الأدب والتاريخ. ففي فلسفة التاريخ ضمن الإرث الهيجلي الذي مارس تأثيرا على تاريخ الأدب، شكلت النصوص الأدبية، الاتجاه الواقعي والأدب الرفيع أداة ذات قيمة معرفية تسمح بالوصول إلى معرفة مجموع وضعية تاريخية ما ( ج. لوكاتش، ف. جيمسون 1981). ومع اختفاء هذا التصور للتاريخ كمسلسل موضوعي ومتصل، والذي كان يتيح أيضا إمكانية تفسير التطور التاريخي للأدب، فإن تاريخ الأدب لم يعد بإمكانه أن يحدد الكلية التاريخية أو التاريخ الجماعي المتميز الذي يشكل الأدب جزءا منه ( ر. كوزيليك 1990)؛ ورغم أن الأعمال الأدبية لا زالت موضوع تحديد تاريخي ضمن إطار تواريخ وطنية وتواريخ ثقافية ( لانسون : الأدب الفرنسي مظهر للحياة الوطنية )، فإن هذا التطبيق لتاريخ الأدب قائم على وعي متجاوز بالتاريخ. إن المفهوم الفوق تاريخي للأدب كظاهرة حاضرة في كل المجتمعات لا يمكنه أن يصمد بهذا المعنى ، ما دام قد كان هو نفسه مرتبطا بمثل هذا التصور للتاريخ ( كمسلسل موضوعي ثابت). ( هـ. أ. كومبرخت 1985؛ انظر أيضا م. بوردسلي 1973؛ نفس المشكل يطرح في تاريخ الفن، كما بين ذلك هـ. بيلتنغ 1989).
في هذه الشروط، يقترح هـ. أ. كومبرخت أن نفصل بين المنظور التاريخي والتقويم الجمالي (اللذين يتم الخلط بينهما عادة في تاريخ الأدب التقليدي)، من أجل التوصل إلى تاريخ براغماتي للأدب. المنطلق في ذلك هو الافتراض بأن النصوص الأدبية هي تشكيل موضوعي لوضعيات تواصلية خاصة، وموضوع متميز لإعادة بناء الذهنيات. بما أن علاقة النص الأدبي بمحيطه تحددها وضعيات تاريخية، فإن تاريخا للأدب كهذا سيتمثل في إعادة تشكيل العلاقات بين وضعيات تواصلية أدبية ويومية خاصة بكل مرحلة - مع العلم أن التمايز بين المراحل لا يمكن أن يتأسس فقط على معايير داخل-أدبية، ما دامت النصوص "الأدبية" ( المناسبة لتصورنا حول الوضعية التواصلية الأدبية ) لم تكن بمثابة وسائط في سياقات تفاعلية ماضية.
نظريات التلقي والقراءة
انبثقت الأعمال المتعلقة بجمالية التلقي المنتسبة لكل من مدرسة كونستانس، لنظرية التلقي وللتاريخانية الجديدة ( س. غرينبلات، أ. ليو، ت. ج . ريس ...) من نقد التاريخ الأدبي التقليدي ومن التحليل الشكلاني.
1 - يعتبر هـ . ر. جوس مؤسسا لجمالية التلقي. وأبرز ممثليه هم و. إيزر، ك. ستيرل، ر. وورنينغ. وقد وجه في نفس الوقت نقدا لتاريخ الأدب المستوحى من الماركسية كما انتقد التحليل البنيوي، إذ اعترض على نظرية الانعكاس التي يزعم بموجبها النقد الماركسي أنه سيفسر التطور التاريخي للأدب، وانتقد "تشييئ" النص الذي يؤدي إليه التحليل البنيوي. النموذج الذي يقترحه مستوحى من هيرمينوطيقا غادامير: لقد نقل مركز الاهتمام من العمل الأدبي كنتيجة لفعل فني إلى عملية تلقي هذا العمل، ونتيجة لذلك اعتقد أن بإمكانه أن يكتشف مجال بناء تيمات تاريخ الأدب ضمن الصور المتغيرة تاريخيا لهذا التلقي، أي ضمن تقاليد التلقي ( حتى وإن كانت متعارضة). ونسجل في نفس الوقت أن الأطروحة التي تضع هوية العمل الأدبي ليس ضمن الهوية التركيبية للنص ولكن ضمن مجموع البناءات القرائية المتغيرة تاريخيا، ليست متنافرة البتة مع الشكلانية : وهــكــذا فإن نظرية التأويل التي اقترحــها م . ريفاتير تقبل نفس المسلمة الأساسية ( وهي أن دلالة العمل الأدبي ليست هي الدلالة التي يقصد إليها الكاتب ولكن الدلالة التي يقوم القارئ ببنائها)، وهي نظرية لاتختلف عن منهج جوس إلا بالامتياز شبه المطلق الذي تخصصه للمستوى الشكلي للقراءة ( ريفاتير 1979).
لقد جددت جمالية التلقي بعمق قضية التأويل التاريخي للنصوص ( خاصة من خلال إدراج مفهوم أفق الانتظار). لكنها تواجه عددا من العوائق، خاصة على مستوى مناهج التحليل. بما أنها مناهج منبثقة عامة من الهرمينوطيقا النصية، فإنها تبدو غير متلائمة بشكل جيد مع موضوع التحليل الذي تحدده جمالية التلقي لنفسها، وهو التلقي التاريخي للأعمال الأدبية. من الصعب أن نتصور كيف يمكن أن ننجز دراسة لهذا التلقي التاريخي للأعمال الأدبية دون القيام بتحليل عملي ( تاريخي) لممارسات القراءة الفعلية، طالما تمكنا من إعادة بنائها ( وهو تحليل قد نبحث عنه دون جدوى في أعمال جوس، ويفرض علينا أن نتجه لأعمال المؤرخين كأعمال شارتييه) . الإمكانية الثانية تتمثل ربما في تجاوز جمالية التلقي بواسطة مشروع أنثروبولوجي صارم كما حاول القيام بذلك و. إيزر في آخر أعماله.
2. يمكن لنظرية التلقي أن تجد في أعمال إ. أ. ريشارد ( النقد التطبيقي، دراسة في تقييم الأدب، 1929) أو أعمال ل. روزنبلات حول العلاقة الخاصة بين أي قارئ وبين النصوص الأدبية ( الأدب كاستكشاف 1937) مقدمات لاهتماماتها. إنها تتعارض خاصة مع ميل النقد الجديد إلى اعتبار النص الأدبي معطى موضوعيا وإلى التمييز بين ماهية القصيدة الشعرية وأثرها على القارئ ( ويمسات و بوردسلاي، "التضليل العاطفي"، الرمز اللفظي، 1954 ) وتتبنى الافتراض الفينومينولوجي المتعلق باستحالة الفصل بين الذات والموضوع. إن مصطلح نظرية التلقي يشمل مجموعة من المقاربات (الفينومينولوجية، التفاعلية، البنيوية، التفكيكية ، البلاغية... ) التي تشترك في نقطة واحدة هي تركيزها على فعل القراءة. بعضها يتصور قراءا متميزين ( ن. ن. هولاند، د. بليش)، وبعضها الآخر يفترض وجود مجموعات من القراء توحدهم استراتيجيات مشتركة ( س. فيش، ج. كولر). وكلها تعوض تحليل النص في ذاته بموضوع التفاعل بين القارئ والنص وبالنشاط المعرفي للقارئ؛ لقد انتقل الاهتمام النقدي إلى زمانية القراءة كمسلسل استشرافي واسترجاعي، كتحيين تدريجي لدلالة العمل الأدبي، في تعارض مع التركيز على فضاء النص أو القصيدة، ومع الشكل الثابت للصفحة المطبوعة.
إن التنويعات المختلفة لنقد نظرية التلقي تتوزع بين تلك التي تزعم أن استجابات القراء في جزء كبير منها حصيلة أعراف نصية ( ج. كولر)، إذ النص هو الذي يقدم المعنى، ويراقب و يضبط كيفية استجابات القراء، وبين تلك التي تلح على الاختلافات بين القراءات والمجموعات التأويلية. وهكذا فإن نشاط القارئ يفهم تارة كنشاط أداتي إذا نظرنا إليه من زاوية فهم النص الأدبي، باعتباره الغاية القصوى للاهتمام النقدي، وتارة كمعادل للنص - حيث يقوم المؤول بتشكيل النص حقا أثناء عملية القراءة ( س. فيش 1980). إن العلاقة بين الموضوع النصي والنشاط التأويلي تصبح علاقة معكوسة في هذه الحالة: فالنص، باعتباره كيانا مستقلا عن عملية التأويل، يصبح نتيجة للنشاط التأويلي الذي لم يعد نتيجة حاصلة عن القراءة ، بل عملية إغناء للنص باعتبارها أداة للقراءة.
مهما كانت التحفظات التي يمكن أن نعبر عنها تجاه الذاتية والنسبية التي أعلن نقد نظرية التلقي، يجب مع ذلك أن نعترف له بنموذج التواصل الأدبي الذي يقترحه ( والذي يفترض إضافة إلى ذلك إمكانية الوصول إلى مقصدية منتسبة للقارئ، انظر س. مايو 1982). هناك حيث يجعل النقد الجديد من العمل الأدبي معادلا لحرفية النص، ويقوم بهدم الإحالة على القارئ، فإن نقد نظرية التلقي وهو يقوم بحل مفهوم العمل الأدبي داخل الإحالة على القارئ، لا زال يحمل قيمة تصور هذا العمل كبنية سؤال وجواب.
هذا وإنه لا تاريخ الأدب ولا تحليل الأعمال الأدبية يمكن اختزالهما في تاريخ للتلقي أو تاريخ للقراءات. إن التلقي يستلزم وجود عمل أدبي، أي وجود بنية تركيبية دلالية على الأقل قابلة "للتلقي"، ومن ثمة فإن تحليل العمل الأدبي لا يمكن اختزاله في تحليل عمليات التلقي : إن تاريخ القراءات ليس هو تاريخ إبداع النصوص، ولكنه تاريخ امتلاك هذه النصوص من طرف القراء.
المجالات المعرفية التأويلية
أغلب المجالات المعرفية التأويلية التي تمارس اليوم تندرج ضمن إطار معاد للمقصدية. هذه اللامقصدية لها جذور متعددة، ولكن أصلها الأحدث عهدا هو بنيوية الستينات.
يمكن أن نميز بين أشكال مختلفة من اللامقصدية.
أ) الشكل الأقل تطرفا يتمثل في اختزال مقصدية "السطح" في تمثلات لاواعية خفية تعرف بأنها ليست في متناول المرسل رغم أنها مقصودة بالمعنى الهوسرلي للكلمة ( أي بمعنى أنها هي نفسها كيانات سيميائية). وهكذا فإن الدوال التي تشتغل على مستوى مقصدية السطح تحيل في الواقع ليس على ملازماته الفترضة ( أي على دلالته المعلنة القريبة من الفهم)، ولكن على بنية مقصدية ثانية، غير واعية هذه المرة ، أي أنها تشتغل دون وعي من مقصدية السطح ، ولا يمكن الوصول إليها إلا بواسطة أدوات تحليل خاصة. إن التأويل التحليل- نفسي، إضافة إلى أنواع مختلفة من التأويل الإيديولوجي ( خاصة كل تلك التي ترجع بنيات الخطاب إلى إرادة السلطة أو إلى استراتيجيات طبقية ) تنتمي لهذا التوجه ( انظر ف. جيمرسون، مرجع مذكور).
ب ) إن النزعة الاختزالية يمكن أن تذهب إلى أبعد من ذلك، حيث يمكن أن نسعى إلى اختزال المقصدية باعتبارها كذلك إلى مجرد "تعبير" عن العوامل السببية غير المقصودة: إن كل مذهب تأويلي ينطلق من "نظرية للانعكاس"، يفترض مثل هذا الاختزال، خاصة وأن النقاد الذين يتبنونه يراوحون عامة بين اختزال سببي واختزال في مقصدية "غير واعية"، رغم أن الاختزالين مختلفان جدا: فأن تكون "في خدمة" هاته الطبقة أو تلك ( وهي علاقة مقصدية "غير واعية") ليس هو أن تكون "نتاجا" لهذه الحالة الاجتماعية أو تلك ( علاقة سببية ). إن التأويلات الماركسية تنتج عن تركيبات موفقة بهذا القدر أو ذاك لهذين الاختزالين.
ج ) في الأخير، الشكل الثالث للامقصدية يتمثل في إنكار وجاهة مفهوم المقصدية. وقد تمت صياغة هذا الإنكار خاصة من طرف ديريدا في نقده لنظرية أفعال الكلام عند ج. ل. أوستن. لقد رفض السلطة الغائية لحقل كلي يمثل القصد نواته المنظمة، ورفع في وجهها ما سماه عملية التشتيت. وهكذا فإن تبادل العلامات "ليس وسيلة نقل للمعنى، أو تبادلا للنوايا والمقاصد" : "فالكتابة تْقرأ ، ولا تشكل في النهاية مجالا للتفكيك الهرمينوطيقي، فكا لشفرة المعنى أو الحقيقة" (ديريدا، 1972، ص 392). الشيء الوحيد المتحقق فعلا هو التداول المستمر للعلامات، التحفيز المتجدد لعملية التأويل، والتأجيل الدائم للمعنى. وبعبارة أخرى، فإن النزعة اللامقصدية تأتي هنا ملازمة للاعتقاد بأن للمعنى طابعا مبهما. هاتان الأطروحتان مستقلتان منطقيا. وهكذا فإن الاختزال السببي للمقصدية يحافظ على فرضية وجود دلالة محددة. أما نظرية ديريدا فقد تم الرجوع إليها بالولايات المتحدة، حيث أدت إلى ظهور مدرسة نقدية ذات تأثير واسع، والتي يعتبر بول دو مان أهم ممثليها، (مجاز القراءة ، 1979، الترجمة الفرنسية 1989). أضف إلى ذلك أن النظرية التفكيكية، بحكم إلحاحها على الطابع اللامحدود للعملية التأويلية، قد وجدت أصداء مساندة لها في بعض نظريات السيميائيات الموسعة المستوحاة من بيرس الذي كان قد ألح على الطابع اللامحدود المحتمل للمسلسل التأويلي، أو أيضا عند أتباع نقد نظرية التلقي. في الأخير، وبحكم نسبيته، فقد تمكن من إغراء بعض أتباع التداولية ( رورتي، 1985).
إن اللامقصدية المتطرفة تنتهي إلى موقف النفي الذاتي: فإذا كانت دلالة النص ليست هي التي يمنحها له كاتبه، فمعنى هذا أن دلالة الملفوظ الذي يؤكد هذه الأطروحة ( أي أطروحة أن دلالة نص ما ليست هي التي يمنحها له الكاتب) ليست بدورها هي التي يمنحها الكاتب لهذا الملفوظ، وإنما هي الدلالة التي يمنحها له أي قارئ مهما كان، ومهما كانت هذه الدلالة. ولتفادي هذا الموقف غير المقبول، فإن كثيرا من مناصري اللامقصدية يحصرون أطروحة اللامقصدية في بعض النصوص، هي النصوص الأدبية، ومن ثمة يسلمون للنص الأدبي بــ"خصوصية أنطولوجية" تميزه عن غيره من الرسائل اللفظية ( هيرش، 1967).
هذا التصور نجده خاصة في النص الشهير لــويمسات و بوردسلي "وهم القصد": حسب الكاتبين، فإن الشعر يختلف عن الرسائل العملية على أساس أن هذه الأخيرة لا تعتبر ناجحة إلا استطعنا أن نحدد قصدها بدقة، أما في النصوص الشعرية فإن القصد لايهم (ويمسات وبوردسلي، 1954). ويدافع م. ريفاتير عن فصل مماثل ، لأن ما يميز عملا إبداعيا (معلمة) عن نص عاد (وثيقة) هو كون العمل الإبداعي يستطيع أن يفرض بنيته على القارئ ( رفاتير، 1979). يحدث أمر مماثل في بعض طرق النظر إلى النصوص الأدبية المشتقة من نظرية افعال الكلام لدى ج. ل. أوستن و ج. ر. سورل، والتي تحاول أن تحدد بعض الأعراف التي لا تنطبق إلا على الخطاب الأدبي ( مع الخلط في نفس الوقت بين النص الأدبي والنص التخييلي، عكس ما يحدث مع سورل). لقد نسب النص الأدبي إلى سياق غير إخباري وشاذ بدرجة عالية مقارنة مع أقسام أفعال الكلام المصنفة، ومن ثمة اعتبر "خطابا دون قوة إنجازية ؛ إن العمل الأدبي خطاب جمله مجردة من القوة الإنجازية التي ترتبط به عادة. إن قوته الإنجازية محاكاتية. إن العمل الأدبي يحاكي ( أو ينقل) إراديا مجموعة من الأفعال الكلامية التي ليس لها وجود آخر خارج النص الأدبي ( ر. أوهمان 1971). إن عدم إيجاد سياق محدد للخطاب الأدبي هو ما يفسر تعدد وعدم تحديد دلالة النص ( الأدبي). لاحظنا غالبا أن محاولات التمييز بين الأدب والخطاب العادي على هذا الأساس (أفعال كلامية حقيقية، ومحاكاة الأفعال الكلامية) قد شكلت طريقة لتكريس التعريفات الجوهرية للأدب ( م. ل. برات 1977، س. فيش 1980).
في الواقع، فإن الهرمينوطيقات اللامقصدية تتجاهل التمييز بين دلالة الأعمال الأدبية، أي بنيتها المقصودة التي وضعها الكاتب، وبين إنتاجها للدلالة ، أي ربط الصلة بين هذه الدلالة وانشغالات واهتمامات ووجهات نظر ... المتلقي ( هيرش ، 1967). وهكذا فإن تنوع المتلقين هو ما يمكن أن يفسر تنوع الإنتاجات الدلالية التي تحققها الأعمال الأدبية، خاصة في استعمالاتها الجمالية. صحيح أن التمييز بين الدلالة وإنتاج الدلالة ليس سهلا رسمه دائما بالتأكيد، ولكنه يشير على الأقل إلى أن الاختيار ليس مطلوبا بين معنى دقيق ومعنى غير دقيق، ولكن بين مستويات مختلفة لبناء هذا المعنى.
2) إن النجاح الحالي الذي حققته الاستراتيجيات التأويلية المبنية على هرمينوطيقا غير مقصدية لا يمكنه أن يحجب عنا كون المقصدية هي نقطة ضعف الدراسات الأدبية. إن كل دراسة أدبية تمر بالضرورة بممارسة تأويلية، ما دامت أدواتها تتمثل في مجموعة من الخطابات: ينطبق هذا على الدراسة التاريخية والاجتماعية كما ينطبق على التحليل الشكلي. وعلى هذا الأساس فإن التحليل الهرمنوطيقي هو أساس كل دراسة أدبية مهما كانت ( مولينو 1985). أضف إلى ذلك أنه يجب أن نميز بين الفهم والتأويل ( هيرش 1967)، وفيما يتعلق بالتأويل، يجب أن نميز بين "تأويل السطح" و "تأويل العمق" (دانتو 1993). إن الفهم هو الفعل الابتدائي، وهو على العموم فعل صامت، ينصب على إعادة بناء الدلالة المقصودة للنص: فدون نشاط للفهم ، لا وجود لعلاقة سيميائية. إن الدلالة المقصودة للنص ليست طبعا هي الدلالة التي رغب الكاتب أن يمنحها له، ولكنها الدلالة التي منحها له بالفعل: يتعلق الأمر بالقصد الفعلي كما فرضته القواعد اللسانية والتداولية وليس القصد القبلي الذي يمكن أن تكون علاقته بالمقصدية المتجسدة في النص في غاية التنوع. إن تأويل السطح هو تفسير لهذه الدلالة بواسطة إعادة صياغة للنص. أما تأويل العمق فهو دائما تأويل ثان يشكل أساسا لتحديد الدلالة القصدية التي تمت إعادة بنائها عن طريق نشاط الفهم وتم إبرازها من خلال تأويل السطح: ينطبق هذا أيضا على الاستراتيجيات التأويلية اللامقصدية التي تفترض على المستوى العملي دائما فهما "مشتركا" للنص. هذا يستلزم خاصة أن مصداقية تأويل نصي، مهما كانت ، يجب قياسها على ضوء قدرتها على أن تشكل أساسا لميكانيزمات الفهم المشترك كما تدرسها اللسانيات، السوسيولسانيات، الخ.
إن إعادة بناء الدلالة النصية لا يمكن أن يكون نشاطا محايثا خالصا: إن فهم النصوص يستلزم بدوره معارف مستمدة من التاريخ والمجتمع وعلم الشعر. فهذه المجالات وحدها قادرة على رصد خصوصية البنية الدلالية للعمل الأدبي. ضمن هذا التفاعل المستمر بين التحليل النصي المحايث و "معرفة خلفية التص" يوجد أكثر المظاهر مركزية في ما يسمى عادة بالدائرة الهرمنوطيقية: إن فهم النصوص أمر مستحيل دون التسلح بمعرفة بالخلفية ذات الطبيعة التاريخية والتكوينية، بينما المعرفة التي نتوفر عليها بصدد هذه الخلفية وبصدد الإكراهات التكوينية هي نفسها مستمدة من نصوص ( ستيغمولر 1972). منذ ديلتي نلاحظ غالبا ضمن دائرة الهرمنوطيقا ( التي لا يشكل مفترق الطرق المذكور أعلاه إلا واحدا من مظاهرها) السمة المميزة لمجال الإنسانيات مقارنة مع ميدان العلوم الطبيعية: يتعلق الأمر بالتمييز الذي يصاغ كتعارض بين الفهم و التفسير. ومع ذلك يجب أن نذكر أن الهرمنوطيقا الكلاسيكية خلال القرن التاسع عشر اعتبرت أنه يجب تجنب دائرة الهرمنوطيقا من أجل ضمان مصداقية النتائج المتعلقة بإعادة بناء الدلالة النصية. وهكذا فإن الفقيه اللغوي أ. بوك، ومع اعترافه بضرورة الذهاب والإياب المستمرين بين التحليل المحايث للنص وبين الخلفية المعرفية، يؤكد على إمكانية تفادي الدائرة، خاصة وأن أي عنصر تم استخلاصه من العمل الأدبي من أجل بلورة إحدى خلفياته لا يمكن إعادة تطبيقه على نفس النص من أجل تحديد عناصر أخرى ( نفس القاعدة تشتغل في الاتجاه المعاكس حين نستخدم عنصرا من عناصر الخلفية تم بناؤه من قبل بهدف تحديد عنصر مجهول من عناصر العمل الأدبي ) - مع العلم أن هذا العنصر يمكن بالطبع استخدامه كأداة لتحليل عمل أدبي آخر، فهذا التحليل المعتمد على التصنيف يشكل بالإضافة إلى ذلك الوسيلة الوحيدة لإثبات الصواب المحتمل لهذا العنصر. ومع ذلك يعترف بوك أيضا بوجود مواقف لا يمكننا فيها أن نتجنب أي شكل من أشكال الدائرية: لقد كان يرى في هذا أحد الحدود المقننة للنشاط الهرمنوطيقي.
هناك حد آخر أكثر أهمية: إن كل إعادة بناء لدلالة النص لا يمكن أن يكون لها سوى طابع الاحتمال، على اعتبار أننا لا نتوفر أبدا على منفذ مباشر نحو الحالات المقصدية التي تعبر عنها السلسلة الدالة (هوسرل 1901، هيرش 1967). هذه الخاصية ليست سمة مقتصرة على النصوص الأدبية، ولا هي حتى خاصية مميزة للنصوص المثبتة بواسطة الكتابة (وبالتالي فإنها تتجاوز سياقها الأصلي): إنها خاصية عامة مطلقا وتنطبق حتى على المخاطبات اللفظية اليومية الخالصة . ويرجع ذلك إلى كون مقصدية الملفوظات اللسانية "مقصدية مشتقة" ( سورل 1985): إن الدلالة ليست أبدا "معطاة" في الملفوظ ، ولكن يجب إعادة بنائها من طرف المتلقي انطلاقا من الإشارات الملموسة التي تمثلها السلسلة اللفظية.
هذه الاعتبارات تفترض أنه لا وجود لـ "دلالة أدبية" يمكن أن تختلف عن تشكل الدلالات "العادية". إن دراسة دلالة النصوص الأدبية تخضع بالضرورة لنفس المبادئ التي توجه تحليل الدلالة اللفظية باعتبارها كذلك، رغم أن الخصوصية التداولية أو الشكلية لأغلب النصوص الأدبية (النصوص التخييلية من جهة، والنصوص الشعرية من جهة أخرى) تقتضي مرونة خاصة في هذا التحليل.
-Jean-Marie Schaeffer, Philippe Roussin, Nouveau dictionnaire encyclopédique des sciences du langage.
Éditions du Seuil, 1995)
ملحق بأسماء الأعلام وبعض المصطلحات
كلوبش Klopsch
هوغ Haug
أبرامس: M.H. Abrams
شليير ماخر: Schleiermacher
أوغست بويخ: August Boeckh
هـ . ج . غادامير Hans-Georg Gadamer
ف. شليجل : Friedrich Schlegel
ج . باريس G. Paris
ب. سيركيغليني : B. Serquiglini
م. ويرنير: M. Werner
م. إيسبانيا : M. Espagne
ل . لوفيفر Louis Lefebvre
لانسون : Lanson
مورني : Mornet
فيالا: Viala
شارلز: Charles
بورديو: Bourdieu
شارتييه: Chartier
لوغ : Laugh
مارتان: Martin
ك. غيرتز : Clifford Geertz
س. غرينبلات: Stephen Greenblatt
هـ . أ. غومبرخت : Hans Ulrich Gumbrecht
ت. ج. ريس: Timothy J. Reiss
موازان : Moisan
فاين: Veyn
فايان : Vaillant
بروني : Brunet
كومبانيون : Compagnon
جورج لوكاتش: George Lukacs
ف. جيمسون : F. Jameson
ر. كوزيليك : Reinhart Koselleck
هـ. أ. كومبرخت : Hans Ulrich Gumbrecht
م. بوردسلي: Monroe Beardsley
هـ. بيلتنغ Hans Belting
أ. ليو A. Liu
هـ . ر. جوس Hans Robert Jauss
و. إيزر Wolfgang Iser
ك. ستيرل Karlheinz Stierle
ر. وورنينغ Reiner Warning
م. ريفاتير Michel Riffaterre
أ. ريشارد Ivor Armstrong Richards
ويمسات Wimsatt
بوردسلاي Beardsley
ن. ن. هولاند Norman Norwood Holland
د. بليش David Bleich
س. فيش Stanley Fish
ج. كولر Jonathan Culler
س. فيش: Stanley Fish
س. مايو: S. Mailloux
ج. ل. أوستن John Langshaw Austin
بيرس Peirce
رورتي Rorty
هيرش Hirsch
ويمسات Wimsatt
بوردسلي Beardsley
ج . سورل John Searle
ر. أوهمان Ohmann
م. ل. برات Mary Louise Pratt
س. فيش Stanley Fish
مولينو Molino
هيرش Hirsch
دانتو Danto
ستيغمولر Stegmüler
ديلتي Dilthey
أ. بوك A. Boeckh
هوسرل Husserl
***
الغائية الذاتية autotéléologie
الحكاية المجازية : allégorie
التاريخانية الجديدة: New Historicism
النقد التطبيقي، دراسة في تقييم الأدب Practical Criticism: a Study of literture Judgement
الأدب كاستكشاف Literture as Exploration
النقد الجديد New Criticism
التشتيت: dissémination
مجازية القراءة allégorie de la lecture
السيميائيات الموسعة pansémiotique