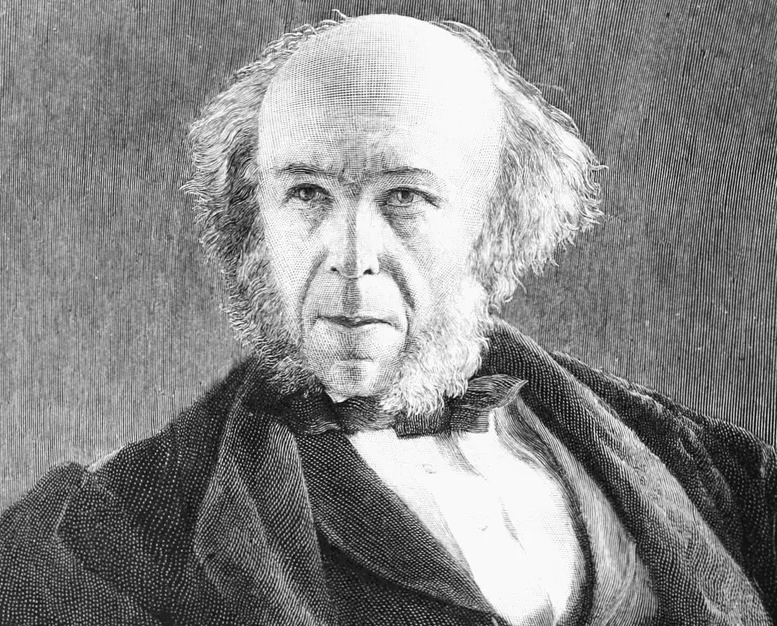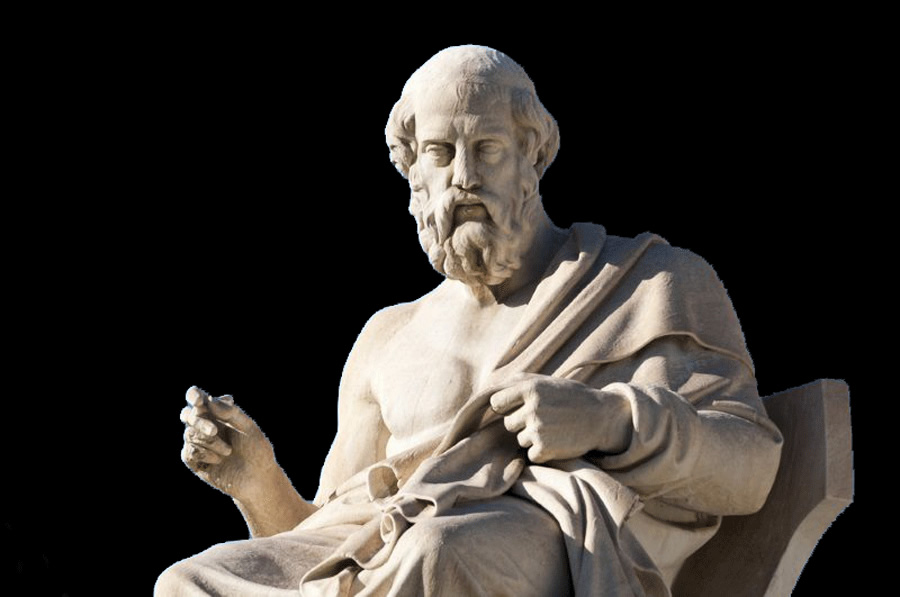" صمت قبل الولادة وصمت بعد الموت، والحياة مجرد صخب بين صمتين لا قرار لهما".. الروائية التشيلية إيزابيل الليندي.
"نحن نعيش في زمان شديد الغرابة، أصبحنا نلاحظ فيه وباستغراب أن التقدم قد عقد تحالفا أبديا مع النزعة الهمجية البربرية"[1]. سيغموند فرويد .
1- مقدمة تمهيدية :
في أصل العدوانية يكمن فيض أسرار لا يتناهى تنوعه ولا ينقطع تدفقه. وفي البحث عن خفايا هذه القضية وأسرارها يشدّ علماء النفس الرحال ويعقد علماء الاجتماع العزم. فالعدوانية حقيقة بيولوجية - نفسية -اجتماعية (بيوسيكوسوسيولوجية) تضرب جذورها في أعماق الكائنات الإنسانية وفي صلب فطرتها على امتداد تنوعها واختلاف صورها وتجلياتها، وهي حقيقية مبهمة تشتد غموضا كلما اشتد الطلب في الكشف عن ماهيتها واستجلاء خفاياها.
شكلت هذه القضية -منذ بداية التاريخ الإنساني- هاجسا يقض مضاجع المفكرين والفلاسفة، وما زال العقل الإنساني حتى اليوم يكدّ ويجد في البحث عن ماهية العدوانية، وفي الكشف عن أسرارها وخفاياها وضروب تجلياتها في أعماق الإنسان. ويضج تاريخ الفكر اليوم بعظيم المحاولات الفكرية التي تسعى دون انقطاع إلى استجلاء هذه الحقيقية التي ما زالت في دوائر المتاهات الغامضة. ويأتي هذا السعي الإنساني المستمر تكثيفا لإرادة إنسانية تريد أن تهتك حجب الحقيقية دون أن تقف عند حدود التفسيرات الأحادية الجانب التي تنأى عن القصد وتَقْصُر عن اللحاق بالغاية المعرفية لخفايا هذه الظاهرة بأبعادها الكونية وأسرارها الخفية. وفي نسق هذا القصد فإن الكشف عن ماهية هذه الظاهرة وجوهرها أمر يتجاوز حدود القناطر والتخوم العلمية المعروفة. فالعنف ليس حقيقة سوسيولوجية أو نفسية أو بيولوجية فحسب بل هو حقيقة تتكون من هذه الأبعاد وتتجاوزها في الآن الواحد.
فالعدوانية تأخذ بأبعادها المختلفة صورة مشّفرة لتكوينات نفسية واجتماعية بالغة التنوع، وبالتالي فإن هذه الصورة بما تنطوي عليه من رموز خفية تتحدى الجهود العلمية وتشكل حتى اليوم رهانا علميا يشد العقل الإنساني ويشتدّ في طلبه. ويضاف إلى هذا كله طابع التغير الدائم في طبيعة الأشياء الذي يجعل من اللحاق بالحقيقة الغامضة لهذه الظاهرة أمرا في غاية الصعوبة والتعقيد. وإذا كانت الحقيقة المطلقة أمر يتنافى مع الروح العلمية يبقى على العارفين أن يقلصوا المسافة بين الأوهام والحقيقة إلى ابعد حدّ ممكن، وأن يعملوا على تحطيم أسرار الأشياء وخفايا الظواهر بصورة مستمرة وبطرق مختلفة وبأساليب منهجية متنوعة. وانطلاقا من هذه الروح العلمية يأتي البحث الدائم عن حقيقة العنف وماهية العدوان وذلك لما لهذه الظاهرة من أهمية كونية في عالم الإنسان القديم والمعاصر.