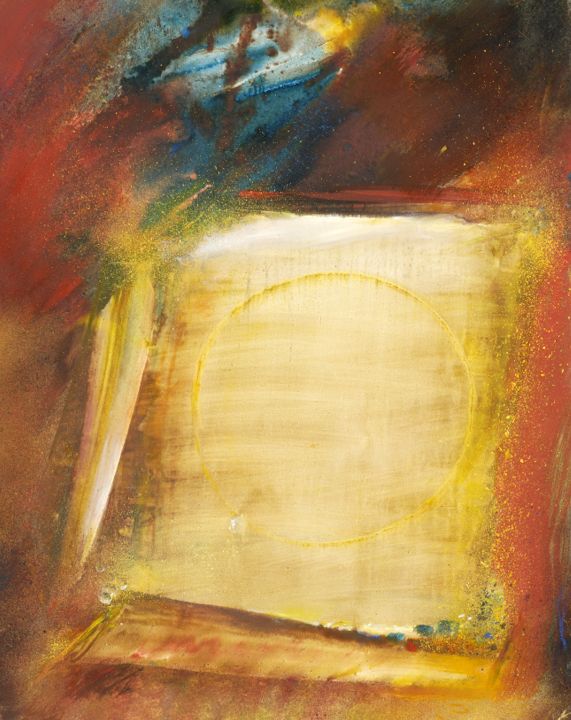 "لست ضد آلهة الجمهور، بل ضد فكرة الجمهور عن الآلهة" سقراط
"لست ضد آلهة الجمهور، بل ضد فكرة الجمهور عن الآلهة" سقراط
في أسلوب مغلق بدايته القصاص ونهايته جهنم، لم يكن مصطفى صادق الرافعي، وهو يحاكم "في الأدب الجاهلي"، يقرأ كتاباً وينقد شخصاً محدّد الاسم واللقب، بل كان يستولد من لغة معطاة عدواً يلبّيه، وينزل به العقاب الذي يشتهي ويرغب. كان الرافعي، وكما في أزمنة لاحقة، يواجه التفكير بالتكفير، مساوياً بين التكفير والدفاع الغيور عن الدين. ما كان في المعركة، التي أشعلها كتاب، مكان، صغير أو كبير، للدين، لأنها كانت بين مَنْ ينصر الثبات ومَن يقول بالتطور، أو كانت، وبلغة طه حسين، معركة بين أنصار القديم وأنصار الجديد.1
كانت المعركة بين مثقف جديد، يدعو إلى تفكير غير مألوف، وعارف قديم يستظهر، مطمئناً، لغة جاهزة أكثر قدماً. ولأن للقديم شرعيته الراسخة، ونسقاً متوالداً له شكل البداهة، بدأ المثقف الجديد معلّقاً في الفراغ، ينتظر زمناً يأتي ولا يأتي، مقترباً من حلم أرخميدس القديم، الذي يعد بتحريك الأرض، لو عثر على نقطة ارتكاز في الفضاء.
الشيخ المثقف: اختلاف المنطلق
يكتب طه حسين في الأيام: "وكان حذاء الشيخ غليظاً كصوته جافياً كثيابه، فلم يكن يتخذ العباءة، وإنما كان يتخذ "الدفية"، كان حذاء الشيخ غليظاً جافياً، وكانت نعله قد ملئت بالمسامير، وكان ذلك أمتن للحذاء وأمنع له من البلى. ففكر في الطالب الذي كانت تصيبه مسامير هذا الحذاء في وجهه أو فيما يبدو من جسمه".2 لو وضع النص كلمة الشيخ جانباً، لانتهى إلى وصف إنسان بائس، يحاصره الفقر وتستبد به الفاقة، ولكشف عن فقر هذا الإنسان الشامل، الذي يتخذ من الحذاء الغليظ أداة للتربية ووسيلة مروّعة للتأديب. وهذا الفقر المادي والمعنوي الشامل، هو الذي جعل طه حسين يرى في الشيخ، الذي تتلمذ على يديه واختبر قوله، مجازاً للتأخر الاجتماعي. لم يكتب حسين كلماته المتمردة، وكان قد رجع من فرنسا، إلا بعد أن التقى بمعلم مختلف، لا يرى في الحذاء وسيلة للتربية والتعليم.
مخطوط: " تقييد في الحسبة " لأبي زيد عبد الرحمان الفاسي ـ دراسة وتحقيق الدكتور محمد عمراني زريفي

كان وجود المحتسب ضروريا لحماية المجتمع من الباعة والصناع بحيث لا يغش هؤلاء في صناعة أو وزن أو قياس من المحتكرين والصيارفة والسماسرة، وهو ما جعل مهمته صعبة وتثير لعاب بعض المتطفلين.
كان دور المحتسب الإشراف على الآداب العامة ومراقبة أهل الحرف والصنائع، وباعة السلع المختلفة، ومراقبة الأطباء والكحالين والصيادلة والبياطرة وغيرهم(1)، كما كان يراقب على أهل السوق «صِنجَاتهم وموازينهم ومكاييلهم كلها: فمن وجده قد غير من ذلك شيئاً عاقبه على قدر ما يرى من بدعته ... ثم يخرجه من السوق حتى تظهر منه التوبة والإنابة إلى الخير»(2)، ومن ثمة استوجبت في المحتسب شروط وصفات يجب أن يتحلى بها حتى لا يتبوأ هذا المنصب إلا ذوو الهمة والنزاهة.
ليست وظيفة الحسبة أمرا مطلقا يفعله كل من شاء، بل إن لها شروطا لا بد من تحققها، وصفات يتحتم توافرها. وقد أجمل السقطي صفات المحتسب حين قال: « يجب أن يكون ولي النظر في الحسبة فقيها في الدين قائما على الحق نزيه النفس عالي الهمة معلوم العدالة ذا أناة وحلم، وتيقظ وفهم، عارفا بجزئيات الأمور، وسياسات الجمهور، لا يستنفره طبع ولا تحلقه (كذا)(3) هوادة ولا تأخذه في الله لومة لائم، مع مهابة تمنع من الإدلال عليه وترهب الجاني لديه»(4).
محمد أركون وقراءة النص الديني ـ أحمد فري
 يستعصي على الفهم ما آلت إليه المجتمعات العربية الإسلامية المعاصرة، من تخلف وجمود فكريين يهيمنان على مختلف جوانب الواقع العربي الإسلامي. وكم هو عجيب حال هذه المجتمعات في إحساسها بحقيقة ما هي عليه إثر اتصالها بالثقافة الغربية في صيغتها الحداثية، بعد ما كانت تغط في نوم عميق، غافلة لا تدرك هول المشاكل المحدقة بها من كل جانب. وبعد اجتياح الثقافة الأوروبية لها لحقها نوع من التشظي والانشطار في ما يتعلق بواقعها؛ الذي أصبح واقعاً يتنافس عليه، ويصطدم فيه ويتصارع، صنفين من المعطيات: أولا: صنف موروث من الماضي، وتثنية: صنف وافد من حضارة غيرنا، فُرِض بقوة، و ينتمي بكليته إلى الحضارة الغربية الحديثة. أمام هذه الشروخ التي نجمت عن صدمة فكرية قوية، كان حري أن تُتخد مواقف فكرية تجاه ما هو حاصل، فظهرت مشاريع فكرية لمفكرين مسلمين تروم التغيير، وتجاوز المألوف وما هو معمول به، هذا المألوف يشكل التراث-الذي يشكل النص الديني جوهره ومرجعيته ودعامته الأساسية. والحال أن تغيير الواقع، يقتضي-أول ما يقتضي-قراءة ما يشكل هذا الواقع من تراث ونص ديني، فكان هذا هو منطلق هذه المشاريع الفكرية الموسومة بالتحديثية. ولعل أبرز المشاريع الفكرية التي نمت على ضرورة التحديث، من خلال قراءتها للثراث وللنص الديني، نلفي مشروع محمد أركون.
يستعصي على الفهم ما آلت إليه المجتمعات العربية الإسلامية المعاصرة، من تخلف وجمود فكريين يهيمنان على مختلف جوانب الواقع العربي الإسلامي. وكم هو عجيب حال هذه المجتمعات في إحساسها بحقيقة ما هي عليه إثر اتصالها بالثقافة الغربية في صيغتها الحداثية، بعد ما كانت تغط في نوم عميق، غافلة لا تدرك هول المشاكل المحدقة بها من كل جانب. وبعد اجتياح الثقافة الأوروبية لها لحقها نوع من التشظي والانشطار في ما يتعلق بواقعها؛ الذي أصبح واقعاً يتنافس عليه، ويصطدم فيه ويتصارع، صنفين من المعطيات: أولا: صنف موروث من الماضي، وتثنية: صنف وافد من حضارة غيرنا، فُرِض بقوة، و ينتمي بكليته إلى الحضارة الغربية الحديثة. أمام هذه الشروخ التي نجمت عن صدمة فكرية قوية، كان حري أن تُتخد مواقف فكرية تجاه ما هو حاصل، فظهرت مشاريع فكرية لمفكرين مسلمين تروم التغيير، وتجاوز المألوف وما هو معمول به، هذا المألوف يشكل التراث-الذي يشكل النص الديني جوهره ومرجعيته ودعامته الأساسية. والحال أن تغيير الواقع، يقتضي-أول ما يقتضي-قراءة ما يشكل هذا الواقع من تراث ونص ديني، فكان هذا هو منطلق هذه المشاريع الفكرية الموسومة بالتحديثية. ولعل أبرز المشاريع الفكرية التي نمت على ضرورة التحديث، من خلال قراءتها للثراث وللنص الديني، نلفي مشروع محمد أركون.
يعتقد محمد أركون أن التراث الإسلامي-منذ انبثاقه في لحظاته التأسيسية الأولى-لم يعالج ضمن إطار التحليل والفهم النقدي ، والذي من شأنه أن يزيح اللثام عن المنشأ التاريخي للوعي الإسلامي وتشكل بينيته. والحال أن كل ما أنتج في فترة ما يسميه أركون بالعصر التدشيني قد انصب كله على النص الديني، ففي “هذه الفترة ظهرت علوم الفقه وعلوم الشريعة...الخ، ودخلت الفلسفة إلى البيئة الإسلامية، وحاول جل الفلاسفة الجمع ما بين العقل الديني والعقل الفلسفي عبر تأويل النص الديني” (1).
ويقدم الخطاب القرآني نفسه-في نظر محمد أركون- “كحداثة تغيير كل شيء قياسا إلى العقائد والعادات التي سادت قبله، حيث رُمي التراث العربي السابق في دائرة الجهل والفوضى والظلام، ليقدم في مقابله التراث الإسلامي استنادا إلى النص الديني الذي بلور ملامحه”(2). أمام هذه الوضعية الجديدة-أو لنقل أمام هذا التراث الجديد-هل ينبغي دراسة التراث استنادا إلى التحديد الأصولي الدوغمائي الذي يضفي على التراث نوعا من التعالي والتقديس؟ أم أنه يجب علينا إعادة التفكير في التراث بصفة علمية وبالتالي اعتباره صيرورة إجتماعية وتاريخية؟
نظرية النظم عند القاضي عبد الجبارـ حكيم بوحرمة وعمر اكداش
 1. إعجاز القرآن عند القاضي عبد الجبار:
1. إعجاز القرآن عند القاضي عبد الجبار:
أفرد القاضي عبد الجبار من كتابه "المغني في أبواب التوحيد والعدل" الجزءَ السادس عشر لإعجاز القرآن. وهو في هذا الكتاب لا يتعرض للإعجاز مباشرة، بل يقدم له بمباحث كثيرةٍ نالت الحظ الأوفر من هذا الكتاب. وذلك لأن الطابع الكلامي كان هو المهيمنَ على منهجه في معالجته لقضية الإعجاز. أما الجانب البلاغي، فلم يحظ منه إلا بفصلين قصيرين، أورد في أولهما رأي أستاذه أبي هاشم الجبائي، وذكر في الفصل الذي يليه رأيه الخاص، موضحا رأي أستاذه ومستدركا عليه. وقبل أن نعرض لهذين الفصلين، لا بد أن نوجز القول في رأيه في إعجاز القرآن بصفة عامة.
بعد أن تم التشكيك في نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم، رأى القاضي عبد الجبار –شأنه شأن سائر شيوخ المعتزلة- ضرورة الوقوف على صحة النبوة أولا، والنظر في أدلتها ومعجزاتها، وتحقيق ما فيها من البرهان على صدق الرسول في دعواه. ولذلك فصل بين المعجزات التي ترتبط بالمشاهدة والمعاينة والحضور، وبين القرآن الكريم. فجعل القرآن وحده دليلا أصليا على صدق النبوة، وما عداه من المعجزات المادية والحسية فرعا على ثبوتها ومؤكدة لها. فالمعجزات المادية والحسية لا تعتمد في إثبات النبوة إلا لمن شاهدها[1]، وهم الذين عاصروا التنزيل. فهي وإن ثبتت بطريق اليقين، فلا يصح الاعتماد عليها لمناظرة المخالفين. لذلك اعتمد المعتزلة في إثبات النبوة على القرآن الكريم، وهو المعجزةُ الباقيةُ، باعتبارهم لم يشاهدوا باقي المعجزات[2].
أزقة مدينة فاس وجوانب من حياتها الاجتماعية من خلال ثلاث قصائد الملحون دمليج زهيرو، قصة حمان، والفرانة ـ عبير عمراني زريفي
 تقديم:
تقديم:
لا يمكن إدخال الثقافة الشعبية والتراث الشفاهي في إطار ثقافة الأسطورة أو الخرافة، خاصة وأن هذه الثقافة والتراث أضحيا مرتعا خصبا لكثير من العلوم الإنسانية مثل التاريخ وعلم الاجتماع والأنتربولوجيا والإكيولوجيا(1).
انصبت الكتابات التاريخية الحديثة على ما هو شائع ومشهور في مجال التاريخ المغربي معتمدة على مصادر ووثائق النفوذ المهيمنة. ولعل الاهتمام بالتراث الشفاهي ساهم في تغطية سلبيات ونقائص وثائق المعرفة التاريخية أو قدم وجهة نظر مغايرة. بل يمنح الدارس رؤية تأويلية وتفسيرية معاكسة لمصادر التاريخ المدون وتقدم الوجه الآخر المضمر في مشاهد الماضي(2).
يعد الاعتماد على المأثورات الشفوية نبشا في نمط الحياة الشعبية من الاقتصاد والفنون، بل إنها نبش في العلاقة التي يقيمها الفرد والمجتمع وكل ما يحيط بهما.
يمكن إرجاع النصوص الشفاهية عند معاينتها وتفكيك رموزها إلى الوعي الجماعي المغربي، وهو بمثابة سجل حقيقي وواقعي لحياة الجماعات والقبائل المغربية.
عند قراءة التاريخ المغربي نجد مصادره قد تناولت ملامح البنى الاقتصادية والاجتماعية والأحداث السياسية والوطنية، ويستشف منها الظروف المعيشية التي عانتها قوى اجتماعية ضعيفة، والتفاوت الاجتماعي(3).
تحدث عبد الوهاب الفيلالي في مقاله "الملحون في المغرب قيمته الفنية وبعض آفاق اشتغاله":« الملحون تراث، والتراث أبو الحداثة، ولا تبنى الحداثة إلا بالحوار المستمر بين حاضر الإنسان وماضيه ومستقبله. وكلما استمر هذا الحوار في الوجود وتمادى في الإنتاج اتضحت نفعية هذا التراث أكثر، وبرزت نجاعة أساليب الحوار المعتمدة معه... إن القضية، إذن قضية هوية وكيان، خاصة عندما يتعلق الأمر بتراث أصيل ومتجدر مثل فن الملحون»(4).
إذ يعتبر الملحون ديوان وهوية المغاربة خاصة وأنه يجمع بين الفن والجمال وبين الثقافة والحضارة. وجاء في كتاب "المصادر العربية لتاريخ المغرب" لمحمد المنوني:« فإذاكانت التاريخية الموضوعية، إنما تهتم باتجاه محدد فإن المصادر الأخرى تفتح ـ أمام الباحثين ـ آفاقا قد تكون فسيحة في الكشف عن ألوان في التاريخ الحضاري، وأحيانا عن حياة الشعوب»(5)، ومن بين هذه المصادر التي تحدث عنها المنوني في كتابه شعر الملحون الذي اختزنته ذاكرة الحفاظ في العديد من قصائده.
مخطوط: " تقييد في الحسبة " لمحمد بن أحمد بن محمد الفاسي الفقيــه المالكي الشهير بميارة ـ دراسة وتحقيق الدكتور محمد عمراني زريفي
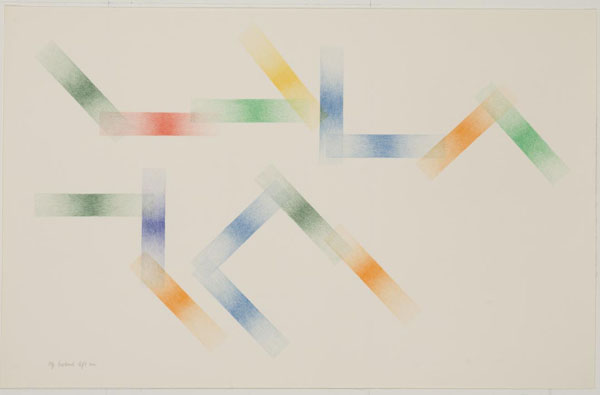 تقديم:
تقديم:
كانت الحسبة من الوظائف الإسلامية التي عرفتها مدن المغرب، والتي اهتمت بتنظيم السوق، والحرص على السير العادي فيه، ومراقبة الموازين والمكاييل والمقاييس، وإيقاف البيوع الفاسدة، والضرب على يد الغشاشين، إلى غير ذلك من المهام الأخرى.
يعرِّف العلماء الحسبة بأنها أمر بالمعروف إذا ظهر تركه، ونهي عن المنكر إذا ظهر فعله(1)، ويمثل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بذلك نظاما رقابيا يتكامل مع النظام الاجتماعي والسياسي في المجتمع الإسلامي المثالي.
وجعل ابن عبدون نظام الحسبة من الوظائف الدينية التي عرفتها الأمة الإسلامية(2)، استنادا لقوله تعالى: (وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ)(3). غير أننا يجب أن نتعامل مع هذه الوظيفة من المنظور الاجتماعي والاقتصادي، بمعنى الكيفية التي تعاملت بها الدول لحماية المجتمعين المغربي والأندلسي من الغبن والتدليس، والحفاظ على اقتصادها. لذلك كانت وظيفة الحسبة من المهام الأساسية في نظام الدولة، بل ومن الولايات الحساسة في جهازها الإداري.
وتعد وظيفة الحسبة من الوظائف القديمة في المجتمع الإسلامي، بل إن بعض المصادر تشير إلى أن العرب قد عرفوا هذه الوظيفة في الجاهلية، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يأمر الباعة في السوق بتوخي الأمانة وعدم الغش(4)، فقد روي عن أبي هريرة « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام. قال: أصابته السماء يا رسول الله. قال: أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس، من غش فليس مني»(5)، في حين أشار أحد الباحثين إلى أن أول من وضع نظام الحسبة في البلاد الإسلامية هو الخليفة عمر بن الخطاب، الذي كان يقوم بدور المحتسب(6).
لمحات عن رحلة ابن بطوطة ـ عمر اكداش
 ● مميزات رحلة ابن بطوطة:
● مميزات رحلة ابن بطوطة:
ليس من المُسْتبعد أن يكون رحّالة آخرون قبل ابن بطوطة زاروا نفس المناطق التي زارها، وقد تحدث بنفسه عن لِقائِه مغربيًّا بالصّين. لكن ميزتَه أنه دَوّن رحْلتَه فيما تغافل الآخرون عن تدوينها، فاكتفوا مقابل ذلك بسردها شفويا، حتى انتهت بوفاتهم ووَفاة مَن سمعوا منهم. وتتجلى مظاهرُ تفوقه على أصحابِ الرّحلات المكتوبة في:
* اتساع البقعة الجغرافية للمناطق التي زارها، فتمتد من المحيط الأطلسي غربا إلى الصيـن شرقـا، ومن بلاد التتار شمالا إلى إقليم السودان أواسط إفريقيا جنوبـا. هكذا، يكون قد زار القارات الثلاث المعروفة في وقته، إفريقيا وأوربا وآسيا. ويكون قد اختلط بثقافات عديدة، وتَعرّف على حضاراتٍ عديدة، واطّلع على أحوالها، منها الحضارة الإسلامية في المشرق وفي المغرب معا، والحضارة الصينية، والحضارة الهندية وغيرها.
* طول المدة الزمنية التي قضاها في رحلاته، والتي تقترب من ثلاثين عاما.
* تَدَاخُل العوامل التي دفعته إلى القيام برحلته؛ فقد كان دافعه إلى الخروج بادئ ذي بدء هو "حج بيت الله الحرام"[1]. لكن، منذ أن كاشفه الشيخ المرشدي في رؤياه، حل به شوق إلى زيارة البقاع المقدسة، وزيارة ما غمض من الأراضي البعيدة. فظهرت عوامل جديدة مع تقدمه دفعته إلى الاستمرار في رحلته، منها السفارة والاستكشاف وطلب العِلم... ومع تداخل هذه العوامل، أصبحت رحلته حجية وزيارية وسفارية وعلمية واستكشافية... وتداخلت نصوص عدة في رحلته جعلتها محطة تلتقي فيها علوم عدة، منها التاريخ والجغرافيا والإثنوغرافيا والتراجم...
الإنسان والعالم في الخطاب الصوفي في الغرب الإسلامي . د. محمد رضى بودشار
 تعد إشكالية علاقة الإنسان بالعالم من أبرز القضايا الذي خاض فيها الفكر الصوفي والمدونات الصوفية على اختلاف صنوفها، وعيا منها بذلك، أو عن غير وعي، تصريحا أو تضمينا. ونظرا لغنى هذه المدونات بأشكال العلاقات القائمة بين الإنسان الذات المفكِّرة، والمفكّر فيها، والعالم؛ أي الموضوع المتصل والمنفصل عن هذه الذات، فقد أمكن استخلاص شكلين رئيسين لهذه العلاقة المفترضة بين هذين القطبين؛ الأولى: علاقة المعية والاتصال، والثانية: علاقة التقابل والانفصال، فأين تتجلى ملامح هاتين العلاقتين؟
تعد إشكالية علاقة الإنسان بالعالم من أبرز القضايا الذي خاض فيها الفكر الصوفي والمدونات الصوفية على اختلاف صنوفها، وعيا منها بذلك، أو عن غير وعي، تصريحا أو تضمينا. ونظرا لغنى هذه المدونات بأشكال العلاقات القائمة بين الإنسان الذات المفكِّرة، والمفكّر فيها، والعالم؛ أي الموضوع المتصل والمنفصل عن هذه الذات، فقد أمكن استخلاص شكلين رئيسين لهذه العلاقة المفترضة بين هذين القطبين؛ الأولى: علاقة المعية والاتصال، والثانية: علاقة التقابل والانفصال، فأين تتجلى ملامح هاتين العلاقتين؟
فلا غرو أن التجربة الصوفية، من حيث كونها خطابا فكريا متضمنا في مقالات، أو من حيث كونها ترجمة لتجربة إنسانية، تعبر عنها الكتابة المنقبية، تفصح عن رؤية إلى الإنسان والعالم، عبر رؤية نسقية تجمع بين النظرة القيمية والتصورين المعرفي والوجودي للإنسان، بدرجات متفاوتة. لهذا، فإن قراءة النصوص الصوفية المنقبية لتبيّن تصور الخطاب الصوفي للإنسان والعالم، تظل قراءة تجزيئية قِطاعية، محصورة الآفاق، ومحدودة النتائج، إن لم تكن مصحوبة بقراءة أخرى موازية أو قبلية للمتون الصوفية النظرية. كما أن تبيّن هذا التصور من كتب التصوف بمعزل عن المدونات المنقبية التي تعْرض التصوف باعتباره حقيقة اجتماعية وواقعة ثقافية، فردية أو جماعية، يظل من جانبه يحوم حول أفكار ومفاهيم، وكأنها أنساق منغلقة على نفسها، مكتفية بذاتها.











