 " استعمال تعبير "فلسفة عربية" يمتلك سبق التأكيد على أهمية المرور الى العربية بينما صياغة "فلسفة إسلامية" تسجل انتماء ثقافيا أكثر منه دينيا "[1]
" استعمال تعبير "فلسفة عربية" يمتلك سبق التأكيد على أهمية المرور الى العربية بينما صياغة "فلسفة إسلامية" تسجل انتماء ثقافيا أكثر منه دينيا "[1]
من المعلوم أن القراءات السائدة تقلل من قيمة التناول الفلسفي العربي للقضايا السياسية وتعطي الأولوية للميتافيزيقا والمنطق واللغة والأخلاق وبدرجة أقل المجتمع والتاريخ والاقتصاد ، وتدرج شؤون الحكم ومسألة الحقوق في خانة الأمور المسكوت عنها إلى جانب الدين والجنس وأشياء محرمة ينصح بتركها. لكن هذا الحكم المسبق يمكن مراجعته وإعادة التفكير في حضور المسألة السياسية في الفلسفة العربية وإثارة مواقف حكماء العرب من الإشكاليات المطروحة على الحكام في زمنهم وطرق تعاطيهم معها. لعل استذكار بعض النظريات الفلسفية الماضية والتركيز على جملة من المفاهيم الاجرائية والمقاربات الجدية واستدعاء آراء ومناهج مفكري حضارة اقرأ وعلماء لغة الضاد يخرجهم من سراديب التقاليد وقبو التراث ويلقي بهم في معارك العصر وحركة التاريخ ويصلح ما أفسده الدهر من ناحية أولى، وربما يمثل هذا الاستنجاد دليلا ساطعا على استمرار نفس المزالق العملية والتشويشات النظرية التي ظل الوعي الإسلامي يعاني منها وتعيقه عن تشخيص العلل وفتح طرق الخروج من الأزمات من ناحية ثانية.
الفكر العربي و بناء منهج النفي و الإثبات ـ د. محمد الصفاح
 استقراء لشخصية الفكر العربي يتبين أن حياته الفكرية قد خضعت لحقبتين زمنيتين اثنتين:
استقراء لشخصية الفكر العربي يتبين أن حياته الفكرية قد خضعت لحقبتين زمنيتين اثنتين:
1- حقبة التلقي ،و الإقبال ،و القبول ،و الاستيعاب و التمثل: و خلالها كانت العلاقة بين الفكر و الأنشطة المعرفية، علاقة تقبليه، تميزت بالانفتاح على العلوم و المعارف. فكان بذلك فكرا طوافا، جوالا غازيا، سائحا ،شديد الحماسة للعلم، و تعقبه أنى وجده، يتوخى تحصيل الزاد المعرفي الروحي، الكفيل بصناعة الشخصية المعرفية الفكرية القادرة على صياغة رؤية للعالم، وفق منظور علمي فكري، يمتلك القدرة على بناء المواقف، و تدبير الوضعيات على الوجه المطلوب.
على هذا النهج القويم الرشيد إذن سار الفكر العربي حقبة من الزمن، تحركه الرغبة الأكيدة لامتلاك ناصية العلم من مواطن العلم، و تشده غريزة الوفاء للفكر. و لعلها القيمة الثمينة الكامنة وراء ميلاد و إنجاب الشخصية الفكرية الاعتبارية العابرة بصدق و مصداقية نحو:
2- حقبة التساؤل و النقد و التأصيل و الإبداع: إنه طور أبان فيه الفكر العربي و بحق عن نضجه و قوته وعلو شأوه، إذ برز على مسرح الحياة الفكرية، فكرا رشيدا، راشدا يمتلك ناصية التفكير القوي، بعدما تزود بكفايات و مهارات و آليات مستقاة من علوم شتى اطلع عليها و خبر فلسفتها و مضامينها لاسيما الفلسفة و المنطق. فتجلت بذلك حركته الفكرية القائمة على أساليب
"هل يمكن اعتبار سؤال "ما الفلسفة؟" مدخلا إلى الفلسفة ؟" ـ محمد غمـري
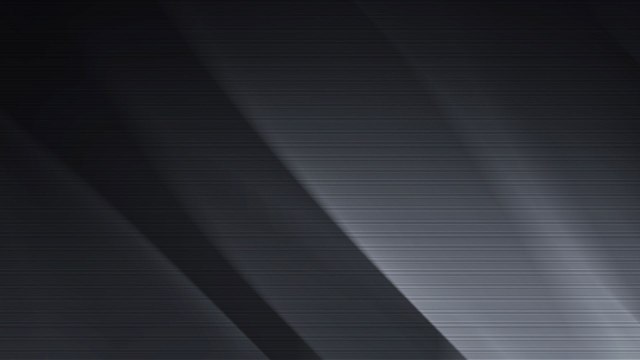 يحيل هذا السؤال على مفارقة إشكالياتية تمكن قراءتها على وجهين : يتمثل الأول في حروف السؤال المكونة له (هل، و ما) باعتبارها تحيل إلى البدايات الأولى للفلسفة مع سقراط على وجه الخصوص، ويتمثل الوجه الثاني في كونه ينصب على "المدخل الفلسفة"، ومعنى ذلك أن سؤال "ما الفلسفة" قــد يشكل مدخلا للفلسفة، لكن ماذا نقصد بالمدخل إلى الفلسفة؟ هل يعني ذلك الطواف حولها دون الولوج إلى عمقها؟ هل يعني تكوين تصور عام حول أفكارها، تاريخها، ومشاكلها دون امتلاك القدرة على ممارستها؟ أليس طرح السؤال وفق الصياغة التالية: "هل يمكن اعتبار سؤال "ما الفلسفة؟" مدخلا إلى التفلسف؟" أكثر تعبيرا عن روح الفلسفة، باعتبار أنه لا يمكن أن ندخل إلى عوالم الفلسفة دون ممارسة فن التفلسف؟...
يحيل هذا السؤال على مفارقة إشكالياتية تمكن قراءتها على وجهين : يتمثل الأول في حروف السؤال المكونة له (هل، و ما) باعتبارها تحيل إلى البدايات الأولى للفلسفة مع سقراط على وجه الخصوص، ويتمثل الوجه الثاني في كونه ينصب على "المدخل الفلسفة"، ومعنى ذلك أن سؤال "ما الفلسفة" قــد يشكل مدخلا للفلسفة، لكن ماذا نقصد بالمدخل إلى الفلسفة؟ هل يعني ذلك الطواف حولها دون الولوج إلى عمقها؟ هل يعني تكوين تصور عام حول أفكارها، تاريخها، ومشاكلها دون امتلاك القدرة على ممارستها؟ أليس طرح السؤال وفق الصياغة التالية: "هل يمكن اعتبار سؤال "ما الفلسفة؟" مدخلا إلى التفلسف؟" أكثر تعبيرا عن روح الفلسفة، باعتبار أنه لا يمكن أن ندخل إلى عوالم الفلسفة دون ممارسة فن التفلسف؟...
إن هذه المحاولة سوف تعمل أساسا على تجاوز هذا السؤال، وذلك من منطلق أساسي يجب التصريح به منذ البداية، وهو أن سؤال "ما الفلسفة؟" لا يمكن اعتباره مدخلا إلى الفلسفة، بل إن محاولة الإجابة عنه تقذف بنا مباشرة في عالم التفلسف، باعتباره ممارسة للفلسفة، وليس مدخلا إليها، ففي الفلسفة لا توجد هناك مداخل، كل ما هنالك هو ممارسات للتفلسف، ولبناء الحجة على هذا القول سوف يتم الاستناد على طرحين أساسيين، يتعلق الأول بتصور الفارابي لحروف السؤال الفلسفي، التي تشكل الآليات الأولية لممارسة التفلسف، ويتعلق الثاني بمفارقة "مينونMénon " التي تضعنا وجها لوجه أمام أحد أهم المكونات البنيوية لتاريخ الفلسفة، والشاهد على ذلك، تلك القراءة التي قام بها ميشل مايير لتاريخ الفلسفة باعتباره تاريخا إشكالاتيا، أي تاريخا يعمل على تجاوز هذه المفارقة في شتى محطات تاريخ الفلسفة : "أن تاريخ الفلسفة منذ سقراط هو تاريخ مفارقة مينون ؟" تلك المفارقة التي تتضمن إشكالية "أيهما أسبق من الآخر : الوجود أو المعرفة؟ الأنطولوجيا أم الابستمولوجيا؟"... ربما قد يلف بعض الغموض هذه الفقرة، لكن غموض سوف ينبلج شيئا فشيئا، كلما تقدمنا خطوة نحو معالجة هذا الموضوع...
مفهوم لاتناهي العالم عند كبلر من منظور ألكسندر كويري ــ الاعرج بوجمعة
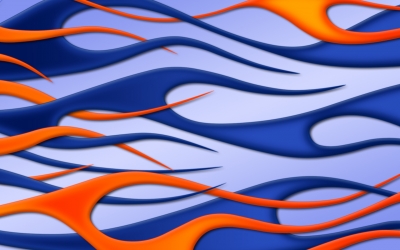 تقديم:
تقديم:
شكل مفهوم اللاتناهي أحد الإشكالات ذات الأهمية في العصور الحديثة، رغم الرفض الذي تعرض له في السابق؛ أقصد مع المشائيين. فألكسندر كويري في كتابه: "من العالم المغلق إلى الكون اللامتناهي"، تطرق إلى فكرة اللاتناهي، فيقول إنها ليست فكرة حديثة ومنعدمة في الفلسفات القديمة والوسطوية، معترفا بالدور الذي لعبه كل من نيكولاس دي كوس Nicolas de Cuses، والذين سيأتون من بعده: كبلر، ديكارت.. فالقول باللانهائية يستلزم زحزحة مجموعة من العقائد والأفكار غير العلمية والتي تم تغليفها بغطاء ديني، كما نجد عند سان أوغسطين، من قبيل قوله "إن اللانهائي صفة للإيمان بالله.." لذا نجد ملاحظات تيكوبراهي واستنتاجات كبلر نقلت هذا العلم ومعه العقل البشري من المقاصد الغائية المتعالية، أو ما كان يصطلح عليه "بإنقاذ الظواهر" إلى نظرة علمية للكون شملت كل مجالات الحياة في العصر الحديث.
لكن ما يهمنا نحن هو إبراز كيف تعامل كبلر مع هذا الحدث العلمي؟ ما هي الأسس الإبيستمولوجية التي جعلت كبلر يقول بفكرة اللاتناهي وتعدد العوالم؟
1. كبلر مؤسس علم الفلك الحديث:
اعتبر يوهانس كبلر مؤسس الفلك الحديث نظرا لأهمية الأبحاث التي قام بها، والتي تتلخص في قوانين كبلر الثلاثة. إنها أهم اكتشاف قدم للمنظومة، تصف مدرات الكواكب حول الشمس، مبتعدا عن التفاسير الفيتاغورية القديمة رغم اعتماد كبلر عليها.
ما هي الفلسفة؟ (*) ـ جيل دولوز و فيليكس غوتاري ـ ترجمة : عبدالعالي نجاح
 ربما أن طرح مسألة ما هي الفلسفة؟ لا يتأتى إلا آجلا، حين تقبل الشيخوخة وساعة الحديث بطريقة ملموسة. تطرح هذه المسألة حين تنتفي المواضيع التي تستدعي السؤال، لكن تكون نتائجها مهمة.
ربما أن طرح مسألة ما هي الفلسفة؟ لا يتأتى إلا آجلا، حين تقبل الشيخوخة وساعة الحديث بطريقة ملموسة. تطرح هذه المسألة حين تنتفي المواضيع التي تستدعي السؤال، لكن تكون نتائجها مهمة.
فيما مضى، نطرحها ولا نكف عن طرحها، لكن بشكل جد سطحي وجد تجريدي؛ نعرضها ونحتويها أكثر مما نحن مشذوذين بها. توجد حالات حيث لا تمنح الشيخوخة شبابا أبديا، لكن على العكس حرية مطلقة، وضرورة خالصة حيث ننعم بالسكينة بين الحياة والموت، وحيث تأتلف كل أجزاء الآلة قصد إرسال في المستقبل سمة تخترق العصور، تورنر وموني وماتيس (1). فقد اكتسب أو انتزع تورنر في شيخوخته حق إنقياذ الصباغة في طريق قاحلة وبدون رجعة، والتي لا تتميز قط عن السؤال الأخير. وكذا الشأن في الفلسفة، إذ أنجز كتاب (نقد الأحكام) لكانط في مرحلة الشيخوخة، كتاب متحرر لن يتوقف أتباعه عن السعي وراءه.
لا ندعي الوصول إلى هذه المكانة، كل ما في الأمر، أن الوقت قد حان لنتساءل عن ماهية الفلسفة. لم نتوقف عن القيام به سابقا، ونمتلك مسبقا الجواب الذي لم يتغير: الفلسفة فن تكوين وإبداع وصناعة المفاهيم. لكن لا ينبغي فقط أن يتضمن الجواب السؤال، بل يتطلب أيضا تحديد لحظة معينة ومناسبة وملابسات ومشاهد وشخصيات وكذا شروط ومجهولي السؤال. يتطلب إمكانية طرحه "بين الأصدقاء"، كبوح أو ثقة، أو في وجه العدو، كتحدي، وفي نفس الآن بلوغ تلك اللحظة، بين الكلب والذئب، حيث نتوجس حتى من الصديق.
جدل المنطق و جدل راأس المال ـ المختار منودي
 يهدف هذا المقال الى معالجة المنهج الجدلي الموظف من قبل كتاب ماركس رأس المال، مع ضبط علاقة جدل التواصل والتفاصل بين جدل المنطق الكبير وجدل رأس المال.
يهدف هذا المقال الى معالجة المنهج الجدلي الموظف من قبل كتاب ماركس رأس المال، مع ضبط علاقة جدل التواصل والتفاصل بين جدل المنطق الكبير وجدل رأس المال.
مقدمات غنية:
تشكل مقدمات رأس المال عنصرا شارحا هاما لنظرية ماركس وانجلز الاقتصادية. وهي لا تكتفي، في الغالب، بتقديم رؤى عامة توضيحية حول نتائج فصول الكتاب، وإنما تتجاوز ذلك نحو شرح الموضوع الذي ينصب نحوه مجهود ماركس العلمي، وكذا طريقته الديالكتيكية الموظفة في الكتاب. وبعد اطلاعنا على: -مقدمة الطيعة الألمانية الأولى، تذييل الطبعة الألمانية الثانية، مقدمة الطبعة الألمانية الثالثة، مقدمة الطبعة الإنجليزية، ومقدمة الطبعة الألمانية الرابعة، وجدنا أنه من الضروري مقاربة بعض النصوص المفتاح لاستيعاب جدة نظرية ماركس من حيث الموضوع والمنهج (طريقة البحث وطريقة العرض) والمفاهيم الموظفة.
مفهوم الواقع بين ستيفن هوكينغ وجون بودريار 3/2 ـ علي الحسن أوعبيشة
 " إلى المؤمنين بالواقع: أيتها السذاجة المقدّسة! يا له من تبسيط وتزييف غريب يعيش فيه الانسان! فما إن يفتح المرء عينيه ليبصر هذه الأعجوبة حتى لا يعود للعجب من نهاية! كم جعلنا كل شيء من حولنا باهرا وحرا، خفيفا وبسيطا! وكم برعنا في إفلات حواسنا على كل ما هو سطحي وفي تزويد فكرنا برغبة إلهية في البهلوة وفساد الاستدلال! "
" إلى المؤمنين بالواقع: أيتها السذاجة المقدّسة! يا له من تبسيط وتزييف غريب يعيش فيه الانسان! فما إن يفتح المرء عينيه ليبصر هذه الأعجوبة حتى لا يعود للعجب من نهاية! كم جعلنا كل شيء من حولنا باهرا وحرا، خفيفا وبسيطا! وكم برعنا في إفلات حواسنا على كل ما هو سطحي وفي تزويد فكرنا برغبة إلهية في البهلوة وفساد الاستدلال! "
ف. نيتشه، ما وراء الخير والشر(ص:51)
طرح هوكينغ نموذجا آخر للواقع البديل نجده في فيلم ماتريكس The Matrix أو المصفوفة، مفاده أن "البشر يعيشون في واقع خيالي بدون أن يعرفوا ذلك، واقع تمت محاكاته بواسطة كمبيوترات ذكية كي تحافظ عليهم مسالمين وقانعين، بينما تمتص الكمبيوترات طاقتهم البيو-كهربائية".
وهذه رؤية مجازية، للنظرية التي عرضها جان بودريار في الكثير من كتبه، والقائمة على كون الواقع أصبح مشبعا بنقائضه، إذ اتسعت رقعته ليشمل ما اعتبرناه ليس واقعيا، وهذا ما عرضه في نظريته عن الواقع-الفائق.
وتستند نظرية بودريار عن الواقع الفائق، إلى أساسين: الأول فلسفي صرف، والثاني يتعلّق بنتائج التقدم العلمي خصوصا في مجالات تطبيقات العلم.
بخصوص الأساس الفلسفي، فهو مرتبط بالسيرورة النظرية لتطور إشكالية الواقع، وبالخصوص كل من هيجل ونيتشه، بخصوص هيجل فإن بودريار استطاع أن يستثمر مفهوم الواقع عند هيجل باعتباره مطابقا للمطلق ومتماهٍ معه، ومن ثمّ تصبح جميع الأحلام اليوتوبيات متحقّقة على أرض الواقع، وهذا ما يحيلنا إلى الحديث عن ماوراء النهاية(...) أما بخصوص نيتشه فقد أحدث ثورة كبرى في الفلسفة، إذ بقلبه للأفلاطونية، استطاع أن يوحّد الذهن البشري مثلما وحّد غاليلي العالم، إذ أنهى التراتبية التفاضلية في الذهن بين الحقيقة والخطأ من جهة، وبين الحقيقة والوهم والخيال من جهة أخرى، وهكذا فإذا كنّا قد نظرنا منذ غاليلي إلى العالم كوحدة، فمنذ نيتشه بدأت بوادر النظر إلى الذهن البشري كوحدة كذلك.
مفهوم الهوية في فكر عبد الكبير الخطيبي ــ اوبلوش محمد
 أ-الهوية المتعددة:
أ-الهوية المتعددة:
إذا كانت الهوية، هي ما يجعل شخصا ما يكون هو لا سواه. فهي تحديد لمقومات وقيم هذا الشخص، وبعبارة أخرى هي تحديد الذات بموروثها الثقافي وبتعدده.( الدين، التقاليد، العرق...) ثم تحديد للأنا.
عندما تكون للشخص هوية ويكون له تاريخ ( ذاكرة- ماض كيفما كان مجيدا أو ماض الانحطاط). ويدرك من هو ومن يكون، فإن هذا الشخص يصبح إنسانا سويا كاملا وقادرا على الإبداع. في حدود خطوط هويته مع الانفتاح على هوية الآخر. هذا الآخر الغريب عن الذات بمقوماتها ومكوناتها. فالجماعة بدون هوية كالقطيع التائه الضائع، وتصبح (أي الجماعة بدون هوية) كالوعاء الفارغ الذي يستطيع أي كان أن يملأه بما شاء ومتى شاء. دون الاعتراف لهذه الجماعة بماضيها وموروثها. وحقها في الاختلاف الذي يفسح المجال للهوية المتعددة، التي لا تتحدد بالانتماء إلى نفس العرق، كما لا يمكن اختزالها في ممارسة بعض الطقوس، بل إنها مفهوم يتكون عبر التاريخ. مفهوم يرتبط بالوجود والذات والذاكرة ويرتكز على عدة مكونات أهمها: (الأرض، الدم، العقيدة، اللغة، الموروث الثقافي...) مفهوم مفتوح على المستقبل في تعايش مع الآخر واعتراف باختلاف مشروع.
يقول الخطيبي عن هذا المفهوم:" كل مجتمع يعيد كتابة المكان الذي يتأصل فيه ثانية فيما يعيد كتابة تاريخه وبهذه الحركة يسقط على الماضي ما يفلت منه في الحاضر. بلى، إن التاريخ هو مسكن الإنسان ومنبت هويته المتعددة. لكن نحو أي تأريخي يتجه؟"[1].
التصوف كرؤية للعالم ـ اشريف مزور
 مدخل:
مدخل:
مما لا شك أن الإنسان هو الكائن الوحيد الذي يعي وجوده في هذا العالم. وغير خاف أيضا أن حاجة الإنسان لإدراك العالم من حوله وسبر أغواره هي حاجة إلى الفهم، بقدر ما هي رغبة لإعادة بنائه وتغييره، لذاك فرؤى الإنسان المختلفة للعالم تجسد نزوعه اللامحدود إلى تعقله والفعل فيه، بحثا له عن موقع في خضم الوجود، بل وتمردا على ما هو موجود. لا ارتياب في أن موقف الإنسان من قضايا الوجود يترجم هوسه بإيجاد المعنى ومنح القيمة للأشياء، ظهر ذلك في العلم والتقنية والجمال والمقدس...
ورغم اختلاف الطرق الاستدلالية والمادة المفهومية في هذه الرؤى، فإنها تشترك جميعا في إضفاء مشروعية على طموح الإنسان لضمان استمرارية بقائه. ألم يقل ديكارت Descartes عن حركة اليد الإلهية (Pichenette) بأن الله قد خلق العالم (صنعه)، لكن لم يضع له غاية محددة ومعينة مسبقا، فالعالم إذن يستقيم بموارده وقوانينه الخاصة، وهي القوانين التي على الإنسان اكتشافها، وفي لحظة الاكتشاف والإدراك والتمثل والرؤية والصياغة والتعبير اختلفت العقول البشرية وتباينت منطلقاتها ونتائجها، لكن هذا لا يمنع من استنبات تقاليد حوارية بين المباحث والرؤى تلافيا لمنطق الدوغمائية الشال لخصوبة الإمكان، وقد لا تعني الحوارية هنا أكثر من السماح بالتراوح والتذاوت Intersubjectivité والتعارف والتيهان...
ابن طفيل ورؤيته للعالم من خلال قصته "حي بن يقظان" ـ اشريف مزور
 وما زال يطلب الفناء عن نفسه والإخلاص في مشاهدة الحق، حتى تأتى له ذلك، وغابت عن ذكره وفكره السماوات والأرض وما بينهما، وجميع الصور الروحانية والقوى الجسمانية وجميع القوى المفارقة للمواد...وغابت ذاته في جملة تلك الذوات، وتلاشى الكل واضمحل، وصار هباء منثورا، ولم يبق إلا الواحد الحق الموجود الثابت الوجود...
وما زال يطلب الفناء عن نفسه والإخلاص في مشاهدة الحق، حتى تأتى له ذلك، وغابت عن ذكره وفكره السماوات والأرض وما بينهما، وجميع الصور الروحانية والقوى الجسمانية وجميع القوى المفارقة للمواد...وغابت ذاته في جملة تلك الذوات، وتلاشى الكل واضمحل، وصار هباء منثورا، ولم يبق إلا الواحد الحق الموجود الثابت الوجود...
فلسفة ابن طفيل ورسالته "حي ابن يقظان"، تحقيق عبد الحكيم محمود، دار الكتاب اللبناني، بيروت، لبنان، 1982، ص.141.
مدخل:
لا جدال في أن الإنسان هو الكائن الوحيد الذي حول أشياء العالم بغناها إلى أفكار ومعقولات وإبداعات أدبية. وقد لا نجانب الصواب إذا قلنا بأن عقلنة العالم وصبغه بمسحة جمالية وأدبية تعني تحديد موقف أو رؤية للوجود انطلاقا من مبادئ معينة.
وبما أن أشياء العالم كثيرة ومتنوعة تنأى بنفسها عن الحصر والضبط، فإننا نفهم تعدد منظورات الإنسان إليها، وهذا ما يشكل دافعا قويا نحو إيجاد تقاليد تحاورية بين المباحث والرؤى، وقد لا تعني الحوارية هنا أكثر من التراوح والتيهان والبينذاتية وتكسير الحدود الشالة لخصوبة الإمكان.
عرف العصر العباسي ازدهارا أدبيا وفلسفيا وعلميا لاسيما بعد تأسيس بيت الحكمة، حيث ترجمت عيون التآليف الإغريقية والساسانية والهندية. في هذا الصدد، ومن زاوية فلسفية، طرحت إشكالية الدخيل والأصيل مضمونا ومنهجا، وهو الخلاف الذي جسده المتفلسفة والمتكلمة فيما عرف بإقرار التوافق بين الحكمة والشريعة في مختلف تجلياتهما (مناظرة متى للسيرافي لا تخرج عن هذا الإطار). ولنا في نصوص الفارابي والباقلاني والغزالي...ما يشهد على غنى هدا السجال النقدي. ونستحضر هنا تأليف ابن المعتز لكتابه "البديع" كرد على الشعوبية الذين زعموا أن البديع صناعة دخيلة اقتبسها المحدثون من بلاغة اليونان، بسوق أدلة من كلام النبي والصحابة وأشعار المتقدمين تبين أصالة البلاغة العربية([1]).
المونادولوجيا عند لا يبنيز ـ مصطفى قشوح
 ينطلق لا يبنيز من فكرة أساسة مفادها أن هناك تناغم و انسجام بين أشياء العالم , فالطبيعة أو نظام العالم عند لايبنيز هي مثل ساعة دقيقة صنعها الله بإحكام . فالله مع لايبنيز ليس ساعاتيا رديئا كما هو الحال مع مالبرانش, لأنه خلق هذا العالم بشكل منقطع النظير واختار أفضل العوالم الممكنة وأحسنها للإنسان .
ينطلق لا يبنيز من فكرة أساسة مفادها أن هناك تناغم و انسجام بين أشياء العالم , فالطبيعة أو نظام العالم عند لايبنيز هي مثل ساعة دقيقة صنعها الله بإحكام . فالله مع لايبنيز ليس ساعاتيا رديئا كما هو الحال مع مالبرانش, لأنه خلق هذا العالم بشكل منقطع النظير واختار أفضل العوالم الممكنة وأحسنها للإنسان .
يوضح لا يبنيز في رسالته:" في فن التركيب" أن الكون بأكمله عبارة عن مجموعة من المركبات، وكل مركب يتكون من أجزاء، وكل جزء يتكون من أجزاء دقيقة وهكذا دواليك حتى نصل إلى الجزء الذي لا ينقسم ويسميه لايبنيز بالذرات غير القابلة للانقسام أو المونادات،وهي جسيمات لا مادية غير قابلة للقسمة أو التجزيئ.
لكن هل توجد هده الذرات اللامادية في الواقع ؟
وما هو البرهان الذي قدمه لايبنيز كي يقنعنا بأنها موجودة فعلا ؟
يجيب لا يبنيز: إن الشاهد الوحيد على وجود هذه المونادات هو النفس البشرية، فالنفس الإنسانية عبارة عن مونادة بسيطة غير قابلة للقسمة وغير مادية. فالأنا أفكر جوهر بسيط يفكر ويشعر و يحس، ويتخيل ، إذن فمنبعه روحي . هكذا بعدما قدم لا يبنيز الشاهد على وجود هده الذرات . قال إن الكون عبارة عن مونادات وأنها المسؤولة عن تكوين كل المركبات المادية الكبرى التي نشاهدها بالعين المجردة.
فلكل جسم مونادة محددة تميزه عن باقي الأجسام ، فاختلاف الأجسام نابع عن اختلاف مونادته، فلكل جسم مونادة خاصة به او كما يقول لا يبنيز:










