 أثارت علاقة مارتن هايدغر بالنازيّة جدلا مطوّلا بدأ في حياة الفيلسوف الشهير ولم ينته بمماته. غير أنّ الكتب والمقالات العديدة التي تناولت هذا الموضوع لا يمكنها أن تعوّض الوثائق. وتمثّل بداية نشر "الدفاتر السوداء"، في السنة الماضية، وهي اليوميات التي كان يكتبها فيلسوف الغابة السوداء، منعرجا جديدا لهذا النقاش. غير أنّ ذلك لا ينبغي أن ينسينا أهميّة وثائق أخرى مثل الرّسالة التي كتبها هايدغر إلى الفيلسوف الأمريكي هربرت ماركوزة، بتاريخ 20 يناير 1948، نظرا لخصوصيّة السياق. فهايدغر لم يتطرّق لعلاقته بالنازيّة طيلة حياته تقريبا. وحتّى الحوار المطوّل الذي أجراه مع مجلّة دير شبيغل الألمانية والذي تضمّن حديثا مستفيضا عن الفترة النازية وعن دوره فيها، لم ينشر إلاّ بعد وفاته، احتراما لوصيّته، وكان ذلك في 31 مايو 1976 رغم أنّه يعود إلى سنة 1966. ولكنّ الفرق واضح بين حديث صحفي موجّه للعموم ورسالة مكتوبة لا تخلو من بوح ومن حميمية.
أثارت علاقة مارتن هايدغر بالنازيّة جدلا مطوّلا بدأ في حياة الفيلسوف الشهير ولم ينته بمماته. غير أنّ الكتب والمقالات العديدة التي تناولت هذا الموضوع لا يمكنها أن تعوّض الوثائق. وتمثّل بداية نشر "الدفاتر السوداء"، في السنة الماضية، وهي اليوميات التي كان يكتبها فيلسوف الغابة السوداء، منعرجا جديدا لهذا النقاش. غير أنّ ذلك لا ينبغي أن ينسينا أهميّة وثائق أخرى مثل الرّسالة التي كتبها هايدغر إلى الفيلسوف الأمريكي هربرت ماركوزة، بتاريخ 20 يناير 1948، نظرا لخصوصيّة السياق. فهايدغر لم يتطرّق لعلاقته بالنازيّة طيلة حياته تقريبا. وحتّى الحوار المطوّل الذي أجراه مع مجلّة دير شبيغل الألمانية والذي تضمّن حديثا مستفيضا عن الفترة النازية وعن دوره فيها، لم ينشر إلاّ بعد وفاته، احتراما لوصيّته، وكان ذلك في 31 مايو 1976 رغم أنّه يعود إلى سنة 1966. ولكنّ الفرق واضح بين حديث صحفي موجّه للعموم ورسالة مكتوبة لا تخلو من بوح ومن حميمية.
«الفيلسوف والسياسة» حوار مارتن هايدغر لمجلة Der Spiegel ـ ترجمة وتقديم : حمودة إسماعيلي
عرفت الفلسفة في تاريخها عدة انعطافات، أبرزها انعطافة نيتشه الذي قلب الطاولة الفلسفية على اعتبار أن قيمها لا تصلح للحياة بعدما تحجرت أخلاقياتها، عند نيتشه هناك لزوم لقلب التاريخ الفلسفي حتى ينقلب الخطاب الميت أو الداعي/الممجد للموت إلى خطاب نحو الحياة والوجود والمرح. عند هايدغر يصل الأمر لأكثر من ذلك، باعتبار أن ذلك التاريخ بانعطافاته ليس سوى انحرافا في التفكير، "تناسيا" كما يصفه في تأويلاته الأنطولوجية، بذلك تطلب الأمر العودة لأسس ذلك التاريخ ـ الإغريقي بجوهره ـ للتساؤل مجددا حول أهم المقولات الفلسفية كـ"الإنسان"، "الوجود"، و"الفكر". لوضع التفكير في اللامفكر فيه، أو التفكير مجددا بأننا لم نكن نفكر. هايدغر كما هو مفكر إبستيمولوجي ذا خطاب فلسفي (بامتياز) هو أيضا بالعمق مفكر سياسي بالمعنى الواسع للممارسة السياسية : كتنظير/رؤية/توقع. في هذا الحوار الذي أجراه معه كل من رودولف أوغشتاين وجورج وولف لمجلة الشبيغل الألمانية ب23 سبتمبر (أيلول) 1966 : يتداخل ما هو فلسفي بما هو سياسي في حديث هايدغر ـ الذي يتجلى بكامل هيئته الفكرية ـ حول رؤيته للحضور الإنساني الحديث والحالة الراهنة للعالم، ليرتكز بحديثه أكثر على السياسة التكنولوجية للعالم اليوم، الوضع الذي تصفه الفرنسية سيمون دي بوفوار بتعبيرها : "مهما كانت الدولة، رأسمالية أو اشتراكية، فالإنسان مسحوق أينما كان من طرف التكنولوجيا، التي تجعله متغرّبا عن عمله، مسجونا، ومجبرا على التخلف".
تم نشر الحوار بـ31 من شهر ماي (أيار) سنة 1976، بعد خمسة أيام من وفاة هايدغر ـ بناءً على طلبه بأن لا ينشر الحوار بحياته ـ تحت عنوان "إله فقط هو من باستطاعته إنقاذنا"، وهي جملة تضمنها حديث هايدغر بالحوار، وتم اعتماد نفس العنوان بالترجمات التالية لهذا الحوار :
لماذا يجب أن نكون ديكارتيين ؟ ـ هادي معزوز
 يجب أن نكون ديكارتيين أولا، لأن بنية أسئلة الواقع المعيش، تفترض منا الانطلاق من التفكير للتأسيس للوجود، إذ كل وجود متماسك هو نتيجة تفكير منهجي صارم، قائم على روح السؤال والشك في البديهيات، ومبني على صرح عقلاني محض، العقل ملكة تساعدنا على التمييز بين الصواب والخطأ، يحتفظ بما هو صائب، ثم يعود للخطأ يفككه إلى أكبر قدر ممكن من الأجزاء، يركبه مرة أخرى ثم يفحصه ويراجعه ليس باعتباره خطأ متعاليا، وإنما بمدى قوته ووقعه علينا.
يجب أن نكون ديكارتيين أولا، لأن بنية أسئلة الواقع المعيش، تفترض منا الانطلاق من التفكير للتأسيس للوجود، إذ كل وجود متماسك هو نتيجة تفكير منهجي صارم، قائم على روح السؤال والشك في البديهيات، ومبني على صرح عقلاني محض، العقل ملكة تساعدنا على التمييز بين الصواب والخطأ، يحتفظ بما هو صائب، ثم يعود للخطأ يفككه إلى أكبر قدر ممكن من الأجزاء، يركبه مرة أخرى ثم يفحصه ويراجعه ليس باعتباره خطأ متعاليا، وإنما بمدى قوته ووقعه علينا.
نحن ديكارتيون إذن لأن بنية مجتمعنا لازالت محكومة بروح اتصالية، لازال الانفصال أفقا بعيد المنال، إذ ليس بينهما تضاد كما يُعتقد، بقدر ما أن الانفصال ابن بار للإتصال، صحيح أنه قتله، لكن الأمور من أساسها تُؤخذ، والأصل يبقى دوما منبع الفصل والتفرع، واقعنا المعيش واقع تحكمه عقلية القطيع، وكل منفصل عن القطيع مصيره الطرد الرمزي منه والمادي، واقعنا واقع إمَّعة يتوجس من الفرد لصالح النحن، إذ الفرد عندنا ليس من التفرد والفرادة وإنما من الفردنة والعزلة، إننا نعتبر كل استئصال تنكر للأساس، ونعتبر قتل الأب جريمة، إننا ننتج أبا فينا من حيث لا ندري، من هنا تنبني خصوصية مجتمعنا على الاتصال ضد الانفصال، على الأصل ضد الفرع، وعلى الأيقونة ضد السيمولاكر.
واقعتنا الحياتية ما بين ردة الانخراط وممكنات الخروج ـ طوسون البديري
 الحياة هي صراع الجميع ضد الجميع هكذا استطاع ميلان كونديرا تلخيص ليس فقط حالة المعاش الراهن بل حالة المعاش الحديث بِرُمّتِهِ الذي تم تدشين وِلاَدَتَهُ فلسفياً على يد ديكارت ، فجراء تلك الأطروحات الفلسفية الديكارتية خرجنا كما يقول هيدجير من براديغم التوافق الذي كانت تتأطر الحياة بالعصور الوسيطة والقديمة داخل إطاره الى براديغم التسيد ، فآلية تآويل الانسان كذات المنجز الاهم للحداثة الغربية تم تسييره وفق خطة ديكارتية هدفها التسيد والسيطرة على الطبيعة وتحول العَالم بفضل ذلك إلى موضوع خارج عنا ومن ثمّ إلى صورة مُدرَكة .
الحياة هي صراع الجميع ضد الجميع هكذا استطاع ميلان كونديرا تلخيص ليس فقط حالة المعاش الراهن بل حالة المعاش الحديث بِرُمّتِهِ الذي تم تدشين وِلاَدَتَهُ فلسفياً على يد ديكارت ، فجراء تلك الأطروحات الفلسفية الديكارتية خرجنا كما يقول هيدجير من براديغم التوافق الذي كانت تتأطر الحياة بالعصور الوسيطة والقديمة داخل إطاره الى براديغم التسيد ، فآلية تآويل الانسان كذات المنجز الاهم للحداثة الغربية تم تسييره وفق خطة ديكارتية هدفها التسيد والسيطرة على الطبيعة وتحول العَالم بفضل ذلك إلى موضوع خارج عنا ومن ثمّ إلى صورة مُدرَكة .
وبعد ان تم تآويل الانسان كَذات وتحول العالَم الى صورة مُدرَكة تم تحقيق "السيرورة الاساسية للازمنة الحديثة وهي غزو العَالم من حيث هو صورة مُدرَكة "1.، وعبر استمرار تلك السيرورة من حلم التسيد والسيطرة نستطيع القول بأننا وصلنا مع براديغم التسيد والذي تم تدشينه منذ عدة قرون الى انتاج انسان جديد كُل الجِدَّة وهو إنسان نستطيع ان نسميه بإنسان الشُغل والمول ، فهو انسان تآكلت ذاته وماتت فاعليته مما حدا بالفيلسوف الفرنسي ميشيل فوكو الى إعلان موت الانسان .2
في الحاجة إلى الخطأ ـ هادي معزوز
 سيكون من العبث واللامعقول بالنسبة للسواد الأعظم من الناس التسليم بحاجتنا إلى الخطأ، كما سيعدو من اللامنطق بماكان قبول الخطأ بل وتمجيده، إننا نعمل طول حياتنا من أجل تجنبه وليس تكريسه، والحال أن العقاب قد تم اكتشافه ووضعه من طرف أجدادنا الأوائل لطرد الخطأ وعدم ارتكابه أكثر من مرة، الحياة مليئة بالأخطاء التي لا نرغب في أن نكون ضحاياها، لأنها وبكل بساطة تضر بنا ،هذا إذا لم تقتلنا، فكم من الأشخاص قتلتهم قاعدة إعادة الخطأ مرات ومرات فباتوا بأخطائهم هاته تعساء لا حول لهم ولا قوة.
سيكون من العبث واللامعقول بالنسبة للسواد الأعظم من الناس التسليم بحاجتنا إلى الخطأ، كما سيعدو من اللامنطق بماكان قبول الخطأ بل وتمجيده، إننا نعمل طول حياتنا من أجل تجنبه وليس تكريسه، والحال أن العقاب قد تم اكتشافه ووضعه من طرف أجدادنا الأوائل لطرد الخطأ وعدم ارتكابه أكثر من مرة، الحياة مليئة بالأخطاء التي لا نرغب في أن نكون ضحاياها، لأنها وبكل بساطة تضر بنا ،هذا إذا لم تقتلنا، فكم من الأشخاص قتلتهم قاعدة إعادة الخطأ مرات ومرات فباتوا بأخطائهم هاته تعساء لا حول لهم ولا قوة.
في هذا المقام سنعمل على قراءة الخطأ من زاويته اللامفكر فيها، ومن بعده المتستر عنا، لهذا فنحن ملزمين بطرح سؤال من يرتكب الخطأ؟ الخطأ فعل مرتكب من الحركة وليس من الجمود، ابق مكانك لا تتحرك آنذاك لن ترتكب أي خطأ، لكن إذا غامر الفكر وزاد من جرأته، حينها قد يسقط في الخطأ بداية، لكن تجاوز الخطأ هو من صميم الخطأ نفسه، ليس بينه وبين الصواب علاقة تنافر وتضاد كما يعتقد البعض، الخطأ يحاول أن يصبح صوابا عن طريق الخطأ، مادام الصواب نفسه ليس يستوي منطقه إلا عن طريق خطأ الخطأ، صحيح أن هاته العلاقة المنطقية لم تظهر عند ولادة المنطق مع أرسطو، كان الرجل يعتقد أن الأورغانون الذي أنشأه من شأنه طرد الخطأ، لكنه أغفل جانبا مهما من اللعبة ألا وهو تصور الحياة والوجود بصفة عامة بدون خطأ، الواقع أن منطق أرسطو هو منطق لتصحيح الخطأ وللعصمة من الزلل حسب قول المعلم الأول، حيث وضعه للحد مما كان يعتقده أخطاءً مرتكبة بسبب إشكالية الجذر التربيعي الفيتاغورية، وعن طريق مفارقات زينون الإيلي، وأغاليط السفسطائيين الغريبة، من ثمة فإن صواب أرسطو لم يكن ليخرج إلى أرض الواقع لولا أخطاء الذين سبقوه، هذا إذا كانت أخطاء حقا.
مارتن هيدجر والطريق القصير نحو الوجود ـ د.زهير الخويلدي
 إذا كان أدموند هوسرل قد أدخل الفنومينولوجيا إلى مجال البحث الابستيمولوجي وبحث في نظرية المعرفة ومسألة الوعي وانتهى إلى أزمة العلوم الأوروبية فإن مارتن هيدجر قد نقلها إلى المجال الأنطولوجي وجعلها منهجا بحثيا في أحوال الوجود وتفطن إلى خطورة التقنية والعقل الأداتي وأهمية الشعرية. وإذا كانت الأنثربولوجيا الفلسفية مع أرنست كاسرر والفنومينولوجيا المتعينة مع موريس مرلوبونتي قد سلكت الطريق الطويل في تقصي معنى الوجود فإن هيدجر قد اختار الطريق القصير والمباشر في العروج نحو الوجود. وإذا كان الطريق الطويل في استهداف الكائن البشري يشير إلى الأنثربولوجيا الفلسفية التي سعى إلى بنائها بول ريكور وذلك بالتعويل على ما وفرته العلوم الإنسانية من عدة منهجية وطرق اجرائية واستثمار النسق الرمزي للغة والأولوية العلمية والإيتيقية للبيولوجيا والبسيكولوجيا وما تركته الشمولية من جراحات حية وأخلاقية. فإنه على خلاف ذلك يدل الطريق القصير في استهداف الكائن البشري على الأنطولوجيا الأساسية التي أبدعها مارتن هيدجر وتمظهرت في ثوب تحليلية الدازاين بالعزوف عن استثمار نتائج واكتشافات العلوم الوضعية والصحيحة والإنسانية.
إذا كان أدموند هوسرل قد أدخل الفنومينولوجيا إلى مجال البحث الابستيمولوجي وبحث في نظرية المعرفة ومسألة الوعي وانتهى إلى أزمة العلوم الأوروبية فإن مارتن هيدجر قد نقلها إلى المجال الأنطولوجي وجعلها منهجا بحثيا في أحوال الوجود وتفطن إلى خطورة التقنية والعقل الأداتي وأهمية الشعرية. وإذا كانت الأنثربولوجيا الفلسفية مع أرنست كاسرر والفنومينولوجيا المتعينة مع موريس مرلوبونتي قد سلكت الطريق الطويل في تقصي معنى الوجود فإن هيدجر قد اختار الطريق القصير والمباشر في العروج نحو الوجود. وإذا كان الطريق الطويل في استهداف الكائن البشري يشير إلى الأنثربولوجيا الفلسفية التي سعى إلى بنائها بول ريكور وذلك بالتعويل على ما وفرته العلوم الإنسانية من عدة منهجية وطرق اجرائية واستثمار النسق الرمزي للغة والأولوية العلمية والإيتيقية للبيولوجيا والبسيكولوجيا وما تركته الشمولية من جراحات حية وأخلاقية. فإنه على خلاف ذلك يدل الطريق القصير في استهداف الكائن البشري على الأنطولوجيا الأساسية التي أبدعها مارتن هيدجر وتمظهرت في ثوب تحليلية الدازاين بالعزوف عن استثمار نتائج واكتشافات العلوم الوضعية والصحيحة والإنسانية.
النظرة الحداثية لفلاسفة الغرب الإسلامي تجاه المرأة: ابن رشد ومحمد عزيز الحبابي أنموذجاً ـ الأعرج بوجمعة
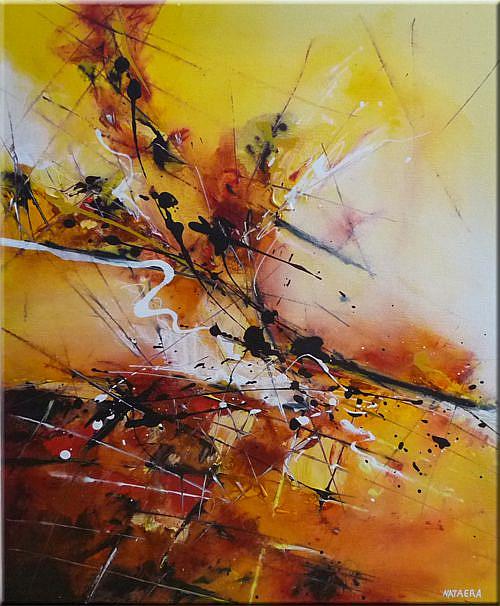 تمهيد:
تمهيد:
إن القارئ لمتون فلاسفة الغرب الإسلامي يجدها تحتوي على خطاب حداثي شمل عدة جوانب؛ سواءٌ على المستوى العلمي أو على المستوى الفلسفي أو على المستوى الاجتماعي، مع الإقرار بوجود تقاطعات بين هذه الجوانب دون أن نراها جزرا متباعدة. لكن الضرورة المنهجية تفرض علينا حصر مجال الاشتغال، لذا حاولنا في هذه الدراسة الاقتصار على نظرة كل من ابن رشد ومحمد عزيز لحبابي تُجاه المرأة واصفين هذه النظرة بأنها حداثية، أو يمكن القول حداثة سابقة لزمانها، حيث نجد نظرتهم للمرأة لا مثيل لها في زمانهم (زمن ابن رشد مثلا) سوى ما تقدمه اليوم الجمعيات النسائية التي تدافع عن حقوق المرأة. فكلما ذُكر اسم ابن رشد يُلصق به أنه من أحيا الفلسفة، وأنه من انتصر للعقل نوعا ما على حساب النقل، كما يذكر كذلك بأنه رافع لقلق العبارة كما نجد في رواية عبد الواحد المراكشي. فالقول أن ابن رشد رافع لقلق العبارة لا يعني أنه ظل بعيدا عن قضايا المجتمع؛ بل كانت له اهتمامات منها نظرته في التربية التي يجهلها العديد من قراء ابن رشد، كما نشير أنها لم تحظى بالبحث كما حظيت قضايا العلم والسياسة، والميتافيزيقا، كما كان له اهتمام بوضع المرأة داخل المجتمع، وداخل المدينة التي يحاول تشيدها، بل أكثر من ذلك أكد أن تطور المدينة رهين بمشاركة المرأة وإدماجها في قضايا المجتمع. هذا القول هو ما بثه ابن رشد في الضروري في السياسة، وهو ما سنحاول نقله للقارئ الكريم. أما بخصوص جعل اسم محمد عزيز الحبابي إلى جانب ابن رشد، فهو لأمرين؛ أولاً كما يقول الأستاذ محمد المصباحي إن كان هناك فيلسوف جاء بعد ابن رشد في الغرب الإسلامي فهو محمد عزيز الحبابي، أما الأمر الثاني فهو منهجي أردت أن أبين بأن النظرة الحداثية لفلاسفة الغرب الإسلامي رغم بدايتها مع ابن رشد، إلا أنها لم تتوقف وإنما ظلت مستمرة، ولعل خير مثال على ذلك نظرة الحبابي إلى المرأة. إنها نظرة تنهل من الكتاب والسنة من جهة، ومن جهة أخرى من خطاب فلسفي شخصاني معاصر يجد جذوره في شخصانية موني. لكن رغم تأثره بشخصانية موني، إلا أن الحبابي ظل يدافع عن شخصانية تعكس واقعه كفيلسوف ينتمي للعالم الثالث. إذن، من هنا نتساءل عن ما الذي ميزّ نظرة فلاسفة الغرب الإسلامي تجاه المرأة وخاصة ابن رشد والحبابي؟ كيف انعكس الخطاب الفلسفي لابن رشد على نظرته للمرأة؟ هل هنالك من قواسم مشتركة بين كل من ابن رشد والحبابي تجاه المرأة؟
المقصد الإيتيقي بين سبينوزا وليفيناس ـ د.زهير الخويلدي
 استهلال:
استهلال:
لا ينطلق المنهج الإيتيقي من التعاليم التي يقدمها العقل وإنما هو الذي يعاين موضوعيا العوامل الطبيعية الضرورية المحددة لحياة الوجدان ويستنبط من "طبيعة الإنسان المألوفة أي من الوضع الإنساني عموما"1[1] ويدرك المجتمع كعلاقات قوى ويهدي الجميع إلى العيش في وئام مع بعضهم البعض ومع نظام الكون.
إيتيقا ليفيناس هي اختبار حاسم تجريه الفلسفة ضد أنانية الفرد وذلك بالتساؤل عن عفوية الأنا ومجهوده في المحافظة على وجوده في ظل حضور الغير والتحلي بالمسؤولية اللاّمتناهية تجاهه دون تحفظ أو احتراز. اذ لا يمكن تعويض وجهة نظر الأنا المنخرط في التجربة المعيشة والكف عن النظر إلى الأخلاق بوصفها بلورة قواعد للحياة الجيدة وفق الخير الأسمى أو وفق مبدأ الواجب وإعادة تعريفها باعتبارها تحمل الذات مسؤوليته تجاه الغير والانفتاح على ماوراء الماهية والإقرار بالوجود المختلف[2]. لكن أي منزلة يحتلها الكائن البشري في الوجود؟ وماهي الفضائل التي يجب أن يكتسبها الإنسان في الحياة ؟ وما نصيبه من مطلب السعادة ومن قيمة الخير؟ ولماذا يفترض الناس أن جميع الأشياء الطبيعية تتصرف مثلهم من أجل غاية؟ وكيف تتولد الأحكام المسبقة المتعلقة بالخير والشر وبالاستحقاق والخطئية وبالثناء والتوبيخ بالنظام والفوضى وبالجمال والقبح عن حكم خاطئ هو العلة الغائية ؟ لكن ماذا لو كانت الغاية الحقيقية من الفعل الإرادي هو الرغبة في الحصول على الشيء النافع وتجنب حصول الشيء الضار؟[3]
إشكالية المنهج الأوتوبيوغرافي في الفلسفة في مقامات السرد والتذكر ـ حيدر علي سلامة
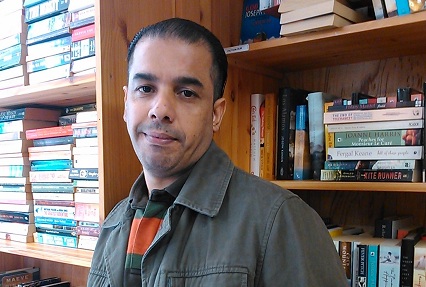 تتحدد طرق وممارسات اشتغال المنهج الأوتوبيوغرافي " AUTOBIOGRAPHIC"في الخطاب الفلسفي من خلال إعادة اكتشاف الأطر الأبستمولوجية والأنطولوجية "للنص الفلسفي" بوصفه –أي النص– علاقة تواصلية جديدة من الناحية الفينومينولوجيةphénoménological ، بين كل من مفهوم الذات subject ومفهوم الموضوع object. ربما هذا هو أهم ما يسعى إليه المنهج الأوتوبيوغرافي ((...الذي يقوم أساسا على كتابة العالم، وعلى ابتكار النص text الذي يُولّد خبرة الذات في العالم، عبر الكلمات (). Understanding Curriculum as Phenomenological and Deconstructed text, Edited By F. Pinar & William M. Reynolds, Teachers College Press, USA, 1992, P. 33
تتحدد طرق وممارسات اشتغال المنهج الأوتوبيوغرافي " AUTOBIOGRAPHIC"في الخطاب الفلسفي من خلال إعادة اكتشاف الأطر الأبستمولوجية والأنطولوجية "للنص الفلسفي" بوصفه –أي النص– علاقة تواصلية جديدة من الناحية الفينومينولوجيةphénoménological ، بين كل من مفهوم الذات subject ومفهوم الموضوع object. ربما هذا هو أهم ما يسعى إليه المنهج الأوتوبيوغرافي ((...الذي يقوم أساسا على كتابة العالم، وعلى ابتكار النص text الذي يُولّد خبرة الذات في العالم، عبر الكلمات (). Understanding Curriculum as Phenomenological and Deconstructed text, Edited By F. Pinar & William M. Reynolds, Teachers College Press, USA, 1992, P. 33
هنا تضعنا الفينومينولوجيا إزاء قانون فلسفي جديد (( يكون فيه التأسيس الموضوعي هو حياة الذات؛ وحيث تصبح فيه معرفة الذات هي معرفة بالذات كعارفة – للعالم، ليس كتعبير عن الذاتية الكامنة، وإنما كمعبر أو وسيط بين هذين الحقلين))Ibid., P.33. والنقطة الأساسية التي نود الإشارة إليها هنا، تتعلق في مدى إمكانية أعادة إكتشاف الجدل التواصلي والفلسفي بين كل ماهو ذاتي/وموضوعي (( اللذان يشكلان بنية الخطاب البيداغوجي/التعليمي للدرس والبحث الفلسفي في آن واحد حينما يستندان على المنهج الاوتوبيوغرافي كمنهج للبحث والتحقق inquiry)) Ibid., P.36. من هنا، نرى أن المنهج الأوتوبيوغرافي أصبح يمثل ابستمولوجيا جديدة للخطاب الفلسفي اولا؛ وللمتلقي السوسيو-ثقافي ثانيا؛ ولتقويض النزعة الوثوقية والأرثوذكسية في الفلسفة التجريبية و المنطق الوضعي ثالثا.
الفيلسوف نيتشه و قضية تأخر العرب ـ حمودة إسماعيلي
 بذكر النازية وإعلائها من قيمة الجنس الآري وتفوق الإنسان الألماني، تتم العودة لنيتشه على اعتبار أنه ممهد هذه الأفكار، لكن عند نيتشه نجد نقدا لاذعا ليس فقط للعرق الألماني بل لكل ما هو ألماني ثقافيا وسياسيا ولغويا وفكريا.. ونقده هنا راجع إلى تحسره على المنظومة القيمية الألمانية التي بددت القيم الجديدة للنهضة والرؤى الحياتية المستقبلية حفاظا على قيم الانحطاط الكنسية، بالارتكاز على الصياغات الواهمة للقومية والتفوق الاجتماعي. هذه النقطة من جهة أخرى يعرّفها جوزيف كامل باعتبارها المسوغ اللامنطقي للفرد الذي يعتبر نفسه ظاهرة استثنائية بالعالم ـ كحماية للذات من الواقع الملتبس ـ معتبرا سلوكاته كلها تمثيلا للخير، ومبررا لها أيضا من منطلق نفس المفهوم، مهما بلغت درجتها (السلوكات) من العنف - مثلما يحدث مع الجماعات الأصولية. فالمسوّغ الذاتي هنا يصبح معيقا ليس فقط لرؤية الذات ـ بمفهوم كامبل ـ بل عن فهم الذات والعالم أو الذات ضمن الطبيعة. هذا ما يعيدنا لإثارة إشكالية المجتمع العربي، الذي يرى نفسه خير أمة أخرجت للناس، لكن أهذا ينطبق حاليا على الواقع الراهن ـ بعيدا عن نظريات التآمر والتصهين والتأمرك ؟ هل سينفك الإشكال إذا تمت إعادة رسم رؤية للذات العربية كمجتمع تتوافق (هذه الرؤية) مع مسؤوليات الوضع السياسي الاقتصادي القائم : بدل جر مشاكل قَبَلية تعاد للطرح منذ زمن علي ابن أبي طالب.
بذكر النازية وإعلائها من قيمة الجنس الآري وتفوق الإنسان الألماني، تتم العودة لنيتشه على اعتبار أنه ممهد هذه الأفكار، لكن عند نيتشه نجد نقدا لاذعا ليس فقط للعرق الألماني بل لكل ما هو ألماني ثقافيا وسياسيا ولغويا وفكريا.. ونقده هنا راجع إلى تحسره على المنظومة القيمية الألمانية التي بددت القيم الجديدة للنهضة والرؤى الحياتية المستقبلية حفاظا على قيم الانحطاط الكنسية، بالارتكاز على الصياغات الواهمة للقومية والتفوق الاجتماعي. هذه النقطة من جهة أخرى يعرّفها جوزيف كامل باعتبارها المسوغ اللامنطقي للفرد الذي يعتبر نفسه ظاهرة استثنائية بالعالم ـ كحماية للذات من الواقع الملتبس ـ معتبرا سلوكاته كلها تمثيلا للخير، ومبررا لها أيضا من منطلق نفس المفهوم، مهما بلغت درجتها (السلوكات) من العنف - مثلما يحدث مع الجماعات الأصولية. فالمسوّغ الذاتي هنا يصبح معيقا ليس فقط لرؤية الذات ـ بمفهوم كامبل ـ بل عن فهم الذات والعالم أو الذات ضمن الطبيعة. هذا ما يعيدنا لإثارة إشكالية المجتمع العربي، الذي يرى نفسه خير أمة أخرجت للناس، لكن أهذا ينطبق حاليا على الواقع الراهن ـ بعيدا عن نظريات التآمر والتصهين والتأمرك ؟ هل سينفك الإشكال إذا تمت إعادة رسم رؤية للذات العربية كمجتمع تتوافق (هذه الرؤية) مع مسؤوليات الوضع السياسي الاقتصادي القائم : بدل جر مشاكل قَبَلية تعاد للطرح منذ زمن علي ابن أبي طالب.
نظرة حول الحقيقة ـ عبد الحليم مستور
 يشكل مفهوم الحقيقة، أهم وأبرز المفاهيم الفلسفية التي شغلت تفكير الفلاسفة والمفكرين، بمختلف تياراتهم، واتجاهاتهم الفكرية، مما جعل منها مطلبا إنسانيا، فالكل يبحث عن الحقيقة والكل يسعى للوصول إليها. كما تعتبر الحقيقة غاية كل بحث إنساني، الأمر الذي يجعل منها مفتاح جميع المشاكل الفلسفية. وهذا ما يفرض علينا ضرورة التأصيل والتقعيد لذات المفهوم، سواء انطلاقا من تاريخ الفلسفة، أو عن طريق تبيان دلالات ومعاني المفهوم اعتمادا على تصورات وآراء الفلاسفة أنفسهم مما يجعلنا نطرح تساؤلا مركزيا هو : هل باستطاعة الفكر الإنساني أن يحصل على معرفة حقيقة ؟ وإذا أمكن ذلك، فما طبيعة هذه المعرفة ؟ هل ترقى لأن تكون مطلقة أم أنها لا تعدو أن تكون مجرد معرفة نسبية؟ ما هي أفضل الطرق المؤدية إلى الحقيقة هل العقل أم الواقع أم هما معا؟ وهل يمكن الاعتماد على الرأي لبلوغ الحقيقة أم أنها عائق أمام تحقيقيها؟ وهل الحقيقة ذاتية أم موضوعية ؟ وما قيمة الحقيقة ؟
يشكل مفهوم الحقيقة، أهم وأبرز المفاهيم الفلسفية التي شغلت تفكير الفلاسفة والمفكرين، بمختلف تياراتهم، واتجاهاتهم الفكرية، مما جعل منها مطلبا إنسانيا، فالكل يبحث عن الحقيقة والكل يسعى للوصول إليها. كما تعتبر الحقيقة غاية كل بحث إنساني، الأمر الذي يجعل منها مفتاح جميع المشاكل الفلسفية. وهذا ما يفرض علينا ضرورة التأصيل والتقعيد لذات المفهوم، سواء انطلاقا من تاريخ الفلسفة، أو عن طريق تبيان دلالات ومعاني المفهوم اعتمادا على تصورات وآراء الفلاسفة أنفسهم مما يجعلنا نطرح تساؤلا مركزيا هو : هل باستطاعة الفكر الإنساني أن يحصل على معرفة حقيقة ؟ وإذا أمكن ذلك، فما طبيعة هذه المعرفة ؟ هل ترقى لأن تكون مطلقة أم أنها لا تعدو أن تكون مجرد معرفة نسبية؟ ما هي أفضل الطرق المؤدية إلى الحقيقة هل العقل أم الواقع أم هما معا؟ وهل يمكن الاعتماد على الرأي لبلوغ الحقيقة أم أنها عائق أمام تحقيقيها؟ وهل الحقيقة ذاتية أم موضوعية ؟ وما قيمة الحقيقة ؟
إذن هذه هي التساؤلات الرئيسية التي تدور حولها مشكلة الحقيقة. وقبل معالجتها من خلال ما سنستعرضه من مواقف وآراء نحاول أولا تحديد معنى الحقيقة.











