 من الممكن تقسيم المصلحة تقسيمات متعددة من حيث اعتبار الشرع لها ، ومن حيث درجة قوتها ، ومن حيث ثباتها أو تحولها...
من الممكن تقسيم المصلحة تقسيمات متعددة من حيث اعتبار الشرع لها ، ومن حيث درجة قوتها ، ومن حيث ثباتها أو تحولها...
1 - اعتبار الشرع
فمن حيث اعتبار الشرع ، فهي إما مصالح معتبرة أو ملغاة ، فالمعتبرة هي ما صرحت باعتماده النصوص الشرعية كأصول الحلال والحرام المفضية إلى مصالح العدل والإحسان ، وصحة العقول والأبدان ، وسلامة الأسر ، واليسر والسماحة ، والقوة والأمانة ، والعدل والبذل ...والملغاة هي ما قد يظهر من مصالح مادية أو معنوية جزئية ملتبسة بمضار أكبر منها وأعم ، مثل المصالح المترتبة عن الاتجار في الخمر أو التعامل بالميسر ، فالنص يسقط اعتبارها : (ويسألونك عن الخمر والميسر ، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس ، وإثمهما أكبر من نفعهما ) أو مصالح التعامل بالربا فهي مقرونة بالتشنيع الشديد ( يمحق الله الربا ويربي الصدقات ) أو مصالح تقتضيها مجاوزة حدود رد العدوان المفروض بغرض الانتقام و " التأديب وإشفاء الغليل " ( وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا ) ، فتلك مصالح ثابتة حظرها الشرع واستنكرها الطبع ، لا لذاتها بل بما لابسها من مضار أفسدتها وأخرجتها عن طبيعتها .
مقصد المقاصد طلب المصلحة ـ د. مخلص السبتي
 المصلحة هي كل قول أو فعل جلب منفعة أو جنب مضرة ، وهي نقيض الفساد ، وقد يعبر عنها بالنفع المقابل للضر ، وبالخير المقابل للشر ، وبالبر المقابل للإثم ، وبالرحمة المقابلة للغلظة ، وبالطيبات المقابلة للخبائث [1].،...كل تلك ألفاظ كلية قد ينوب بعضها عن بعض في الدلالة عن المقصد العام لورود الشرع ، وقد اعتبر الكثير من الأصوليين والفقهاء " المصلحة " مدار التشريع والغاية من وراء تقرير الأحكام [2] ، إلى الحد الذي جعلهم يبتكرون أصل "المصالح المرسلة " ويجعلونه حاكما لجميع ما لم يرد فيه نص ، فكانوا إذا استجدت بين أيديهم الحوادث ولم يجدوا لها جوابا من أصولهم المعتمدة انطلقوا ينظرون في المصلحة المجردة معتبرين هذا النظر تطبيقا لروح الشريعة ومقاصدها العليا .
المصلحة هي كل قول أو فعل جلب منفعة أو جنب مضرة ، وهي نقيض الفساد ، وقد يعبر عنها بالنفع المقابل للضر ، وبالخير المقابل للشر ، وبالبر المقابل للإثم ، وبالرحمة المقابلة للغلظة ، وبالطيبات المقابلة للخبائث [1].،...كل تلك ألفاظ كلية قد ينوب بعضها عن بعض في الدلالة عن المقصد العام لورود الشرع ، وقد اعتبر الكثير من الأصوليين والفقهاء " المصلحة " مدار التشريع والغاية من وراء تقرير الأحكام [2] ، إلى الحد الذي جعلهم يبتكرون أصل "المصالح المرسلة " ويجعلونه حاكما لجميع ما لم يرد فيه نص ، فكانوا إذا استجدت بين أيديهم الحوادث ولم يجدوا لها جوابا من أصولهم المعتمدة انطلقوا ينظرون في المصلحة المجردة معتبرين هذا النظر تطبيقا لروح الشريعة ومقاصدها العليا .
اجتهادات الصحابة:
طلب المصلحة هو الذي بنيت عليه أولى اجتهادات الصحابة في القضاء وفي التدبير الاجتماعي والسياسي.....بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم ، فكانوا إذا وجدوها في حكم سبق العمل به في عهده عليه السلام ، كان ذلك هو الأصل وهو المطلوب ، فإن أعياهم ذلك بحثوا عن أقرب التصرفات تحقيقا لها في وقت لم يوجد فيه بعد إجماع ولا قياس ، ومن نماذج ما يذكر العلماء في ذلك :
المسلمون والانسداد التاريخي: لا عاصم اليوم إلا العقل ـ حوار مع المفكر عزالدين عناية ـ أجرى الحوار: الكاتب المهدي مستقيم
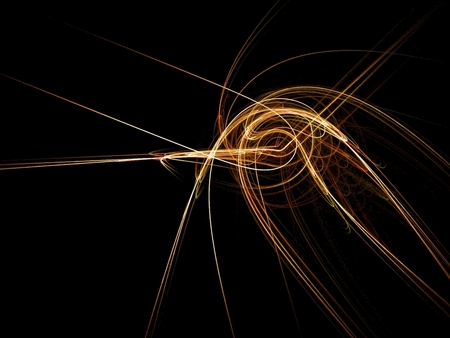 منذ أن دشن الراحل محمد أركون مشروع نقد العقل الإسلامي في سبعينات القرن العشرين وهو يؤكد ويردد بأن الأمر يتعلق بمشروع كبير يحتاج إلى فتح عدة أوراش من أجل مباشرة عمليات الحفر والتنقيب في تلك الطبقات المتراكمة عبر عصور طويلة من تاريخ العرب والمسلمين. ورغم إدراكه لصعوبة المشروع فقد كان مقتنعا بأنه سيأتي الوقت الذي سينهض المثقفون العرب والمسلمون للقيام بهذه المهمة، فذلك هو السبيل الوحيد للخروج من مرحلة الانسداد التاريخي التي تعيشها الشعوب العربية الإسلامية في العصور الحالية.
منذ أن دشن الراحل محمد أركون مشروع نقد العقل الإسلامي في سبعينات القرن العشرين وهو يؤكد ويردد بأن الأمر يتعلق بمشروع كبير يحتاج إلى فتح عدة أوراش من أجل مباشرة عمليات الحفر والتنقيب في تلك الطبقات المتراكمة عبر عصور طويلة من تاريخ العرب والمسلمين. ورغم إدراكه لصعوبة المشروع فقد كان مقتنعا بأنه سيأتي الوقت الذي سينهض المثقفون العرب والمسلمون للقيام بهذه المهمة، فذلك هو السبيل الوحيد للخروج من مرحلة الانسداد التاريخي التي تعيشها الشعوب العربية الإسلامية في العصور الحالية.
وبالفعل ظهر جيل من الباحثين والمفكرين أخذوا على عاتقهم حمل المشعل والمضي في الطريق من أجل تحقيق الهدف. الأمر يتعلق بمجموعة من الباحثين تخرجوا من جامعة الزيتونة وعزموا على التخصص في الفلسفة و التاريخ وسوسيولوجيا الأديان من بينهم الأساتذة: عدنان المقراني وحسن سعيد جالو وعامر الحافي ومحسن العوني وعز الدين عناية، لكنهم وجدوا أنفسهم محاصرين ومحرومين –كما توقع ذلك أركون- من الدعم الكافي لممارسة عملهم بل أكثر من ذلك حرموا من الحصول على وظيفة تمكنهم من الإستمرار في العيش فكان أن غادروا البلد ولجأوا إلى بلدان مختلفة .
وهذا الحوار سنخصصه لباحث من هؤلاء هاجر إلى الديار الإيطالية وحصل على الجنسية الإيطالية وأصبح مدرسا في جامعة روما لاسابيينسا. ألا وهو الدكتور عز الدين عناية.
في الحاجة إلى الإصلاح الديني ـ اسماعيل فائز
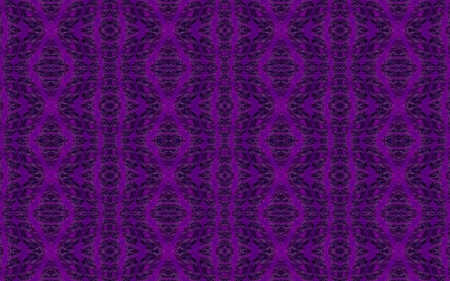 هل يمكن لثورات سياسية، في مجتمعاتنا الإسلامية، أن تنجح في اجتثات الإستبداد، وجني ثمار الحرية ما لم تتهيأ لها الأرضية الفكرية والثقافية؟ أليس المطلوب، بداية، الإسهام في تحرر العقل والمخيال الإسلامي من أغلال التراث، وقيود الآبائية؟ وكيف السبيل إلى تحقيق ذلك؟ ألا تبدأ كل ثورة بثورة ثقافية وفكرية هي من قبيل إعادة إنتاج الإستبداد في صورة مغايرة ربما (ولنستحضر هنا الثورة الإيرانية التي أسقطت استبداد الشاه، وصنعت استبداد "ولاية الفقيه")؟
هل يمكن لثورات سياسية، في مجتمعاتنا الإسلامية، أن تنجح في اجتثات الإستبداد، وجني ثمار الحرية ما لم تتهيأ لها الأرضية الفكرية والثقافية؟ أليس المطلوب، بداية، الإسهام في تحرر العقل والمخيال الإسلامي من أغلال التراث، وقيود الآبائية؟ وكيف السبيل إلى تحقيق ذلك؟ ألا تبدأ كل ثورة بثورة ثقافية وفكرية هي من قبيل إعادة إنتاج الإستبداد في صورة مغايرة ربما (ولنستحضر هنا الثورة الإيرانية التي أسقطت استبداد الشاه، وصنعت استبداد "ولاية الفقيه")؟
ليس القصد في هذه المساهمة، المتواضعة، تقديم إجابات نهائية لهذه الأسئلة العويصة، بقدر ما أن الهدف هو إثارة الإنتباه إليها. وإذ نتحدث عن التراث فإننا لا نقف منه موقف الرفض المسبق، ولا التمجيد الأعمى. بقدر ما نروم التأكيد على ضرورة بناء منظور نقدي اتجاه تراثنا الإسلامي.
فالملاحظ أنه بدل أن نستلهم التراث في بناء الحاضر والمستقبل، تجدنا "معتقلين" داخله. وبدل أن نؤرخ للماضي لننفلت منه تجدنا نسكن فيه (في ممارساتنا وخطاباتنا)، وصرنا نحن الأحياء أمواتا نجتر ما أنتجوه دون نقد. بل إن ننا نعتبر كل سعي للإبداع "بدعة"، و"البدعة ضلالة" و"الضلالة في النار". وباسم هذه اللازمة قتلنا أنفسنا ليعيشوا هم. واعتقلنا العقل في سجن الموروث. لقد صرنا عبدة لما وجدنا عليه آباءنا وأسلافنا. هكذا تمكن منا مرض الآبائية.
صورة الفلاحة في التراث الإسلامي ـ رشيد يلمولي
 يوصف التراث بأنه من المرجعيات الأساس في بناء التصورات و الآراء الخاصة بالثقافة و المجال الحضاري الإسلامي ، و آلية لمعرفة البنية الذهنية و معرفة خصوصياتها " الابستمية " ، عبرها نستطيع أن نعرف مستويات القول و أطره ، فلسفته و قوانينه ، و المرتكزات الناظمة لنسقه و القادرة على تشكيل أنواع الوعي به .
يوصف التراث بأنه من المرجعيات الأساس في بناء التصورات و الآراء الخاصة بالثقافة و المجال الحضاري الإسلامي ، و آلية لمعرفة البنية الذهنية و معرفة خصوصياتها " الابستمية " ، عبرها نستطيع أن نعرف مستويات القول و أطره ، فلسفته و قوانينه ، و المرتكزات الناظمة لنسقه و القادرة على تشكيل أنواع الوعي به .
تتوقف هذه المعرفة على تحديد إطاره المرجعي و أفقه ، و هذه الفلسفة مرهونة بتحقيق التراث الذي لا يمتد إلى التراث ليلغيه ، و لكن ليستمر في روحه ما دام أن تحقيقه لا يتم إلا بعد إلغائه ؛ أي تمثله في جوانبه و امتداداته تحليلا و نقدا ، و يتأتى ذلك بعد قتل التراث فهما و استيعابا .
غير أن التراث لا يقدم نفسه وفق صورة موضوعية " خالصة " ، إذ أن البحث فيه يصطدم بما سماه الأستاذ محمد جسوس بالعائق التراثي ، وهو إعاقة البحث و " منعه " من تكوين و تأسيس معرفة موضوعية ، تصل في بعض الأحيان إلى حد المفارقة و التباين ، لعل موضوع الفلاحة أحد مظاهرها المعبرة ؛ لذلك ما طبيعة الصورة التي يقدمها التراث عن الفلاحة ؟ و كيف يمكن تفسير هذه الصورة ؟
يفيد الفلح في اللغة الشق ، الفلح مصدره فلحت الأرض إذا شققتها للزراعة ، و فلح الأرض للزراعة فلحا إذا شقها للحرث ، و الفلح هو الشق و القطع ، فلح رأسه فلحا إذا شقه [1] .
نحو نقد جذري للفقه : رسالة الى بنيتي ـ محمد منير الحجوجي
 بنيتي، لنبدأ من أول الحكاية.. القرآن قال: "سيروا في الأرض" ولم يقل "سيروا في القرآن".. القرآن يدعو بشكل لا لبس فيه إلى "الخروج" من دوائره و السير بعيدا.. يعترف القرآن بشكل يكاد يكون مفجرا بمحدوديته أمام الأرض/الحياة.. يقر بأن اللغة الأساسية هي الأرض و ليس القرآن.. القرآن دعوة فادحة للخروج نحو الخلق: نحو سرعة الضوء و الجاذبية و اشتغال الخلية و تمفصلات العلاقات البشرية و... رهان القرآن هو الارض، و ليس ذاته- كما توحي بذلك التأويلات/الهلوسات الرسمية.. وهذه في اعتقادي هي حداثته الجذرية..
بنيتي، لنبدأ من أول الحكاية.. القرآن قال: "سيروا في الأرض" ولم يقل "سيروا في القرآن".. القرآن يدعو بشكل لا لبس فيه إلى "الخروج" من دوائره و السير بعيدا.. يعترف القرآن بشكل يكاد يكون مفجرا بمحدوديته أمام الأرض/الحياة.. يقر بأن اللغة الأساسية هي الأرض و ليس القرآن.. القرآن دعوة فادحة للخروج نحو الخلق: نحو سرعة الضوء و الجاذبية و اشتغال الخلية و تمفصلات العلاقات البشرية و... رهان القرآن هو الارض، و ليس ذاته- كما توحي بذلك التأويلات/الهلوسات الرسمية.. وهذه في اعتقادي هي حداثته الجذرية..
يجب أن نفهم جيدا الانقلاب الهائل الذي حصر في قلب الابستمولوجيا الدينية.. عندما جاءت العصابة القريشية الى الحكم مع معاوية، كان أول شيء كان لابد أن تقوم به هو تصفية عدوها الاستراتيجي: الدين المحمدي الثوري الاول.. سارت نحو بناء دين أخر على هامش الدين الاول.. أو في قلبه.. أو فوقه.. لايهم.. نجح الدين الذي تم بناؤه - دين امارة المؤمنين، و "اطيعوا أولي الامر منكم.."، و " تجنبوا التهلكة"، و" قل لن يصيبنا الا ما كتبه الله لنا"، و "تارك الصلاة الى جهنم"......- في نفي/اعدام دين التداولات و العمل و الانتاج و الحرب على التراكم و البذخ.. ان الدين الحالي هو بحذافيره الدين الاموي..
راهب الأنديز: سحر التحليق لطائر الكندور ـ عبد الحميد العلاقي
 ظلّ الطير باختلاف أجناسه وفصائله كائنا يعزّز حيرة الانسان منذ بدء الخليقة وإلى تخوم الأزمنة الحاضرة، وعُدّ طرفا ألحق به الانسان في العقائد القديمة شتى معاني التخييل وأضفت عليه الحضارات البائدة معاني القداسة خشية وطمعا. و للساحل الغربي لجنوب القارة الأمريكية قدّيسه الطائر الذي احتفت به الحضارات البشرية المتعاقبة على تلك الأرض إنّه الكندور الأنديزي المكتسب للتكريم الطقوسي لا من خلال عظمة حجمه ووزنه باعتباره ثاني أكبر طائر في العالم فحسب ولكن كذلك من خلال أسلوبه المدهش في التحليق عاليا، ولعلّ الاعتبار الثاني هو الأكثر وجاهة في التأكيد على هيبة هذا الكائن وسحره لونا وهيئة وعلوّا، فعندما يُفرد طائر الكندور جناحيه في تحليق مهيب فوق أعالي جبال الأنديز في أمريكا الجنوبية يمنح من يشاهده شعورا بالجلال والعظمة، تحليق صامت يترك فيه الطائر جناحيه الكبيرين بطول يجاوز الأمتار الثلاثة مبسوطين دون رفة واحدة لمدة طويلة قد تتجاوز نصف الساعة مسلما نفسه إلى التيارات الهوائية القادمة من المحيط لتحمل وزنا يبدو ثقيلا لصنف من الطيور فقد يصل وزن الطائر البالغ عشر كيلوغرامات، ويُعَدُّ الكندور بسواده الباهر ملهم الحضارات القديمة في جنوب القارة الأمريكية وشمالها فحضارة الأنكا عدّته من الطيور المقدسة. يسكن الكندور أعالي الأنديز بين الفجوات الصخرية للقمم الجبلية كراهب مكلّل بالوحدة والسواد وككائن فرداني منقطع عن عوالم الضجّة، ويكتفي عند التحليق بقذف نفسه في الفراغ المرتفع محدثا بانبساط جناحيه توازنا مثاليا في الطيران بينه وبين الرياح العاتية التي تهبّ بشكل دائم على السواحل الشرقية للمحيط الهادي.
ظلّ الطير باختلاف أجناسه وفصائله كائنا يعزّز حيرة الانسان منذ بدء الخليقة وإلى تخوم الأزمنة الحاضرة، وعُدّ طرفا ألحق به الانسان في العقائد القديمة شتى معاني التخييل وأضفت عليه الحضارات البائدة معاني القداسة خشية وطمعا. و للساحل الغربي لجنوب القارة الأمريكية قدّيسه الطائر الذي احتفت به الحضارات البشرية المتعاقبة على تلك الأرض إنّه الكندور الأنديزي المكتسب للتكريم الطقوسي لا من خلال عظمة حجمه ووزنه باعتباره ثاني أكبر طائر في العالم فحسب ولكن كذلك من خلال أسلوبه المدهش في التحليق عاليا، ولعلّ الاعتبار الثاني هو الأكثر وجاهة في التأكيد على هيبة هذا الكائن وسحره لونا وهيئة وعلوّا، فعندما يُفرد طائر الكندور جناحيه في تحليق مهيب فوق أعالي جبال الأنديز في أمريكا الجنوبية يمنح من يشاهده شعورا بالجلال والعظمة، تحليق صامت يترك فيه الطائر جناحيه الكبيرين بطول يجاوز الأمتار الثلاثة مبسوطين دون رفة واحدة لمدة طويلة قد تتجاوز نصف الساعة مسلما نفسه إلى التيارات الهوائية القادمة من المحيط لتحمل وزنا يبدو ثقيلا لصنف من الطيور فقد يصل وزن الطائر البالغ عشر كيلوغرامات، ويُعَدُّ الكندور بسواده الباهر ملهم الحضارات القديمة في جنوب القارة الأمريكية وشمالها فحضارة الأنكا عدّته من الطيور المقدسة. يسكن الكندور أعالي الأنديز بين الفجوات الصخرية للقمم الجبلية كراهب مكلّل بالوحدة والسواد وككائن فرداني منقطع عن عوالم الضجّة، ويكتفي عند التحليق بقذف نفسه في الفراغ المرتفع محدثا بانبساط جناحيه توازنا مثاليا في الطيران بينه وبين الرياح العاتية التي تهبّ بشكل دائم على السواحل الشرقية للمحيط الهادي.
خلف ستائر النبي محمد... ـ هادي معزوز
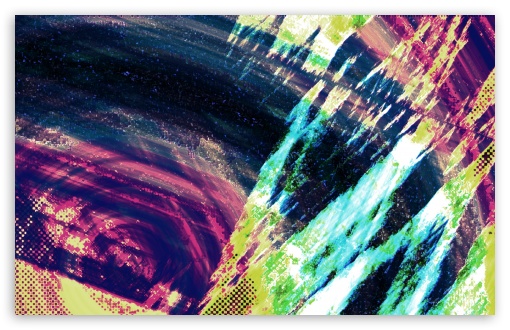 سنحاول في هذا القول العودة إلى زمن غابر جدا، محاولين قراءته وتمحيصه والتحقق منه، انطلاقا من آليات وأدوات معاصرة تتقن قراءة النص كما الرواية بمنهج علمي محض وليس بمنطق تصديقي ساذج، والحال أن الغرض من ذلك ليس ينم إلا على ضرورة قراءة الدين الإسلامي من كواليسه وليس مما يروى وإن كان جله يفقد الوضوح والعلمية لصالح الإيمان بالخوارق، أي أننا سنلفي أنفسنا أمام تاريخين أو قل قراءتين، واحدة رسمية وأخرى محايدة، الأولى تستمد سلطتها من الفهم المبسط للنص الديني ـ القرآن ـ أو السنة ـ أحاديث النبي ـ أو التاريخ المروي ـ سيرة النبي ـ، أما الثانية فإنها تعود إلى كل النصوص محاولة قراءتها على ضوء التاريخ والإنسان والظروف الإبستيمولوجية التي كانت تحكم الذهنية العربية آنذاك، وبما أن النبي محمد ينزل من هذا الأمر منزلة المركز من الدائرة، فإننا سنعمل على ربط حوار ومرحلته التي عرفت كل شيء، من بناء للدعوة في شقيها السري والعلني، وصولا إلى ظروف وفاته الغامضة وما تلاها من صراعات حول الحكم، مرورا بالهزائم، والانتصارات، والدسائس، والأكاذيب، واستغلال الدين خدمة للسياسة... من ثمة لن نقف أمام ستائر النبي حيث الظاهر الزائف المزيف، وإنما سندخل إلى ما وراء هاته الستائر، مزيلين طابع القداسة على شخصية تمكنت من الجمع بين ما هو سياسي وديني واقتصادي وعسكري... وبصمت لنفسها مكانة لازالت لحد الساعة تؤثر على ملايير البشر.
سنحاول في هذا القول العودة إلى زمن غابر جدا، محاولين قراءته وتمحيصه والتحقق منه، انطلاقا من آليات وأدوات معاصرة تتقن قراءة النص كما الرواية بمنهج علمي محض وليس بمنطق تصديقي ساذج، والحال أن الغرض من ذلك ليس ينم إلا على ضرورة قراءة الدين الإسلامي من كواليسه وليس مما يروى وإن كان جله يفقد الوضوح والعلمية لصالح الإيمان بالخوارق، أي أننا سنلفي أنفسنا أمام تاريخين أو قل قراءتين، واحدة رسمية وأخرى محايدة، الأولى تستمد سلطتها من الفهم المبسط للنص الديني ـ القرآن ـ أو السنة ـ أحاديث النبي ـ أو التاريخ المروي ـ سيرة النبي ـ، أما الثانية فإنها تعود إلى كل النصوص محاولة قراءتها على ضوء التاريخ والإنسان والظروف الإبستيمولوجية التي كانت تحكم الذهنية العربية آنذاك، وبما أن النبي محمد ينزل من هذا الأمر منزلة المركز من الدائرة، فإننا سنعمل على ربط حوار ومرحلته التي عرفت كل شيء، من بناء للدعوة في شقيها السري والعلني، وصولا إلى ظروف وفاته الغامضة وما تلاها من صراعات حول الحكم، مرورا بالهزائم، والانتصارات، والدسائس، والأكاذيب، واستغلال الدين خدمة للسياسة... من ثمة لن نقف أمام ستائر النبي حيث الظاهر الزائف المزيف، وإنما سندخل إلى ما وراء هاته الستائر، مزيلين طابع القداسة على شخصية تمكنت من الجمع بين ما هو سياسي وديني واقتصادي وعسكري... وبصمت لنفسها مكانة لازالت لحد الساعة تؤثر على ملايير البشر.
لقد تميزت جل الحضارات القديمة بمرض غريب اسمه النبوة حيث وسم كعنوان مميز لكل قوم، حتى إنه من الصعب تقديم رقم دقيق لعدد الأنبياء الذين عرفهم العالم والذين يتجاوزون الثلاثمائة نبي، "إن جوهر النبي يقوم على تشبع روحه من فكرة دينية ما، تسيطر عليه أخيرا، فيتراءى له أنه مدفوع بقوة إلهية ليبلَّغ من حوله من الناس تلك الفكرة على أنها حقيقة آتية من الله."(1) بيد أن التاريخ وإن كان يذكرهم فإنه يركز على أنبياء ديانات الوحي، وهم إبراهيم وموسى وعيسى ثم أخيرا محمد، هذا وإذا كان هناك شبه تقارب بين النبيين موسى وعيسى، فإن نبي العرب محمد قد شكل بحق استثناءً، وإن " اعتمد على هذين الدينين إلى درجة أنه ناذرا ما توجد فكرة دينية في القرآن ليست مأخوذة عنهما."(2) والحال أن دراسات عدة حاولت أن تقرأ حياة النبي، أقرت بذلك معتبرة إياه ظاهرة نفسية وتاريخية محضة، "لهذا اعتقد بأن الله اختاره هو، النبي العربي، ليقرأ نص الوحي القديم مرة أخرى على الألواح السماوية، وحالما تأكد من أن رسالته إلهية أوعز بتدوين الوحي، كما أتاه."(3) فما الذي وجد ويوجد يا ترى خلف ستائر النبي محمد؟











