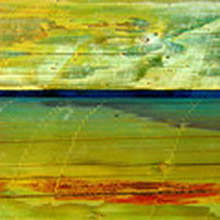 منذ تجليات مرحلة محمد علي باشا في مصر، وعودة رفاعة رافع الطهطاوي من باريس في وقت لاحق، يحيا العالم العربي في ظل شعور قوي بأن هذا هو عصر النهضة العربية، أو مرحلة اليقظة العربية/الإسلامية. لقد بقي هذا الشعور مذاك سائداً لا يقبل النقاش لأسباب عدة، منها ما هو متصل بما سبق في الحياة السياسية والثقافية، ومنها ما هو متصل بما تمخض عنه التالي من الأعوام من نتاجات فكرية وتطورات سياسية قادت نحو تغيرات جذرية نحيا اليوم بعضاً من آثارها المتأخرة. ولكن، ألم يأتِ الوقت المناسب الذي يسمح لنا، ابناءً لما جاءت به النهضة العربية، أن نتساءل: هل نحيا عصراً حقيقياً للنهضة، أم إنه عصر لا يختلف عما سبقه من العصور المظلمة التي نقلل من شأنها متخذين من تغزل أحد شعرائها بـ"مخدة" أو بإبريق شاي دليلاً على التردي والنكوص الذي كان يحياه العقل العربي في ذلك العصر المظلم.
منذ تجليات مرحلة محمد علي باشا في مصر، وعودة رفاعة رافع الطهطاوي من باريس في وقت لاحق، يحيا العالم العربي في ظل شعور قوي بأن هذا هو عصر النهضة العربية، أو مرحلة اليقظة العربية/الإسلامية. لقد بقي هذا الشعور مذاك سائداً لا يقبل النقاش لأسباب عدة، منها ما هو متصل بما سبق في الحياة السياسية والثقافية، ومنها ما هو متصل بما تمخض عنه التالي من الأعوام من نتاجات فكرية وتطورات سياسية قادت نحو تغيرات جذرية نحيا اليوم بعضاً من آثارها المتأخرة. ولكن، ألم يأتِ الوقت المناسب الذي يسمح لنا، ابناءً لما جاءت به النهضة العربية، أن نتساءل: هل نحيا عصراً حقيقياً للنهضة، أم إنه عصر لا يختلف عما سبقه من العصور المظلمة التي نقلل من شأنها متخذين من تغزل أحد شعرائها بـ"مخدة" أو بإبريق شاي دليلاً على التردي والنكوص الذي كان يحياه العقل العربي في ذلك العصر المظلم.لقد قدم الطهطاوي، ومن ثم السيد جمال الدين الأفغاني ومريده محمد عبده، عدداً من الأسئلة، كان أهمها هو: لماذا نحن متأخرون أو متخلفون في العالم العربي الإسلامي، مقارنة بالأمم الغربية؟ وقد تمخضت محاولات الإجابة على هذا السؤال حصراً عن الكثير والمضني من الجدل والمناقشات التي ملأت الكتب والمجلات، كما هي الآن تملأ الدنيا ضجيجاً عبر الفضائيات وسواها من وسائل البث الأثيري. لقد كان المبدأ الأول الذي إعتمده "أساطين" النهضة المشار إليهم أعلاه هو إستمكانهم للتراجع والخنوع لهيمنة الإمبراطوريات الأجنبية، العثمانية خاصة، كواحد من أهم مسببات وتجليات العصر المظلم، كما نفضل أن نطلق عليه، ربما بتعسف. لذا دعا هؤلاء المفكرون إلى تحرير الأقطار العربية والإسلامية من الهيمنة العثمانية ومن سيطرة سواها من الإمبراطوريات الأجنبية، فعد الإستقلال السياسي شرطاً مسبقاً لأنطلاق نهضة عربية أو عربية إسلامية جديدة تتبلور، ليس فقط في التحرر من ربقة الإمبراطوريات، ولكن كذلك فيما سيقدمه العقل العربي الإسلامي من منجزات إبداعية ومبتكرة تذكرنا بالعصر الذهبي لحضارتنا على سنوات الدولة العباسية.



 د. مصدّق الجليدي
د. مصدّق الجليدي ينظر الكاثوليك إلى كنيستهم بصفتها تجلّيا لوحي الربّ على أرضه، تسعى لتثبيت سلطانها في الأرواح، ويغلب نعتهم لها بالدين بدل المذهب، ويراها غيرهم مؤسسة عالمية للمقدّس، تتطلّع جنب السلطات الزمنية للفوز بمغانم للمؤمنين بها. ويخبر واقع الحال أنها مؤسّسة مركّبة، قائمة على شرْعة فيها من التميّز والتماثل مع غيرها من شتى الملل والنحل، تشكّلت قداستها عبر الدهور، ضمّت بداخلها مكونات عدة. يبلغ عدد الحركات المنضوية تحتها والتي تحوز اعترافها في الوقت الراهن 120، إضافة إلى تجمّعات دينية صغرى، 226 منها رجالية و900 نسائية.
ينظر الكاثوليك إلى كنيستهم بصفتها تجلّيا لوحي الربّ على أرضه، تسعى لتثبيت سلطانها في الأرواح، ويغلب نعتهم لها بالدين بدل المذهب، ويراها غيرهم مؤسسة عالمية للمقدّس، تتطلّع جنب السلطات الزمنية للفوز بمغانم للمؤمنين بها. ويخبر واقع الحال أنها مؤسّسة مركّبة، قائمة على شرْعة فيها من التميّز والتماثل مع غيرها من شتى الملل والنحل، تشكّلت قداستها عبر الدهور، ضمّت بداخلها مكونات عدة. يبلغ عدد الحركات المنضوية تحتها والتي تحوز اعترافها في الوقت الراهن 120، إضافة إلى تجمّعات دينية صغرى، 226 منها رجالية و900 نسائية. تقديم:
تقديم: 1. تقديم
1. تقديم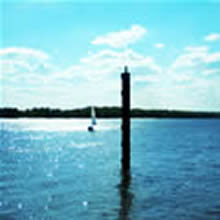 باتت السلفية الشغل الشاغل الآن للباحثين والدارسين والإعلاميين على حد سواء، خاصة لدى الدوائر الغربية ومراكز صناعة القرار بعد هذا الانتشار الذي لقيته والمد الذي تتسع رقعته بمرور الأيام.. وهو نفسه ما دفعني لكتابة هذا الموضوع إضافة إلى ما وجدته من تجافي أو قل (الهوة) بين الإعلاميين والباحثين من جهة وأصحاب ودعاة المنهج السلفي من جهة أخرى حول فهم "السلفية" كمنهج إسلامي.. فهي محاولة لتقريب الأفهام حول هذا التيار الأصولي الآخذ في التمدد، نقف من خلالها على معالم ومحددات المنهج السلفي كما يراه السلفيون.
باتت السلفية الشغل الشاغل الآن للباحثين والدارسين والإعلاميين على حد سواء، خاصة لدى الدوائر الغربية ومراكز صناعة القرار بعد هذا الانتشار الذي لقيته والمد الذي تتسع رقعته بمرور الأيام.. وهو نفسه ما دفعني لكتابة هذا الموضوع إضافة إلى ما وجدته من تجافي أو قل (الهوة) بين الإعلاميين والباحثين من جهة وأصحاب ودعاة المنهج السلفي من جهة أخرى حول فهم "السلفية" كمنهج إسلامي.. فهي محاولة لتقريب الأفهام حول هذا التيار الأصولي الآخذ في التمدد، نقف من خلالها على معالم ومحددات المنهج السلفي كما يراه السلفيون. تجربة الحوار الكاثوليكي مع البلدان المغاربية تجربة متفرّدة، من ناحية تعويل الكنيسة على نتائجها ومقاصدها، ما جعل تلك التجربة واعدة من طرف واحد، من الجانب الكاثوليكي. فالطرف المغاربي، المفتقد لاستراتيجية علمية أو دينية، قد جُرّ جرّا إلى ما يسمّى بالحوار، على مدى أربعة عقود، ولم تنبع المثاقفة من مطلب أكاديمي أو استعداد مؤسّساتي له، بل كان استجابة للمواكبة والمجاراة. كان أوج تلك المثاقفة بتأسيس مجلة "إسلاموكريستيانا" المسماة بـ"إسلاميات مسيحيات" سنة 1975، بإشراف وتسيير لاهوتيين من الآباء البيض، حشِد لها رهط من الجامعيين من تونس بالخصوص، بغرض صنع وعي ديني ليّن وطيّع. غير أن الآباء البيض، الذين ارتبط منشأهم ودورهم بالكنيسة الاستعمارية، لم يوفّقوا في تجاوز الحوار العُصابي مع الإسلام، عبر ذلك التجمّع، الذي سعوا في تشكيله.
تجربة الحوار الكاثوليكي مع البلدان المغاربية تجربة متفرّدة، من ناحية تعويل الكنيسة على نتائجها ومقاصدها، ما جعل تلك التجربة واعدة من طرف واحد، من الجانب الكاثوليكي. فالطرف المغاربي، المفتقد لاستراتيجية علمية أو دينية، قد جُرّ جرّا إلى ما يسمّى بالحوار، على مدى أربعة عقود، ولم تنبع المثاقفة من مطلب أكاديمي أو استعداد مؤسّساتي له، بل كان استجابة للمواكبة والمجاراة. كان أوج تلك المثاقفة بتأسيس مجلة "إسلاموكريستيانا" المسماة بـ"إسلاميات مسيحيات" سنة 1975، بإشراف وتسيير لاهوتيين من الآباء البيض، حشِد لها رهط من الجامعيين من تونس بالخصوص، بغرض صنع وعي ديني ليّن وطيّع. غير أن الآباء البيض، الذين ارتبط منشأهم ودورهم بالكنيسة الاستعمارية، لم يوفّقوا في تجاوز الحوار العُصابي مع الإسلام، عبر ذلك التجمّع، الذي سعوا في تشكيله. مما لامراء فيه أن اللغة ــ بصفة عامة ــ لها أهمية قصوى في تحديد الهوية للقومية لمجتمع معين من المجتمعات عبر عصور التاريخ . وذلك لما تتميز به من خصائص تشترك في تكوين بنيتها الدلالية والتركيبية كما أن لها علاقة بنيوية مع الفكر . إذ أن الكيفية التي ينطق بها الإنسان ويتواصل مع الآخرين هي تقريبا الكيفية التي بها يفكر. وقد قيل في هذا الصدد إن الأسلوب هو صاحبه .
مما لامراء فيه أن اللغة ــ بصفة عامة ــ لها أهمية قصوى في تحديد الهوية للقومية لمجتمع معين من المجتمعات عبر عصور التاريخ . وذلك لما تتميز به من خصائص تشترك في تكوين بنيتها الدلالية والتركيبية كما أن لها علاقة بنيوية مع الفكر . إذ أن الكيفية التي ينطق بها الإنسان ويتواصل مع الآخرين هي تقريبا الكيفية التي بها يفكر. وقد قيل في هذا الصدد إن الأسلوب هو صاحبه .






