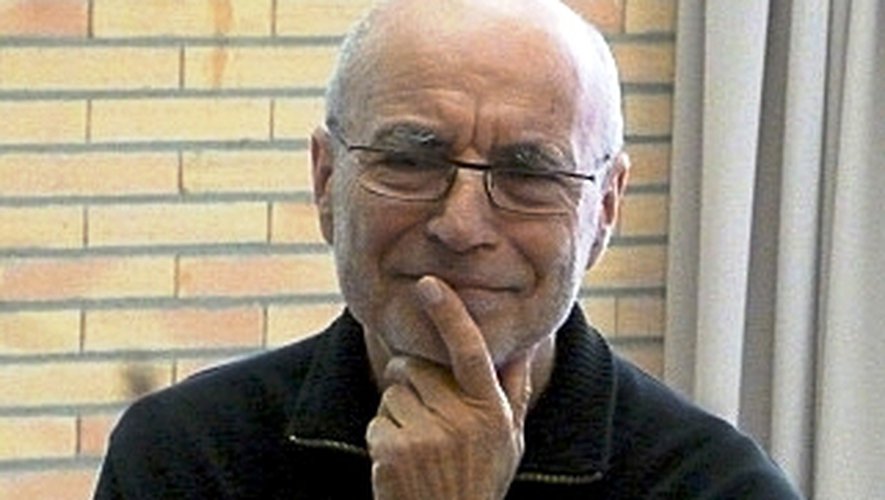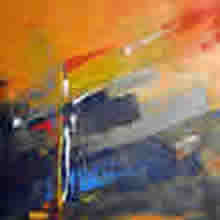 إن أي دراسة للحضارة الغربية لا تأخذ الأبعاد الفكرية والفلسفية التي بُنيت عليها ستكون حتما دراسة قاصرة، وغير ناجعة، لفهم ما آلت إليه هذه الحضارة من تيه وضياع، ومن بين مظاهر هذه الحضارة الآن التطور التكنولوجي المذهل الذي يسابق الزمن، وحصر مفهوم التقدم في الأشياء المادية دون الأخذ بالاعتبار الأبعاد الربانية والإنسانية للإنسان، وكان الأولى أن يكون هذا التطور والتقدم نعمة على الإنسان، وفي خدمته، إلا أن النقمة لاحقت الإنسان، وجعلته يتحسر على الزمن الماضي.. زمن البساطة والسهولة.
إن أي دراسة للحضارة الغربية لا تأخذ الأبعاد الفكرية والفلسفية التي بُنيت عليها ستكون حتما دراسة قاصرة، وغير ناجعة، لفهم ما آلت إليه هذه الحضارة من تيه وضياع، ومن بين مظاهر هذه الحضارة الآن التطور التكنولوجي المذهل الذي يسابق الزمن، وحصر مفهوم التقدم في الأشياء المادية دون الأخذ بالاعتبار الأبعاد الربانية والإنسانية للإنسان، وكان الأولى أن يكون هذا التطور والتقدم نعمة على الإنسان، وفي خدمته، إلا أن النقمة لاحقت الإنسان، وجعلته يتحسر على الزمن الماضي.. زمن البساطة والسهولة.
الحياة في هذا الزمن ( الصعب ) تسير إلى العدم، والكون يتجه إلى الانتحار، وهذا كله نتاج العقل الإنساني العبثي، الذي طلق الوحي الإلهي، وآمن بالعقل، وكل ما يتوصل إليه في حل المشكلات التي تواجه الإنسان في حياته، وجعل أولى أولوياته الربح المادي.. هذا العقل العبثي الذي أعلن موت الإله، هو نفسه الذي قرأ تراتيل النهاية على الإنسان.
موت الإله: المتتبع لتاريخ الفكر الغربي يجده قد مر بالعديد من المراحل، ولعل أبرزها الصراع الكبير بين العقل والدين/ الكنيسة، هذا الصراع لا يرجع إلى اعوجاج في آليات التفكير العقلي فحسب، بل إلى التناقض الفادح بين المبادئ التي تؤمن بها الكنيسة، وتدعو لها، وتطبيقاتها على أرض الواقع.
فتصرفات رجال الكنيسة، وتضييقهم الخناق على العقل، والفكر الحر، وتواطؤهم مع ذوي السلطة والمال، على حساب الطبقات الكادحة، هي التي ولدت الكراهية والامتعاض ضد الدين وتعاليمه، مما أدى بالكثير من الفلاسفة والمفكرين أن يتبنوا أفكارا مناهضة للدين، وقراءات مناقضة للوحي الإلهي، هذه الأفكار والقراءات كانت بمثابة إعلان عن انتصار الإنسان على الإله، وانتصار العقل على الدين، وطلاق الأرض من سلطة السماء..
"فالله قد مات" كما أعلن نيتشه، و"الدين أفيون الشعوب" كما قال ماركس، لهذا لابد للعقل أن يأخذ زمام المبادرة، دون الحاجة إلى تعاليم السماء، حتى ولو أدى ذلك إلى عقد ميثاق مع الشيطان، والتعاون معه من أجل اكتساب العلم والمعرفة كما فعل " فاوست ".
مفهوم موت الإله: لقد أعلن فيلسوف العدمية الشهير فريدريك نيتشه " موت الإله " في كتابه " هكذا تكلم زرداشت " بصرخته المرعبة " يا قوم، لقد ماتت القيم، لقد مات الدين المسيحي في أوروبا، ومات الإله " علما أن الإله الذي يهاجمه نيتشه، ويعلن موته هو غير إلهنا الذي نعبده، وندعوه، ونوقره، وعالم نيتشه الروحي غير عالمنا الروحي الذي نحياه ونعيشه.
والسؤال المطروح لماذا أعلن نيتشه موت الإله؟.
الذات والصفات بين المعتزلة والأشاعرة - زهير الخويلدي*
 المسلمون يقولون بالتوحيد بل إن عنوان دين الإسلام هو لا اله إلا الله ولكن الفلاسفة وعلماء الكلام فلسفوا هذا التوحيد وبحثوه بحثا كلاميا وعمقوه تعميقا جدليا وأضفوا عليه صيغا منطقية ومصطلحات فلسفية وعدد الذين شكوا في وجود الله ووصلوا إلى مرتبة الإلحاد والزندقة يعدون على الأصابع، فمعظمهم ينطلق من أن الله صانع العالم ومبدع الكون ويقيم أنساقا معرفية ومناهج فلسفية كلها تبرهن وتثبت وجود الله لكن إن اتفق المسلمون أن الله تعالى واحد اختلفوا في علاقة ذاته بصفاته وعدد أسمائه الحسنى و قالوا أن كثير من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية تنسب إلى الله العلم والقدرة والإرادة والحياة والكلام فهل هذه الصفات هي أسماء زائدة أم عين الذات؟ بعبارة أخرى هل الأسماء مجرد صفات أم عين للذات الإلهية؟ ثم ما الفرق بين التصور الاعتزالي والتصور الأشعري للذات الإلهية؟ ألم يقع التصور الكلامي برمته في خطأ منهجي هو قياس الغائب الإلهي على الشاهد الإنساني؟
المسلمون يقولون بالتوحيد بل إن عنوان دين الإسلام هو لا اله إلا الله ولكن الفلاسفة وعلماء الكلام فلسفوا هذا التوحيد وبحثوه بحثا كلاميا وعمقوه تعميقا جدليا وأضفوا عليه صيغا منطقية ومصطلحات فلسفية وعدد الذين شكوا في وجود الله ووصلوا إلى مرتبة الإلحاد والزندقة يعدون على الأصابع، فمعظمهم ينطلق من أن الله صانع العالم ومبدع الكون ويقيم أنساقا معرفية ومناهج فلسفية كلها تبرهن وتثبت وجود الله لكن إن اتفق المسلمون أن الله تعالى واحد اختلفوا في علاقة ذاته بصفاته وعدد أسمائه الحسنى و قالوا أن كثير من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية تنسب إلى الله العلم والقدرة والإرادة والحياة والكلام فهل هذه الصفات هي أسماء زائدة أم عين الذات؟ بعبارة أخرى هل الأسماء مجرد صفات أم عين للذات الإلهية؟ ثم ما الفرق بين التصور الاعتزالي والتصور الأشعري للذات الإلهية؟ ألم يقع التصور الكلامي برمته في خطأ منهجي هو قياس الغائب الإلهي على الشاهد الإنساني؟
1- الله عند المعتزلة:
يقصد المعتزلة بعلم التوحيد العلم بأن الله تعالى واحد لا شريك غيره فيما يستحق من الصفات نفيا وإثباتا على الحد الذي يستحقه والإقرار به وهذا الحد الذي يستحقه هو عندهم التنزيه المطلق للذات الإلهية ونفي المثلية عنها بأي وجه من الوجوه وفي إطار هذا التنزيه المطلق نشأت عندهم مباحث متعددة كمبحث الذات والصفات. إن معرفة الذات الإلهية عند المعتزلة واجبة لما تؤدي إليه من الالتزام بحدود الشريعة الذي هو غاية وهدف الدين الإسلامي ولأن المفهوم الاعتزالي للإيمان والذي أساسه العمل يستوجب معرفة الحقيقة الإلهية والاقتناع بها مما يدفع إلى كمال العقل والتشبث بالطاعات العملية ولذلك فان شيوخ الاعتزال وجهوا جهودهم إلى تركيز حقيقة التوحيد في النفوس واستعملوا في ذلك مختلف الأساليب والمعطيات الفلسفية والطبيعية هادفين إلى أن يصل التصديق بهذه الحقيقة إلى مرتبة الدفع إلى العمل وأجمعوا على أن الله واحد ليس كمثله شيء وأنه ليس بجسم طبيعي أو حيواني وأن ذاته ليست مؤلفة من جوهر ذي أعراض تدركها الحواس وأنه منزه عن عوارض المادة وخواصها وأنه بسيط يستحيل عليه التجزؤ ولا يحيط به المكان ولا يجري عليه الزمان ولا تحدده الحدود والنهايات ولا تحيط به الكميات، انه تام الكمال بحيث لا يتصور له شبيها ووجوده أزلي لا شاركه في الأزل أحد،فالله واحد لا شريك له من أي جهة كانت ولا كثرة في ذاته البتة وهو خالق الجسم وليس بجسم ولا في جسم ومحدث الأشياء وليس بمحدث منزه عن كل صفات الحدوث.
بؤس الفكر العربي وحتمية الاستئناف الحضاري - زهير الخويلدي
 "ثمة شيء في الحاضر على غير ما يرام وهذا ليس كما يجب أن يكون"
"ثمة شيء في الحاضر على غير ما يرام وهذا ليس كما يجب أن يكون"
جاك دريدا أطياف ماركس
بقي العالم العربي الإسلامي إلى حد الآن عالما تحكمه رؤية قروسطية متخلفة تتخللها نظرة ماورائية سحرية أسطورية إلى الوجود ومازال المرء ينتمي إلى ما قبل الأزمنة الحديثة يعيش وفق المعايير القديمة ويتصرف بطريقة لا تبعد كثيرا عن ردود أفعال السوائم، كما ظل الفكر جالسا على افتراضات صورية مستخدما حيل لغوية عقيمة وخائضا في مهاترات سفسطائية ونقاشات بيزنطية تحاصره الغيبيات من كل جهة وتهزه المغالطات من الداخل وتسيطر عليه النزعات الدغمائية والكليانية.الفلسفة نفسها التي دشنها الكندي وهذبها الفارابي وابن سينا وطورها ابن رشد وابن خلدون تبدو اليوم بائسة مهجرة إلى غير ديارها غريبة عن أهلها وهذا لا يعود إلى الموقع الذي تحتله بل إلى الوظيفة التي حادت عنها وكذلك يرجع إلى الدور الذي يؤديه السفسطائيون الجدد والمجادلون المتزلفون،فهم إن وجودوا يعيشون في حالة استقالة تامة وغياب فضيعة يجهلون ما يدور خارج قصورهم المعرفية ومفاهيمهم المجردة من استعباد للإنسان واستغلال للطبيعة وتهديد للبيئة ولقيمة الحياة على الأرض ولا يكترثون بصعوبة الحياة اليومية واستفحال الأمراض والبطالة والأمية وسطوة الدعاية والإشهار على العقل والذوق وتنامي مشاعر القلق والضياع،إنهم لم يخرجوا من نظامهم الشمسي ولم يتنحوا عن برجهم العاجي ولم يعزفوا عن وظائف التبرير والتسويغ ليكونوا مرآة عاكسة لمشاكل عصرهم شاهدين عليه وشهداء من أجل إنارة حقيقته.
عندئذ هناك تباعد فظيع بين ما يعلنه الفكر العربي اليوم من وصفات وما يعد به من مشاريع وبين ما يحدث في الواقع المعاش ويصير على الناس من نوائب الدهر وفواجع الزمان وما تظهر من تحديات. إن الثقافة برمتها وليس فقط الفكر متخاذلة ومهزومة والحضارة العالمية بأسرها مخترقة وملوثة بجرعات مسمومة فهجرة الأدمغة إلى الخارج وتخلف البحث العلمي وقلة استثمار الدول العربية في هذا المجال في مقابل الاعتمادات الكبيرة لقطاع الرياضة والفن والسياحة وتناقص عدد العلماء العرب الموسمين والحائزين على شهائد تقدير عالمية فكيف نفسر الغياب الكبير للعلماء العرب والمسلمين عن جوائز عالمية مثل جائزة نوبل؟
ربما سبب هذا الغياب هو العامل الخارجي وتنامي النزعة العنصرية والتمييز والتمركز على الذات التي تعاني منها الثقافة الغربية ولكن التطرق إلى العامل الداخلي مهم في تفسير هذا العجز ذلك أن التجديد صار عند العرب عبورا نحو الوقوع بين براثن التقليد والإصلاح أصبح مطية من أجل التخريب والتفويت ولفظة الثورة اكتفت أن تكون مؤنث ثور هائج ولم تحمل إلينا سوى الانقلابات العسكرية والمشانق والتصفيات ولم تكن مطية نحو بناء المشروع الحضاري المنتظر أو نقطة الوصل مع المستقبل والآخر العالمي.
أرسطو والعلم الطبيعي - أحمد البوسكلاوي
 قراءة في المقالة السابعة من "الطبيعة"
قراءة في المقالة السابعة من "الطبيعة"
ومن مفارقات الزمان، أنه بعد مرور أزيد من عشرين قرنا على موت أرسطو، وهي القرون التي كان فيها للفكر الأرسطي الحضور الأكبر من أي حضور آخر ستظهر في أوروبا نهضة علمية نبعت من جوف الأرسطية وضدها في آن واحد ومستلهمة أفلاطون حسب ادعائها. والمسألة ما زال فيها نظر.
مقدمة:
ذكر روبير واردي R.Wardy في كتاب مشترك تناولت مقالاته، ذكر كيف رأى بعض الباحثين في تاريخ الفكر العلمي الفصل الخامس من المقالة السابعة من كتاب الطبيعة هذا، رأوا فيه عامل الهام لأعمال أرخميدس (+212 ق.م) الميكانيكية، بينما ذهب آخرون إلى أن هذا النص قد أثر حتى في أعمال كل من ليوناردو دافنتشي (+1519) وجاليلي (+1642)(1) هذا دون أن نشير إلى أن هناك من اعتبر أرسطو سواء من خلال هذا الفصل أو الفصل الثامن من المقالة الرابعة من كتاب الطبيعة أو من خلال كتاب "الميكانيكا" المنسوب إليه، اعتبروه رائد الفيزياء النظرية المعتمدة على الصياغة الكمية الرياضية، أو على الأقل أحد الأوائل الذين زرعوا البذور الأولى لهذه الصياغة.
ولقد اندفع بعض مؤيدي هذا الرأي إلى تحرير مقالات وكتب مدافعين عن موقفهم هذا ومحاولين إيجاد أصول لبعض المفاهيم والتصورات والنتائج العلمية الحديثة والمعاصرة في متن أرسطو.
وفي مقابل هؤلاء، تبنى آخرون رأيا مخالفا إذ اعتبروا أرسطو فيلسوفا تأمليا وميتافيزيقيا، وأن فيزياءه ظلت حبيسة تصوره الميتافيزيقي، وأن ما ينسب إليه من أعمال "علمية" لا تعدو أن تكون منحولة ومنسوبة إليه، أو أنها فلتات لسانية أو تعابير فلسفية فضفاضة أسيء تأويلها بعد أن تم اجتثاثها من سياقها النظري. وأكثر من هذا فإن ما يدعى بفيزياء أرسطو ليست سوى تعبير متماسك عن الحس المشترك. ومن أبرز هؤلاء برتراند راسل، كويري، إرنست ماخ وباشلار.
أما في العالم العربي، فقد نشأ، كما هو معروف، تقليد مشائي شرح مؤلفات أرسطو، وبخاصة كتاب "الطبيعة" وحاول ممثلو هذا التقليد تأسيس فيزياء انطلاقا من هذا المؤلف ونخص بالذكر ابن سينا وابن باجة وابن رشد، في الوقت الذي كان قد تأسس تقليد آخر متميز عن المشائين وإن أخذ ببعض العناصر الأرسطية (كالمبدأ الدينامي) ولكنه تقليد يرتبط أكثر بأوقليدس وأرشيمدس وهيرون، ومن أبرز ممثليه ابن قرة والخازني وابن الهيثم.
لقد تعمدت إيراد هذه المعلومات من أجل إبراز الأهمية الكبرى التي منحت للمقالة السابعة من كتاب الطبيعة لأرسطو وبخاصة الفصل الخامس منها في تاريخ الفكر الفيزيائي.
الدرس السياسي للفلسفة : كاستورياديس نموذجا - عبد المجيد السخيري
 بقدر ما يبدو صعبا رصد المسار الفلسفي-السياسي لمفكر من طينة "كورنيليوس كاستورياديس"، المتشعب والمتوغل في ذاكرة قرن فائر بالثورات والاضطرابات العظيمة التي لا يزال وعينا الراهن مشدودا بقوة لنتائجها، بقدر ما أن أصالته وحيويته الفكرية التي تواصلت على مدى نصف قرن تسمح برسم صورة واضحة لذلك المفكر المقاتل، المتعدد/ المتوحد في جبهاته الثلاث: الفلسفة، السياسة والتحليل النفسي. صورة نستعيد من خلالها ملامح مقاتل مقدام، خاض حروبا كثيرة بشجاعة نادرة وكفاحية عالية، إنما أيضا بحكمة بليغة وعميقة تنتصر للحقيقة في وضوح الفكر، ورهان الفعل من موقع سياسي مكشوف: لم توجد الفلسفة لتحايد ولا أن تسلم الأسلحة، لا في زمن الحرب ولا في زمن التسوية.
بقدر ما يبدو صعبا رصد المسار الفلسفي-السياسي لمفكر من طينة "كورنيليوس كاستورياديس"، المتشعب والمتوغل في ذاكرة قرن فائر بالثورات والاضطرابات العظيمة التي لا يزال وعينا الراهن مشدودا بقوة لنتائجها، بقدر ما أن أصالته وحيويته الفكرية التي تواصلت على مدى نصف قرن تسمح برسم صورة واضحة لذلك المفكر المقاتل، المتعدد/ المتوحد في جبهاته الثلاث: الفلسفة، السياسة والتحليل النفسي. صورة نستعيد من خلالها ملامح مقاتل مقدام، خاض حروبا كثيرة بشجاعة نادرة وكفاحية عالية، إنما أيضا بحكمة بليغة وعميقة تنتصر للحقيقة في وضوح الفكر، ورهان الفعل من موقع سياسي مكشوف: لم توجد الفلسفة لتحايد ولا أن تسلم الأسلحة، لا في زمن الحرب ولا في زمن التسوية.
لنتذكر زمن "الاشتراكية أو البربرية"، "لبير Liber"، ماي 68 الفجوة!، ثم أخيرا "ملتقيات المتاهة"؛ مدونة نصوص المقاومة، حيث تتداخل الجبهات الثلاث في فكر مرصع بروح الاختلاف الذي لا يفسد للمقاتل قضية. إنما لا ننسى كذلك "المؤسسة الخيالية للمجتمع"، العمل الأساسي للفيلسوف المفكر والمحلل، حيث ثمة "فلسفة مرصعة بروح كلاسيكية ومهيكلة بشكل قوي".
إن ما يؤشر على أصالة إسهام "كاستورياديس" في تاريخ الفلسفة المعاصرة هو بلا شك ذلك التداخل والتكامل الذي طبع تفكيره ونشاطه في حقول لا تخفى أهميتها ورهاناتها الاستراتيجية في الفكر والحياة المعاصرين: حقول المقاومة/النضال من أجل نيل الاستقلالية؛ كرهان للفكر والسياسة، وأفق لفردانية ديمقراطية ممكنة تؤسس لمواطنة جماعية، إيجابية، فاعلة، متدخلة ويقظة، هي ما يليق بالحياة الديمقراطية. لم يكافح كاستورياديس من أجل تعميم الوعي بهذه الاستقلالية فحسب، بل إنه تمثلها فكرا وسلوكا، من حيث هي إبداع خيالي متميز يفترض على مستوى البعد الاجتماعي-التاريخي للاستقلالية، القدرة على المساءلة (التفكير) اللامحدود للمبادئ. ولذلك فإن اختيار التفكير والعمل على الجبهات الثلاث: الفلسفة، السياسية، والتحليل النفسي، لم يكن سوى لأن الأدوات التي تمنحها إياها هذه الحقول المعرفية، هي ما يتكفل بتعميق مشروع الاستقلالية ذاك، لأجل دفعه نحو تحقق أقصى في المجال العمومي..
الراديكالية السياسية:
كان كاستورياديس في السنوات الأخيرة من حياته يحرص كثيرا على تأكيد حاجة الفكر إلى نوع من الراديكالية كسبيل لإحراز خيال الاستقلالية التي بدونها لا يكون لتدخل المفكر/المثقف في المجال العمومي من جدوى وفاعلية، بل إنه بدونها ليس ثمة فكر. ولذلك سعى فيلسوفنا في البحث عن راديكالية تكون كذلك بالنسبة للفكر، إنما كذلك للسياسة كبديل لما رآه مخرجا ممكنا من بؤس الخيارين الذي حملتهما التجربة الغربية في تاريخها، والتي تواصل اليوم الليبرالية الجديدة التنظير/التأسيس لهما بسخافة لا نظير لها: الليبرالية أو البربرية.
ا
مفهوم التراجيديا عند نيتشه - إدريس جبري
 تقديم:
تقديم:
عندما كان نيتشه يتحدث عن التراجيديا اليونانية، فإنه لم يكن يتحدث عنها بلغة أرسطية واصفة ولا بلغة تاريخية بارطية (نسبة إلى بارط R.Barthes) بل كان يتحدث عنها، بلغة فنان عاشق حتى الموت.
لقد كان نيتشه يداعب التراجيديا اليونانية، كما يداعب امرأة حسناء وبدلال طفولي. كان يغازل ماهيتها بعشق وشغف، ويلامس "جسدها" في انتشار صوفي… لكن، فجأة ما يكشر نيتشه كنسر جارح فيهاجم "طريدته" /الروح العلمية ويحاصرها من كل الجوانب فيهوي بمطرقته على العقل والحكمة ويعبث بالتفاؤل ويحاصره، فيتعالى على المألوف والاستكانة.
إن التراجيديا عند نيتشه، بؤرة الحياة الأبدية وانفتاح لا نهائي نحو الآفاق المجهولة. إن التراجيديا مقاومة للموت، وممارسة للذة في الألم. التراجيديا معانقة للمتعالي.
فعندما نقرأ نيتشه في كتابه "ميلاد التراجيديا" نكون أمام ازدواجية في اللغة مقرونة بازدواجية في الرؤية نفسها. بمعنى أن نيتشه عندما يتحدث عن التراجيديا اليونانية وعن العصر الهلييني، نلمس في لغته همسا شاعريا ونبرة شفافة، فتسري رعشات الانتعاش واللذة في جسد اللغة، ولكن مقابل ذلك حينما ينبري نحو سقراط وأفلاطون أو أوريبيد… نحس بالكلمة تتجهم، وبالعبارة تقسو.
والحق أننا لا نريد الخوض في هذا المجال -أي مجال لغة نيتشه- لأننا لسنا مؤهلين لذلك البتة، بالرغم من أننا سجلنا هذا الانطباع. فكل ما نهدف إليه -واستلهاما لهذا الانطباع- هو محاولة لجمع أشلاء ومكونات التراجيديا عند نيتشه، من خلال كتابه "ميلاد التراجيديا". وهذه الغاية لن تتأتى لنا إلا بهدي من ازدواجية رؤية نيتشه نفسه للتراجيديا عبر ما أسماه: الروح العلمية والروح الديونيزوسية.
وفي إطار هذه الثنائية الكبرى وما تتضمنه من ثنائيات فرعية سنعمل على تشييد وتكوين "مفهوم التراجيديا عند نيتشه".
1 - التراجيديا والروح العلمية:
أ - التراجيديا بين الاحتضار والموت:
يقول نيتشه معرفا الروح العلمية ما يلي:" أفهم أن الروح العلمية اعتقاد ظهر أيام سقراط، وأنه معرفة الطبيعة وحقائقها. كما أن المعرفة تملك في ذاتها فضيلة الخلاص الكوني"(1).
من خلال هذا الكلام يمكن أن نستخلص بعض مقومات الروح العلمية، والمتمثلة في: المعرفة، الحقيقة، الفضيلة، ثم سقراط ذاته. ويعتبر هذا الأخير في نظر نيتشه الممثل الفعلي لهذه الروح العلمية وذلك نظرا لمطابقتها لمبادئ سقراط الثلاثة التالية:
"الفضيلة معرفة، لا نذنب إلا عن جهل، الإنسان الفاضل سعيد(2)".
تعلم التفلسف عند ميشيل طوزي – محسن المحمدي ورشيد أمعاز
إن المغزى العميق لمقولة كانط الشهيرة:" لا يمكننا تعلم الفلسفة، بل يمكننا فقط تعلم التفلسف" هو أن درس الفلسفة بما هو مجال للحرية العقلية المتمثلة في التأمل النقدي، يقوم على التفلسف كعملية عقلية، نقدية، تساؤلية مستمرة. الغرض منها إزالة البداهة عن الأفكار المألوفة والأحكام المسبقة، والتخلص من هيمنة الحقائق المطلقة بإعادة النظر فيها وجعلها تتسم بالنسبية والقابلية للتجاوز. فالتفلسف إذن هو "المسار الذي نقطعه من بادئ الرأي (الدوكسا) إلى المعرفة (الإبستمي)" . كما أنه يعتمد على القدرات والإمكانات الذاتية للتفلسف باعتباره ذاتا مبادرة، فاعلة، منتجة، لها القدرة على التفكير الحر وإبداء الرأي وتحديد مسارها التعلمي وامتلاك سلطة تكوينها.
وهنا يبرز مفهوم التفكير الذاتي كتجسيد للحرية العقلية وللتأمل النقدي فهو يسمح للفرد بالتساؤل عن معنى وقيمة وجوده والمشاكل التي تطرحها حياته الشخصية والتزاماته الفردية والجماعية.
ما فائدة دراسة / تدريس الفلسفة ؟ - عبد الجليل الكور
 «أيُّ فائدةٍ تَجْنِيها من دراسة ﭐلفلسفة، إذا كان كُلُّ ما تقوم به بـﭑلنسبة إليكـ هو أن تَجعلكـ قادرًا على ﭐلتعبيـر بشكلٍ مقبولٍ نِسْبِيًّا عن بعض ﭐلْمسائل ﭐلْمنطقية ﭐلْمُسْتَغْلِقَة، إلَخِ.، وإذا كان هذا لا يُحَسِّن طريقتَكـ فِي ﭐلتفكيـر فِي ﭐلْمسائل ﭐلْهامة للحياة ﭐليومية، وإذا كان ذالكـ لا يَجعلكـ أشدَّ وعـيًا من أيِّ صِحَافِي فِي ﭐستعمالك لتعابيـر خطيـرة يستخدمها أُنَاسٌ من أمثاله لِأَغْرَاضهم ﭐلْخاصة ؟ » لودﭬﻴﮓ ﭬِـتْـﮕِـنْشتيـن (مراسلات)
«أيُّ فائدةٍ تَجْنِيها من دراسة ﭐلفلسفة، إذا كان كُلُّ ما تقوم به بـﭑلنسبة إليكـ هو أن تَجعلكـ قادرًا على ﭐلتعبيـر بشكلٍ مقبولٍ نِسْبِيًّا عن بعض ﭐلْمسائل ﭐلْمنطقية ﭐلْمُسْتَغْلِقَة، إلَخِ.، وإذا كان هذا لا يُحَسِّن طريقتَكـ فِي ﭐلتفكيـر فِي ﭐلْمسائل ﭐلْهامة للحياة ﭐليومية، وإذا كان ذالكـ لا يَجعلكـ أشدَّ وعـيًا من أيِّ صِحَافِي فِي ﭐستعمالك لتعابيـر خطيـرة يستخدمها أُنَاسٌ من أمثاله لِأَغْرَاضهم ﭐلْخاصة ؟ » لودﭬﻴﮓ ﭬِـتْـﮕِـنْشتيـن (مراسلات)
من ﭐلشائع أن "ﭐلفلسفة" لا تقبل ﭐلتعريف، حيث يُنْظَرُ إليها كنوع من ﭐلتجربة ﭐلفردية/ﭐلشخصية/ﭐلذاتية ﭐللَّتِي تستعصي، بطبيعتها، على كل تَحديدٍ موضوعي (=توضيعٌ). ولعل أهم ﭐلصعوبات ﭐلْمتعلقة بـ"ﭐلفلسفة" تَجد بدايتها مع هذا ﭐلِاعتقاد ﭐلسائد بَيْن مُحترفِي "ﭐلفلسفة" أنفسهم، ﭐلذين يَظُنُّ معظمُهم -فِي ﭐلغالب- أن "ﭐلفلسفة" تكتسب مزيدا من ﭐلِامتياز إذا نُظِر إليها وعُرِضَت بِهذا ﭐلصورة. لَكنَّ أيَّ تفكيـرٍ حول "ﭐلفلسفة" لا يُمكن أن يتم من دون إعطاء تعريفٍ لَها، يكون شاملًا وواضحا بِهذا ﭐلقدر أو ذاكـ. لِهذا نَجد أنفسنا، فِي بداية هذا ﭐلْمقال، نستعمل لفظ "ﭐلفلسفة" بـﭑلتعريف ﭐلتالِي : "ﭐلفلسفة" مَجالٌ لِمُمارسةِ نوعٍ من ﭐلتفكيـر ﭐلْمنهجي الذي يتجسد فِي مادةٍ خِطَابِيَّةٍ (هي ﭐللَّتِي تشكل موضوعَ ﭐلدراسة/ﭐلتدريس على مستوى ﭐلتعليم ﭐلثانوي وﭐلْجامعي بعددٍ من بلدان ﭐلعالَم ﭐلْمعاصر)، والذي يَنْصَبُّ على ﭐلْمُشكلات ﭐلأساسية فِي ﭐلوجود ﭐلْإنسانِي ويتميز بأنه تفكيـر عميق وعام ؛ وهو ﭐلتفكيـر الذي يرجع فِي جذوره -على ﭐلْأقل بـﭑلنسبة لبعض ﭐلْأمم- إلَى بضعة قرون قبل ميلاد ﭐلْمسيح. ويترتب على هذا ﭐلتعريف أن "ﭐلفلسفة" تفكيـر عميق يتجاوز ﭐلتفكيـر ﭐلسطحي للإنسان ﭐلعادي ويرمي إلَى ﭐلْإمساكـ بـ"ﭐلْعِلَلِ" ﭐللَّتِي تَـتَحَكَّمُ فِي سَيْرِ ﭐلْأشياء، وتفكيـرٌ عامٌّ يَعْلُو على ما هو جُزئي وفَردي فِي ﭐلوجود ﭐلْإنسانِي بـﭑلنظر فِيما ينطبق على ﭐلْمجموع بِحيث يكونُ كُلِّـيًّا وجَامِعًا (قد لا يكون، فِي ﭐلْواقع، تَحديدُ ﭐلفلسفةِ كفكرٍ عميقٍ وعام سوى ﭐدِّعَاءٍ سرعان ما ينقلب إلَى فكرٍ سطحِيٍّ يقفُ عند ﭐلصُّوَرِ ﭐلذِّهْنِيَّةِ ﭐلْقَبْلِيَّةِ ولا يتجاوز ﭐلتجربةَ ﭐلفرديَّةَ ﭐلْمُتَحَيِّزَةَ زمانيا ومكانيا، وهذه مسألة تستدعي -هي وحدها- وقوفًا طويلًا ليس هذا مقامه). ومن هنا يَأْتِي ﭐلتساؤلُ عن فائدة "ﭐلفلسفة" بِـﭑلنسبَةِ لِـلْإنسان فِي وُجُوده بِهذا ﭐلعالَم. لَكن هذا ﭐلتساؤلَ لا يأتِي فقط، كما قد يَـبْدُو لِأوَّلِ وَهْلَةٍ، من كَوْنِ "ﭐلفلسفة" تَدَّعِي تناولَ ﭐلْمشكلات ﭐلْأساسية فِي ﭐلوجود ﭐلْإنسانِي، مِمَّا يُوجِب بـﭑلتأكيد ﭐلْميلَ نَحو معرفة ما يُمْكِنها أن تقدمه من فائدة (أي من حلول) لِـلْإِنسان ﭐلعادِيِّ، الذي يُعانِي بشكلٍ يَوْمِيٍّ وعَيْنِيٍّ ﭐلوجودَ فِي ضرورته وتَعَقُّده، وإنَّما هو تساؤلٌ يزداد إِلْحَاحًا -فِي ﭐلواقع ﭐلْمعاصر- بفعلِ تَنَامِي ﭐلنظرة ﭐلنَّفْعِيَّة وﭐلْعَمَلِيَّةِ إلَى كُلِّ مَوَادِّ ﭐلتعليم/ﭐلتدريس، من جَرَّاءِ تَقَدُّمِ سَيْرُورَةِ ﭐلتعقيل وﭐلترشيد ﭐلقائمة على إِيـجَادِ ﭐلْآليات ﭐلْمعرفية وﭐلتقنية ﭐلكفيلة بِـﭑلِاستجابة، على ﭐلْمستوى ﭐلعملي، لِحاجات وتَحَدِّيَات ﭐلْحياة ﭐلْإنسانية فِي تَنَوُّعِها وتطورِها وتَعَقُّدِها ؛ وهو ﭐلْإلْحاحُ الذي تَتِمُّ تَرْجَمَـتُهُ ﭐلفعليَّةُ من خلال ﭐلعمل على ﭐلصياغة ﭐلتقنية وﭐلْإجرائية (أي ﭐلْخطاب ﭐلتنظيـري ﭐلْمُتَكَاثِرِ، مُنْذُ عِدَّةِ عُقُودٍ، حول ﭐلْأهداف وﭐلْكَفَاءاتِ) لِطُرُقِ ومضاميـن تعليم/تعلُّم ﭐلْموادِّ ﭐللَّتِي يُمكن أن تكون موضوعا للدراسة وﭐلتدريس فِي أي مستوًى من مستويات ﭐلتعليم/ﭐلتعلُّمِ. ولِهذا فإن "ﭐلفلسفة" أصبحت، هي أيضا، تَخضع (وتُخْضَعُ) لِسُؤَال ﭐلفائدة ﭐلباحث عن تَبَـيُّنِ مدى جَدْوَى هذه ﭐلْمَادَّةِ فِي ﭐلتعليم وقيمتها ﭐلنَّفْعِيَّةِ.
الفلسفة العربية الإسلامية من منظور جديد - محمد عبدالرحمن مرحبا*
 الفلسفة العربية الإسلامية هي إحدى الحركات العقلية التي نشأت في ظل الإسلام وحضارته وارتبطت به بأنواع مختلفة من الارتباط . فإن الإسلام لم يعبر عن ذاته بعلوم الدين والنقل فقط، بل لقد وجد في علوم الفكر والعقل أيضًا متسعًا فسيحًا للتعبير عن هذا الذات.
الفلسفة العربية الإسلامية هي إحدى الحركات العقلية التي نشأت في ظل الإسلام وحضارته وارتبطت به بأنواع مختلفة من الارتباط . فإن الإسلام لم يعبر عن ذاته بعلوم الدين والنقل فقط، بل لقد وجد في علوم الفكر والعقل أيضًا متسعًا فسيحًا للتعبير عن هذا الذات.
ولقد كانت هذه الفلسفة دائمًا محل نزاع ومناقشة بين الباحثين ، فقد اختلفوا في اسمها وفي إمكان وجودها وفي الأشخاص الذين شيدوها وأقاموا بناءها، وفي مدى ما فيها من أصالة وابتكار. لكن هذا الاختلاف لم يقتصر على الفلسفة العربية الإسلامية وحدها بل لقد شمل جميع الحركات العقلية في القرون الوسطى كلها ، إسلامية كانت أو مسيحية أو يهودية، أو وثنية. فليس هناك اتفاق حول قيمة الفلسفة المسيحية أو الفلسفة اليهودية ومدى اصالتهما وقربهما أو بعدهما عن الفلسفة اليونانية والإسلامية. ولا يزال النقاش محتدماً حول أصالة القديس توما الأكويني مثلاً ومدى استقلاله عن ابن رشد خاصة وفلاسفة الإسلام عامة. وهذا ينطبق أيضاً على موسى بن ميمون أعظم فلاسفة اليهود في العصور الوسطى كلها. والذي يهمنا هنا أمر الفلسفة العربية الإسلامية : هل توجد فلسفة عربية إسلامية أم لا ؟ وما طبيعة هذه الفلسفة إن وُجدت، وما هي خصائصها ؟ وإلى أي حد استطاعت أن تتحرر من أثار الفلسفة اليونانية ؟
إن التصدي لهذه المسألة مهمة عسيرة ولكنه لا يخلو من المتعة، على أن تُعالج موضوعياً بعيداً عن التعصب والهوى ومشاعر الحقد والضغينة. وعلى هذا الأساس سندرس الفلسفة العربية الإسلامية، فنبين أصالتها فيما لها فيه من أصالة، ولا نتحيف عليها في بعض ما تعتز به ، كما لن نتوقف عن نقدها حيث يجب النقد.
ونأمل أن تكون هذه الدراسة نواة أولية لدراسة هذه الفلسفة على أساس وضعي لا معياري، فندرسها كما هي بالفعل لا كما يجب أن تكون، ونرافق أصحابها ونعيش معهم ونفهم ظروفهم ومدى الإمكانيات المتاحة لهم للخلق والابتكار. وحسبهم فضلاً أنهم بثوا الحياة في عصور الفكر اليوناني ، وأقاموا فجوة كبيرة بين العصور الوسطى العربية الإسلامية التي كانت عصور اشعاع ونور والعصور الوسطى اللاتينية التي يسميها أصحابها أنفسهم عصور الظلام.
هذا ومنشأ سوء الظن في الفلسفة العربية الإسلامية أن دارسيها الأوائل مثل رينان ومدرسته لم يضعوا آراءهم بعد دراسة كاملة، ولم يستمدوها من التفكير العربي الإسلامي نفسه في أصوله ومصادره، وإنما كانوا يعبرون عن معظم ما كان متداولاً في المخطوطات اللاتينية، حيث لم تكن الدراسات الإسلامية الصحيحة قد بدأت بعد :« ذلك أن بعض مؤرخي القرنين الثامن عشر والتاسع عشر عرض للحياة العقلية عند المسلمين من غير أن يكون لهم إلمام بلغتهم أو أن تتوافر لديهم المصادر العربية الكافية. وانتهى إلى أحكام لا يمكن إلا أن تكون سريعة وناقصة »1، على حد قول د. إبراهيم مدكور رحمه الله. ومع ذلك فقد قدر لهذه الآراء أن تنتشر كما تنتشر النار في الهشيم، فتلقفتها الدوائر العلمية وغير العلمية، واختلفت الأغراض والمآرب. فالأجواء كانت مشحونة بالتعصب على العرب وكراهيتهم.
نظرية الحد عند المناطقة العرب - زهير الخويلدي
 " الفلسفة الموجودة اليوم عند العرب منقولة إليهم من اليونانيين وقد تحرى الذي نقلها في تسمية المعاني" أبو نصر الفارابي كتاب الحروف
" الفلسفة الموجودة اليوم عند العرب منقولة إليهم من اليونانيين وقد تحرى الذي نقلها في تسمية المعاني" أبو نصر الفارابي كتاب الحروف
استهلال:
يظن معظم المستشرقين أن حكماء العرب هم مجرد شراح للفلاسفة اليونان وأنهم عرضوا مؤلفاتهم ولخصوها بلغة الضاد وقد خلطوا في غالب الأحيان بينها وبين بعض المعتقدات الشرقية الهندية والفارسية واليهودية وأساءوا فهمها وأولوها على غير مواضعها فأنتجوا نظريات غنوصية غريبة وخلائط فكروية مجردة مثل التصور المشائي للكون والحكمة المشرقية ونظرية الفيض والأفلاطونية المحدثة وعلم الكلام وعلم الفقه والرسائل والقصص المجازية كحي ابن يقظان ولكنهم في مقابل ذلك يعترفون لهم بالعبقرية والجدة والأصالة خاصة في مستوى فن الترجمة والنقل فسموا ابن رشد الشارح الأكبر لفلسفة أرسطو والفارابي بالمعلم الثاني بعد أن سيطر أرسطو على علم الفكر كمعلم أول لقرون عديدة، وتعود شهرة الفارابي في الغرب حسب المحقق العراقي المرحوم محسن مهدي إلى كتاب الحروف وتعود شهرة كتاب الحروف إلى الفصل الخامس والعشرين الأخير من الباب الثاني والمعنون:اختراع الأسماء ونقلها، وسبب شهرة هذا الفصل أن المعلم الثاني لا يعرض فيه نظرية في الترجمة العلمية فحسب بل علاوة على ذلك يحدد فيه طرق نقل المعاني الفلسفية من لغة إلى لغة أخرى ويجيب عن سؤال: كيف ينبغي أن تؤخذ المعاني الفلسفية عند التعليم؟ ويرسم بذلك نقاط الإتباع والإبداع الفلسفي بين العرب والإغريق. إذ يقول في هذا السياق:"ينبغي أن تؤخذ المعاني الفلسفية إما غير مدلول عليها بلفظ أصلا بل من حيث هي معقولة فقط وإما إن أخذت مدلولا عليها بالألفاظ فإنما ينبغي أن تؤخذ مدلولا عليها بألفاظ أي أمة اتفقت والاحتفاظ فيها عندما ينطق بها وقت التعليم لشبهها بالمعاني العامية التي منها نقلت ألفاظها...فلذلك رأى قوم أن لا يعبروا عنها بألفاظ أشباهها بل رأوا أن الأفضل هو أن تجعل لها أسماء مخترعة لم تكن قبل ذلك مستعملة عندهم في الدلالة على شيء أصلا مركبة من حروفهم على عاداتهم في أشكال ألفاظهم..."
واذا استنطقنا هذه النقاط تبين لنا أن حد الفلسفة تلقاه حكماء العرب على جهة النقل والإتباع أما المعاني الفلسفية فقد تملكوها على جهة الخلق والإبداع عندما تحروا في التسمية وبذلوا الجهد لاختراع الكلمات المناسبة للأشياء والمعاني والحالات. واذا كنا لا نحتاج إلى امتحان الاستنتاج الأول فقد شاع بين المؤرخين أن العرف عرفوا الفلسفة على النحو الذي عرفها به الإغريق فإن الاستنتاج الثاني يطرح عدة شبهات وفي حاجة إلى توضيح وإبانة بتقديم الأدلة والبراهين من نصوص حكماء العرب أنفسهم، لكن كيف يكون هؤلاء الحكماء مقلدين على جهة اللفظ مبدعين على جهة المعنى؟ ما المقصود بالتلقي الإبداعي للمعاني الفلسفية الإغريقية في اللغة العربية؟ كيف تحول العرب من نقل حد الفلسفة إلى إبداع فلسفة في الحد؟ ماهي فلسفة الحد التي أبدعها العرب وميزتهم عن فلسفة الإغريق؟ هل يتعلق الأمر بنظرية في التعريف أم بنظرية منطقية؟
ابن رشـد والبحث عن الحقيقة - عبدالجبار محمود السامرائي
 ثمانية قرون تفصل بيننا وبين المفكر العربي القرطبي الكبير ابن رشد، بيد أن هذه الفاصلة الزمنية الهائلة لم تلغ اتصاله بنا واتصالنا به، فكراً وعلماً وفلسفة. لقد كان الرجل فيلسوفاً بارعاً، خلّف لنا آثاراً شامخة في الحكمة،أبرزها:(تهافت التهافت)،(مناهج الأدلّة)،(فصل المقال) وكتاب في الطب أسمه(الكليات). كان ابن رشد نابغة أهل زمانه، لكن نبوغه كان وبالاً عليه، فقد رمي بتهمة المروق من الدين، ونفي خارج مدينة قرطبة، ثم أحرقت كتبه، وحُرّمت دراسة الفلسفة! بيد أن المحنة لم تدم طويلاً، فقد رد الاعتبار إلى الرجل بعد مضي سنة على المحنة، بفضل من ذوي الفضل وأصحاب الضمير. وفي ليلة الجمعة (11ديسمبر 1198م)الموافق 10صفر595هـ، وفي مفتتح دولة الناصر بالأندلس كانت الفلسفة محمولة على ظهر جمل. الجمل خرج من مراكش قاصداً قرطبة، وكان يمشي وئيداً، لكنه ما كان يحمل جندلاً أو حديداً.. كان يحمل كتباً ضخاماً في جهة، وجثمان رجل في الجهة الأخرى. الرجل هو ابن رشد، الذي مات جسداً، ولم يمت فكراً وروحاً.. أليس هو القائل:"تموت روحي بموت الفلسفة"؟. لقد كان ابن رشد ظاهرة بكل ما تعني هذه المفردة من معنى.ز ظاهرة متفردة في عصره، وصار جسراً من جسور الفلسفة العربية التي امتدت إلى أوربا. وبرغم الأجواء العدائية التي غلفت ابن رشد، إلا أنه قد استطاع بإصراره وأصالة تفكيره أن يضع أُسساً فكرية ونقدية تنم عن تحرر عقلي لا يستسلم للأجواء الملبدة بالغيوم والمصحوبة بقصف الرعود. كان هاجس ابن رشد هو إدراك الحقيقة.. وهذا حسبه.
ثمانية قرون تفصل بيننا وبين المفكر العربي القرطبي الكبير ابن رشد، بيد أن هذه الفاصلة الزمنية الهائلة لم تلغ اتصاله بنا واتصالنا به، فكراً وعلماً وفلسفة. لقد كان الرجل فيلسوفاً بارعاً، خلّف لنا آثاراً شامخة في الحكمة،أبرزها:(تهافت التهافت)،(مناهج الأدلّة)،(فصل المقال) وكتاب في الطب أسمه(الكليات). كان ابن رشد نابغة أهل زمانه، لكن نبوغه كان وبالاً عليه، فقد رمي بتهمة المروق من الدين، ونفي خارج مدينة قرطبة، ثم أحرقت كتبه، وحُرّمت دراسة الفلسفة! بيد أن المحنة لم تدم طويلاً، فقد رد الاعتبار إلى الرجل بعد مضي سنة على المحنة، بفضل من ذوي الفضل وأصحاب الضمير. وفي ليلة الجمعة (11ديسمبر 1198م)الموافق 10صفر595هـ، وفي مفتتح دولة الناصر بالأندلس كانت الفلسفة محمولة على ظهر جمل. الجمل خرج من مراكش قاصداً قرطبة، وكان يمشي وئيداً، لكنه ما كان يحمل جندلاً أو حديداً.. كان يحمل كتباً ضخاماً في جهة، وجثمان رجل في الجهة الأخرى. الرجل هو ابن رشد، الذي مات جسداً، ولم يمت فكراً وروحاً.. أليس هو القائل:"تموت روحي بموت الفلسفة"؟. لقد كان ابن رشد ظاهرة بكل ما تعني هذه المفردة من معنى.ز ظاهرة متفردة في عصره، وصار جسراً من جسور الفلسفة العربية التي امتدت إلى أوربا. وبرغم الأجواء العدائية التي غلفت ابن رشد، إلا أنه قد استطاع بإصراره وأصالة تفكيره أن يضع أُسساً فكرية ونقدية تنم عن تحرر عقلي لا يستسلم للأجواء الملبدة بالغيوم والمصحوبة بقصف الرعود. كان هاجس ابن رشد هو إدراك الحقيقة.. وهذا حسبه.
الفلسفة هي الوليد الشرعي للعقل، وهي ربيبته على مر العصور. لذلك، اتخذ منها ابن رشد منهجاً وأسلوباً، ليهتدي به إلى معرفة الحقيقة. ولما كانت الفلسفة (حب الحكمة) لذا فقد ارتبطت بمعاني النظر والتأمل والتفكير والمشاهدة العقلية. ومادامت (الحكمة) هي النور العقلي الذي نسير على هديه في ظلمات الحياة، لذا فإن الحياة لا تكاد تنفصل عن التفلسف، شريطة أن نفهم من الفلسفة أنها عملية نقد الحياة وتحليلها وتقويمها. والفلسفة لا تخرج عن كونها محاولة إنسانية لتفسير الحياة، وتبرير الوجود، وتأويل الواقع. واما كانت الفلسفة ذات طابع إنساني عام، أو صبغة عقلية كلية، فذلك لأنها تستثير اهتمام كل فرد منا كائناً من كان، إذ ليس بيننا من لم تؤرقه يوماً ما بعض المشكلات حول مصيره، أو حريته، أو قصور معرفته، أو شقاء حياته، أو قلق ضميره، أو فناء وجوده...إلخ. والفلسفة وليدة الدهشة، فالدهشة، كما يقول أرسطو، هي:"الأم التي أنجبت لنا الفلسفة". والفلسفة، تلك الروح التساؤلية التي تقترن دائماً بأداة الاستفهام الكبرى؛لمَ، أو لماذا؟(1). لقد كانت الفلسفة محور اهتمام ابن رشد، ولم يكن من السهل تعاطي الفلسفة في عصره الذي كان فيه للفقهاء المتعصبين نفوذاً كبيراً (2).