 قد أخذ المنحى الشكلي ـ بما فيه من مقاربات عروضية و إيقاعية و غيرها ـ جهودا جمة في مقاربات الشعر الحديث حتى بدا التجديد فيه يكاد لا يتمثل إلا في مظهر المباني بينما ظلت مسألة المعاني و الرؤى والصور قليلة الحضور و التناول على مستوى النصوص النظرية والحجاجية لذلك نرى أنه يتعين على المتابعين لتطور القصيدة العربية الحديثة أن يعكفوا كذلك على سبر مثل هذه الأغوار الداخلية للوقوف على مدى إضافات الشعر الجديد و رصد تحولات القصيدة الحديثة تلك التي ولئن طرقت نفس المواضيع القديمة عموما إلا أنها تناولتها من زوايا أخرى و بأساليب مغايرة مثل موضوع الموت
قد أخذ المنحى الشكلي ـ بما فيه من مقاربات عروضية و إيقاعية و غيرها ـ جهودا جمة في مقاربات الشعر الحديث حتى بدا التجديد فيه يكاد لا يتمثل إلا في مظهر المباني بينما ظلت مسألة المعاني و الرؤى والصور قليلة الحضور و التناول على مستوى النصوص النظرية والحجاجية لذلك نرى أنه يتعين على المتابعين لتطور القصيدة العربية الحديثة أن يعكفوا كذلك على سبر مثل هذه الأغوار الداخلية للوقوف على مدى إضافات الشعر الجديد و رصد تحولات القصيدة الحديثة تلك التي ولئن طرقت نفس المواضيع القديمة عموما إلا أنها تناولتها من زوايا أخرى و بأساليب مغايرة مثل موضوع الموت في الموت قصائد عديدة ضمن أغراض الرثاء والتأمل والزهد وغيرها فهو من المواضيع التي يزخر به ديوان الشعر العربي على مدى توالي عصوره و ترامي أمصاره غير أنه أضحى في مدونة الشعر العربي الحديث موضوعا قد تناوله بعض الشعراء بكثير من التجديد سواء من حيث المناسبة و العبارة أو من حيث الإيقاع والصورة ناهيك عن النظرة إليه من حيث الرؤية الاجتماعية و الدينية و الفلسفية فظهرت قصائد عديدة في ما يسمى بالرثاء الذاتي تتمحور عموما حول فكرة أساسية غالبا ما تؤكد على أن الشاعر قد نفض يديه من الدنيا تلك التي يغادرها وحيدا بلا أهل و بلا أصدقاء وبلا مراسم دفن أو طقوس جنائزية لكأن القصيدة تتحول إلى عتاب لمعاصري الشاعر لتصل إلى الخيبة والمرارة...إنها قمة المأساة
من بين أولئك الشعراء الشاعر والأديب صالح القرمادي في ديوانه ـ اللحمة الحية ـ الصادر بتونس سنة 1970 حيث نقرأ له قصيدا بعنوان ـ نصائح إلى أهلي بعد موتي ـ يقول فيه
إذا متّ مرّة بينكم
وهل أموت أبدا
فلا تقرؤوا على الفاتحة وياسين
واتركوهما لمن يرتزق بهما
ولا تحلّوا لي في الجنّة ذراعين



 خبر لا يهم أحداً:
خبر لا يهم أحداً: لقد ارتبطت مسألة استلهام الشعراء المعاصرين للرمز الشعري وتوظيفه بتيار الحداثة، وهي قضية طرحت العديد من المصاعب للشعراء الحداثيين العرب، وتتمثل في كيفية التوفيق بين صياغات مختلفة حول مفهوم التراث الثقافي للشعراء العرب المعاصرين.
لقد ارتبطت مسألة استلهام الشعراء المعاصرين للرمز الشعري وتوظيفه بتيار الحداثة، وهي قضية طرحت العديد من المصاعب للشعراء الحداثيين العرب، وتتمثل في كيفية التوفيق بين صياغات مختلفة حول مفهوم التراث الثقافي للشعراء العرب المعاصرين. «أحارب... أو لا أحارب؟
«أحارب... أو لا أحارب؟ كلمات في وداع أجمل الفرسان محمود درويش
كلمات في وداع أجمل الفرسان محمود درويش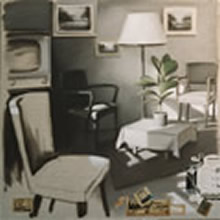 آرنست همنغواي من الأسماء المبدعة التي جسدت السينما أعماله كالشيخ والبحر، ولمن تقرع الأجراس 1941، ومازالت الشمس تشرق 1926، ووداعاً للسلاح 1929 ، وثلوج كلمنجارو.
آرنست همنغواي من الأسماء المبدعة التي جسدت السينما أعماله كالشيخ والبحر، ولمن تقرع الأجراس 1941، ومازالت الشمس تشرق 1926، ووداعاً للسلاح 1929 ، وثلوج كلمنجارو. مقدِّمة: معيار القصة الجيدة:
مقدِّمة: معيار القصة الجيدة: 









