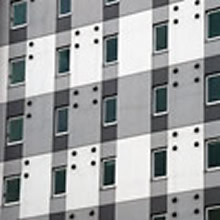 من منَّا نحنُ المنتظرون ما لا يأتي , البسطاءُ في صياغة أحلامنا , المحكومونَ بالعدم وشقاءِ الدمِ الأزرقِ " حبر مواجعنا والنجوم" , يملكُ نفسهُ اللاهثة خلف سرابِ الأهواءِ الفضيِّ , كما يملكُ عفويَّة أحلامهِ وبساطتها المؤجلَّة , ولا يترَّصدُ الفُرَصَ المُبتذلة واللحظاتِ الحرجة والمواقف الرخيصة ليرمي ظهورَ أصدقائهِ الساذجين اللاهينَ بسهامِ عبثهِ غيرِ البريء ؟؟
من منَّا نحنُ المنتظرون ما لا يأتي , البسطاءُ في صياغة أحلامنا , المحكومونَ بالعدم وشقاءِ الدمِ الأزرقِ " حبر مواجعنا والنجوم" , يملكُ نفسهُ اللاهثة خلف سرابِ الأهواءِ الفضيِّ , كما يملكُ عفويَّة أحلامهِ وبساطتها المؤجلَّة , ولا يترَّصدُ الفُرَصَ المُبتذلة واللحظاتِ الحرجة والمواقف الرخيصة ليرمي ظهورَ أصدقائهِ الساذجين اللاهينَ بسهامِ عبثهِ غيرِ البريء ؟؟من منَّا لا يُروِّجُ لأضغاثِ أوهامهِ وهشاشةِ أمانيهِ المُهشَّمةِ كالبلوّر على صخرِ الحياة , المبعثرة على سطحِ كوكبٍ ضائعٍ في مجرَّتهِ ؟
من لا ينافقُ في أصغرِ جزئيَّاتِ علاقتهِ مع الأشياءِ والآخرين ؟؟
حبَّذا لو فعلنا كلَّ هذا ولكن بقدرٍ معلوم ٍ ...حبَّذا .
"كُلنَّا في الهواءِ سواء" هذا ما نكتشفهُ في النهاية ونعترفُ بهِ , هذه الحقيقة تطبقُ علينا كلعنةٍ محتومةٍ , كظلامٍ قاسٍ.
إنَّ ما أغراني بكتابةِ هذا الكلامِ الجريحِ يراودني منذ زمنٍ حتى رنَّ هاتفي ذاتَ مساءٍ
وطُلبَ إليَّ أن أكتب تحيةً تقييميّة للصديقِ الكاتب سهيل كيوان بمناسبة تكريمهِ من مدرسةٍ في قرية كفر قرع , حينها أغراني سريعاً جمالُ ترَّفعهِ عمَّا إنحطَّ إليهِ الكثيرُ من الآخرينْ , من أخلاقيَّات صدئتْ في الشمس العربية , فمنهم من يطعنُ من الخلف , ومنهم من ترميني نرجسيَّتهُ بتلكَ التهمةِ أو بذاكَ الإفتراءْ أو ربمَّا بنصالِ الحقدِ المزمن , ومنهم من يتعامى ويصمُّ أذنيهِ عن صراخِ ضميرهِ في زمنٍ لا يقيمُ وزناً لقيم ولا لمُثلِ , تزدادُ فيهِ حاجتنا إلى درعٍ من الذهبِ الُمقوَّى ليلفُّنا كالجناحِ الدفيءِ ويحمينا من سطوةِ بردِ الآخرينْ .
الكتابة عن أديبٍ بحجم سهيل كيوان مُربكة قليلاً أو ربمَّا كثيراً , ممَّا وضعني في موقفٍ حرجٍ من نفسي وترددّتُ حينها لإتسَّاعِ معنى الكاتب سهيل كيوان وضيق عبارتي , فروائيٌّ مثلهُ متعددُّ الأساليبِ والطرقِ التعبيرية وفسيح المجالاتِ يحتاجُ أدبهُ الى دراسةٍ وبحثٍ علميين دقيقين أمينين ومن أكادميين متخصِّصين ليُوَّفى بعضاً من حقهِ , لا إلى كلامٍ قليلٍ عابرٍ , لإيماني بقيمة كاتب مكافح وعصاميِّ تركَ بصمتهُ على أدبنا المحليِّ , وبأنَّ خيرَ من يقيمُّ سهيل كيوان أدبهُ نفسهُ , رواياتهُ , مقالاتهُ , حسُّهُ النقدي ,سخريتهُ المرَّة ,عصاميَّتهُ الفذة , وطعمُ قصصهِ المراوغة والمراوحة بينَ الأدب الإجتماعي أو السياسي الملتزم والمفارقة الساخرة المنتقاة بعناية فائقةٍ كحجر الزاوية , وفوقها تلتئمُ مداميكُ البراعة الفنيَّةِ واللغويَّةِ .



 أقيمت في مسرح الميدان الموجود في مدينة حيفا قبل مدةٍ وجيزة إحتفالية بتدشين نشر رواية الشاعر والروائي الفلسطيني المعروف والمقيم في عمَّان إبراهيم نصر الله " زمن الخيول البيضاء " والتي قامت بتبنيّها واحتضانها مكتبة كل شيء في حيفا وهي من كبريات دور النشر هنا في الداخل الفلسطيني , ولكن حلقةً ضائعةً لا زلتُ أبحثُ عنها في تبلوِّر هذه العلاقة المفاجئة بين دور النشر عندنا والأدباءِ المقيمين خارج الوطن , لا أريد أن أقول الأغيار أو الأجانب حتى لا أُتهَّم بالتطرَّف الثقافي أو بالعنصريَّة , مع أنَّ الشاعر الفلسطيني إبراهيم نصر الله من لحم هذا الوطن مقتطعٌ ,وليس من باب التقليل من قيمة شاعر وكاتب بحجم إبراهيم نصر الله بالتجائه القسريِّ إلينا بعدما كانت كبرى دور النشر في عالمنا العربي" المؤسسة العربية للدراسات والنشر" تحتضنهُ كابنها وتتبنَّى كتبه . فأنني أعترف بأنه من أنشط الكتاب والشعراء الفلسطينيين في الوقت الراهن ويمتاز برأيي بغنى ثقافي وحضور أدبي آسر وشاعرية إنسانية رقيقة ومسحة غنائية صافية الجرس وعميقة الحسِّ , قرأت ربمّا كلَّ دواوينه الشعرية الأمر الذي لم أفعله حتى هذه اللحظة مع رواياته اللاتي يبدو لي أنها من الأهمية الأدبية والتاريخية بمكان .
أقيمت في مسرح الميدان الموجود في مدينة حيفا قبل مدةٍ وجيزة إحتفالية بتدشين نشر رواية الشاعر والروائي الفلسطيني المعروف والمقيم في عمَّان إبراهيم نصر الله " زمن الخيول البيضاء " والتي قامت بتبنيّها واحتضانها مكتبة كل شيء في حيفا وهي من كبريات دور النشر هنا في الداخل الفلسطيني , ولكن حلقةً ضائعةً لا زلتُ أبحثُ عنها في تبلوِّر هذه العلاقة المفاجئة بين دور النشر عندنا والأدباءِ المقيمين خارج الوطن , لا أريد أن أقول الأغيار أو الأجانب حتى لا أُتهَّم بالتطرَّف الثقافي أو بالعنصريَّة , مع أنَّ الشاعر الفلسطيني إبراهيم نصر الله من لحم هذا الوطن مقتطعٌ ,وليس من باب التقليل من قيمة شاعر وكاتب بحجم إبراهيم نصر الله بالتجائه القسريِّ إلينا بعدما كانت كبرى دور النشر في عالمنا العربي" المؤسسة العربية للدراسات والنشر" تحتضنهُ كابنها وتتبنَّى كتبه . فأنني أعترف بأنه من أنشط الكتاب والشعراء الفلسطينيين في الوقت الراهن ويمتاز برأيي بغنى ثقافي وحضور أدبي آسر وشاعرية إنسانية رقيقة ومسحة غنائية صافية الجرس وعميقة الحسِّ , قرأت ربمّا كلَّ دواوينه الشعرية الأمر الذي لم أفعله حتى هذه اللحظة مع رواياته اللاتي يبدو لي أنها من الأهمية الأدبية والتاريخية بمكان .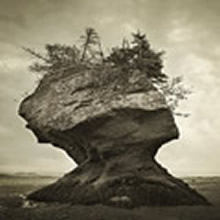 إن مفتاح الدخول إلى عالم عبد الكريم الناعم الشعري: يكمن في قدرته الهائلة على التحليق باللغة في آفاق رحبة، تؤثثها مفاتن الطبيعة النضرة التي تمثل الوجه المادي للأرض المشتهاة بغية التوحد بها، والتماهي مع كل مظهر من مظاهرها. وعن أهمية هذا السفر المحلق مع اللغة يقول الشاعر: "الذين لا يسافرون مع اللغة وفيها يخسرون تذوق الوصل في ليالي الربيع المقمرة المليئة بالعشب والنضارة، ويضيق بهم الأفق، بحيث يسجنون العالم والأحاسيس في قفص من الكلام العادي المكرر" -1-
إن مفتاح الدخول إلى عالم عبد الكريم الناعم الشعري: يكمن في قدرته الهائلة على التحليق باللغة في آفاق رحبة، تؤثثها مفاتن الطبيعة النضرة التي تمثل الوجه المادي للأرض المشتهاة بغية التوحد بها، والتماهي مع كل مظهر من مظاهرها. وعن أهمية هذا السفر المحلق مع اللغة يقول الشاعر: "الذين لا يسافرون مع اللغة وفيها يخسرون تذوق الوصل في ليالي الربيع المقمرة المليئة بالعشب والنضارة، ويضيق بهم الأفق، بحيث يسجنون العالم والأحاسيس في قفص من الكلام العادي المكرر" -1- تعتبر المجموعة القصصية " ذكريات من منفى سحيق " باكورة أعمال القاص المغـربي صخر المهيف ، وهو من مواليد 1971 بتازة ، بدأ النشر مبكـرا منذ سنة 1995 بالعديد من الأسبوعيات و الجرائد و المواقع و المجلات العربية و الوطنية ، يعمل أستاذ التعليم الابتدائي و فاعل جمعوي و منشط بالمطعم الثقافي الأندلسي بأصيلة . يهتم بمجالات أدبية متنوعة : المقالة ، المسرح ، الشعر و القصة و الرواية .
تعتبر المجموعة القصصية " ذكريات من منفى سحيق " باكورة أعمال القاص المغـربي صخر المهيف ، وهو من مواليد 1971 بتازة ، بدأ النشر مبكـرا منذ سنة 1995 بالعديد من الأسبوعيات و الجرائد و المواقع و المجلات العربية و الوطنية ، يعمل أستاذ التعليم الابتدائي و فاعل جمعوي و منشط بالمطعم الثقافي الأندلسي بأصيلة . يهتم بمجالات أدبية متنوعة : المقالة ، المسرح ، الشعر و القصة و الرواية . تقديم:
تقديم:
 الشعر ُفنُّ العربية الأول، وأكثر فنون القول هيمنة على التاريخ الأدبي عند العرب مقارنة بالخطابة والنثر والسرد ولعل هذا ما عناه ابن عباس في مقولته الشهيرة " الشعر ديوان العرب" للدلالة على أهمية الشعرعند العرب وتمجيد ما أبدعه الإنسان من الشعر، خاصة أنه حافظ لتاريخ العرب وأيامها وعلومها المختلفة ويُعدُّ وثيقة يمكن الاعتماد عليها في التعرُّف على أحوال العرب وبيئاتهم وثقافتهم وتاريخهم دون إخراجه من دائرة الفن إلى دائرة أخرى.
الشعر ُفنُّ العربية الأول، وأكثر فنون القول هيمنة على التاريخ الأدبي عند العرب مقارنة بالخطابة والنثر والسرد ولعل هذا ما عناه ابن عباس في مقولته الشهيرة " الشعر ديوان العرب" للدلالة على أهمية الشعرعند العرب وتمجيد ما أبدعه الإنسان من الشعر، خاصة أنه حافظ لتاريخ العرب وأيامها وعلومها المختلفة ويُعدُّ وثيقة يمكن الاعتماد عليها في التعرُّف على أحوال العرب وبيئاتهم وثقافتهم وتاريخهم دون إخراجه من دائرة الفن إلى دائرة أخرى.  الفن الروائي :
الفن الروائي :








