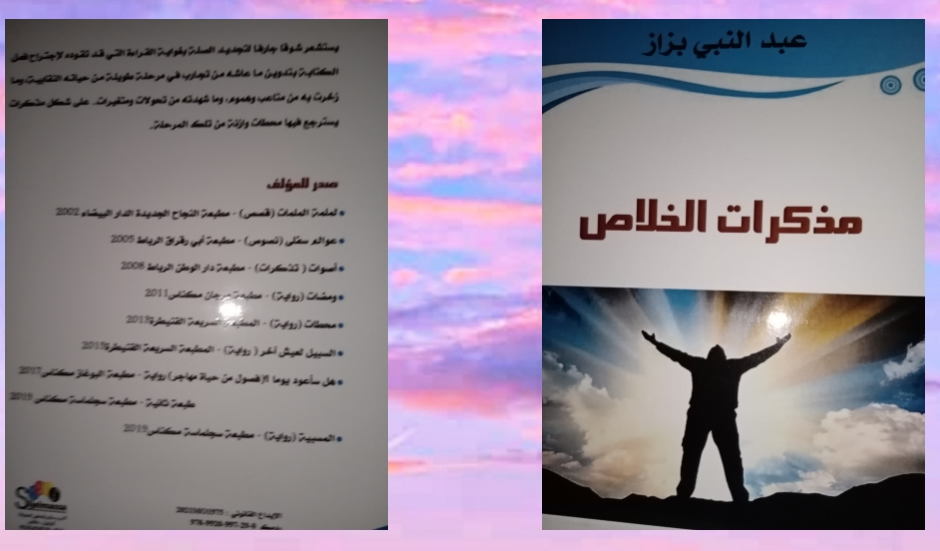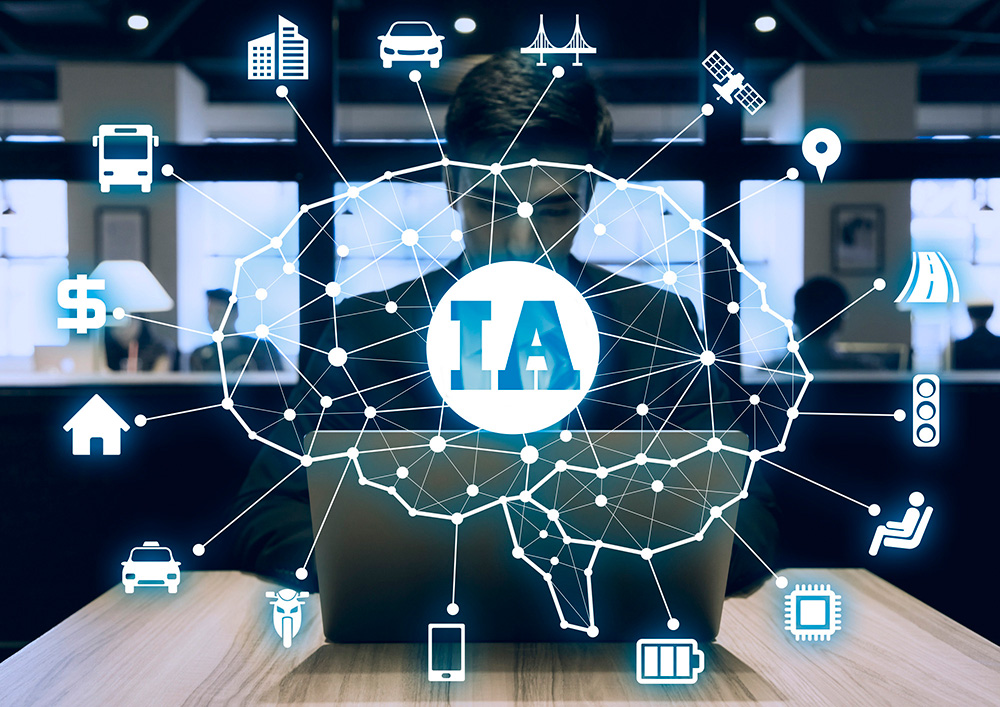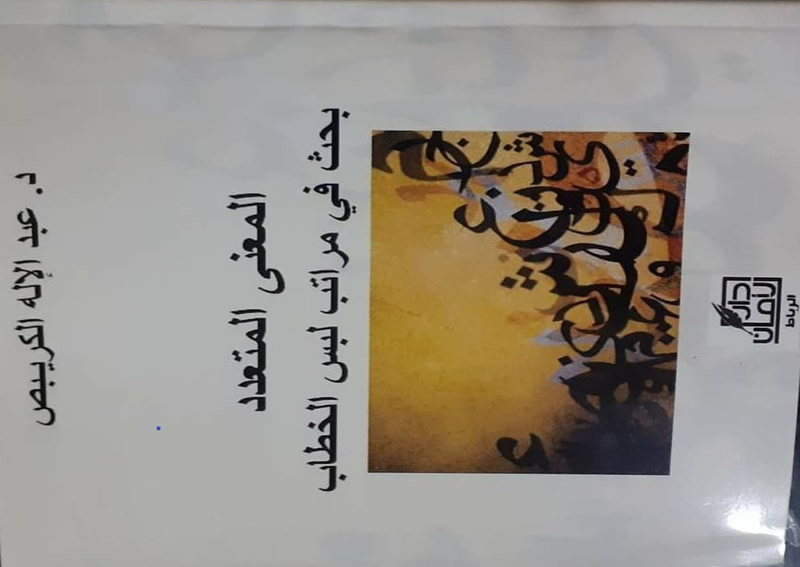إن كان ثمة حق في التعليق؟
ماهو التعليق؟ إنه الارجاء، انه القراءة المرجأة دائما، قد يكون هذا سبب تسمية المعلقات بالمعلقات، قراءة مرجأة ومفتوحة دائما ليتم الاضافة إليها.
***
هل عرف الاستاذ شيئا آخر في المسيد غير ما نراه في نصوص اخرى من شراسة في تصوير المسيد [ ... ] ؟
***
عرف الكتابة، عرف كيف يخلق لغة داخل لغة أخرى. لَكم يغمرني الشعور بالأسف، اذ لم اتعرف على/عن نصوص الاستاذ باكرا، ذلك أني في افضل أحوالي لست إلا قارئا كسيحا، أعاني الكساح كعاهة قرائية.
***
ماهو الأدب؟
إننا لا نَعرفه ولا نُعرفه، او أننا نعرف ما ليس ادبا، او في افصح حالاتنا نقول ان الادب هو ما يخترقنا تماما كالحب، الادب/الحب هو ما يجعلنا في مهب نسيم الاغيار، وهذا النص – تمرد في المسيد – لو لم يكتبه الاستاذ كله لكتبت بعضه، هل يُسمح للمتعلم ان يقول كهذا كلام؟ هل يحق للمحضرية ؟ في مثل هذه الإلتقاءات نحن دائما داخل نوع من المسيد حيث ثمة دوما من يجلس على دكة اعلى/عليا.
المهدي أخريف: الشاعر اللاهث وراء النص الهارب - د. امحمد برغوت
ما يثير انتباهك وأنت تتصفح ديوان المهدي أخريف: "بين الحبر وبيني"1 هوس الشاعر بطقوس الكتابة كموضوعة مهيمنة على جل نصوصه الشعرية، إنه هوس بظروف انبثاق عملية كتابة النص الشعري وكيفية تشكله.
إن بياض الصفحة - باعتباره الحيز الذي تستقر فيه الكتابة هو اللون الذي يؤرق الشاعر، إذ تستوقفك منذ الوهلة الأولى إحالة عناوين قصائده في فهرس أضمومته على العلاقة المحمومة بين لون البياض المستفز والرغبة في الكتابة كما يتضح في
هذه العناوين: "صفحة لأخرى - بين بياضين - يا أنا يا ألفاظي" .
ومن ثم فالشاعر حريص على ذكر بياض الصفحات في أكثر من قصيدة كقوله في بداية الديوان :
عن الشخصية في رواية "مذكرات الخلاص" والقيم الإيجابية المؤطرة لها - عبد الرحيم التدلاوي
أصدر الكاتب الروائي والناقد المغربي عبد النبي بزاز ابن مدينة الخميسات كتابه الجديد، وهو عبارة عن رواية تحت عنوان مذكرات الخلاص، والتي حظيت بإعجاب عدد من الكتاب والمثقفين، ولقيت إقبالا واسعا وتفاعلا إيجابيا من أول يوم خرجت فيه إلى الوجود.
وينشر، الكاتب ابن مدينة الخميسات المقيم حاليا بمكناس في عدة منابر مغربية وعربية ورقية وإلكترونية في مجال القصة والنقد، حيث أصدر كتابه الأخير عبارة عن رواية ، تقع في 98 صفحة من الحجم المتوسط ، ( الطبعة الأولى سنة 2021 بمطبعة سجلماسة ــ مكناس).
وتعتبر رواية (مذكرات الخلاص) تاسع إصدار للكاتب، حيث كانت بدايته سنة 2002 من خلال قصص (لملمة الملمات)، تلاها إصدار آخر سنة 2005 عبارة عن نصوص بعنوان (عوالم سفلى)، وفي سنة 2008 إصدار عبارة عن (تذكرات) بعنوان أصوات، وخلال سنة 2011 كانت له أول رواية بعنوان ومضات، تلتها أربع روايات، 2013 محطات، و2015 السبيل لعيش آخر، و 2017 هل سأعود يوما؟ (فصول من حياة مهاجر)، وسنة 2019 المسبية.
مسؤول سابق في البنتاغون: الصين كسبت معركة الذكاء الاصطناعي ضد الولايات المتحدة
قال رئيس البرمجيات السابق في البنتاغون لصحيفة "فايننشال تايمز" (Financial Times) إن الصين انتصرت في معركة الذكاء الاصطناعي مع الولايات المتحدة وتتجه نحو الهيمنة العالمية بسبب تقدمها التكنولوجي، وذلك وفق ما نقلته رويترز أول أمس الاثنين.
وقال نيكولاس تشايلان -أول مسؤول برمجيات في البنتاغون والذي استقال احتجاجا على بطء وتيرة التحول التكنولوجي في الجيش الأميركي- إن عدم الرد يعرض الولايات المتحدة للخطر.
وأضاف "ليست لدينا فرصة قتالية منافسة ضد الصين في 15 إلى 20 عاما. الآن، إنها بالفعل (قضية منتهية)"؛ وقال للصحيفة "لقد انتهت بالفعل وفق رأيي".
وقال إن الصين عازمة على الهيمنة على مستقبل العالم، والسيطرة على كل شيء من الروايات الإعلامية إلى الجغرافيا السياسية.
وقد ألقى تشايلان باللوم على الابتكار البطيء، وإحجام الشركات الأميركية مثل "غوغل" (Google) عن العمل مع الدولة بشأن الذكاء الاصطناعي والمناقشات الأخلاقية المكثفة حول التكنولوجيا.
عن كتابِ الــمَعْنَى الـمتعدِّد: بحثٌ في مراتب لَبس الخطاب للــدّكتورِ "عبد الإلــه الكَريبص": نحو تَـــصَورٍ سميو لسانـــيٍّ مُدمَجٍ وموسّع لفكِّ لَـــبْسِ الخطابِ - عبد الرّحيم دَودي
- فـي البدء كان اللَّـبس
يُــشكّل سُؤال المعنى أسَّ الوجودِ الإنسانيِّ. إنَّ ما يميّزُ الإنسانَ عن بَـــاقِي الكائناتِ هو قدرتهُ على خلقِ عالمٍ رمزيٍّ قوامهُ علاماتٌ متعدّدةُ الأشكالِ والأنواعِ والمظاهر؛ عالم مفتوح على تعدُّد الدّلالات والمعاني. ولعلّ هذا التعدُّد عائدٌ، حسب "إرنست كاسرير"، إلــى حركةِ الوعي الإنسانيّ -بما هو فاعِليةٌ تتأسّس على المفهمةِ والسميأةِ- المتناوسة بين قانونيْ الجبذِ والنبذِ.[1] جبذٌ يتجهُ نحو الــمرجعِ في محاولةِ رسمهِ على شاشةِ الذهن، ونبذٌ يستنسخُ رسوماً يُدمنها الذهن فتصيرُ نموذجَ قياسٍ )أو بنية تعرّف بتعبير "أمبرتو إيكو"( تحضرُ من خلالهِ الوقائعُ في الذهنِ. وتأتي الــلّغة، على امتداد هذه الــمسافةِ، لــتُغطيَ، ما ارتسمَ في الــعقلِ صوراً، بلباس لفظيّ يظلُّ، دوماً، منذوراً لــقصورِ الـتّمثيل: فالكلمة ليست واقعاً، بل هي صيغةٌ رمزيةٌ عنه. كان أرسطو يقولُ: "أنْ نقول شيئاً عن شيءٍ ما، معناهُ أن نقولَ شيئاً آخر".
مقاربة جندرية : أول نص روائي نسائي في كل بلد عربي مع الترتيب الزمني - الكبير الداديسي
نحاول في هذه المقالة القصيرة النبش في الرواية العربية النسائية، ونتساءل عن أقدم نص روائي نسائي؟ ونسعى إلى ترتيب الدول العربية بحسب ظهور أول نص بكل قطر عربي نسأل الله التوفيق:
- في المرتبة الأولى: لبنان وكانت أول رواية هي نص (حسن العواقب (لزينب فواز) صدرت سنة 1899، وقبل دول عربية أصدر للبيبة هاشم أيضا رواية (قلب الرجل) سنة 1904. وهما روائيتان اشتهرتا قبل رواية ظهور رواية (زينب) لأحمد حسنين هيكل التي يحلو للبعض اعتبارها أول رواية عربية...
- المرتبة الثانية كانت ثلاثية بين كل من سوريا ومصر والعراق : إذ صدر في سوريا سنة 1950 نص (يوميات هالة) للروائية سلمى الحفار الكزبري ، وصدر في نفس السنة نص (أروى بنت الخطوب) لوداد سكاكسيني وهي فلسطينية الأصل، عاشت بين سوريا ومصر ) وبالعراق صدرت رواية (ليلة الحياة) لحورية هاشم، ولم تنته الخمسينيات حتى كانت الرواية قد استقطبت ما زيد على خمس روئيات بسوريا. وبالعراق صدرت روايات نسائية منها (بريد القدر) 1951 ورواية (من الجاني) لحربية محمد سنة 1954، ورواية ن(ادية) لليلى عبد القدر سنة 1957.
الشعر النسائي المغربي المعاصر: تجليات الذات النسائية المبدعة – د. هشام رحمي
ظلت القريحة الشعرية المغربية على مر السنين والأعوام، معطاءة، تجترح الصور الفنية وتشكل الاستعارات، وتنسج الواقع والحلم، وتخط ملامح الأمل؛ بلغة رصينة ونسج محكم، واستلهام كبير للمبادئ الكونية، التي تدعو للمحبة والسلام، وخلق عالم سليم من التشوهات الفكرية والاجتماعية والنفسية. أفقها واحد وموحد، ومبدؤها ثابت لا يتغير، يقوم على أساس تقدير اللحظة الشعرية التي يعيشها الشاعر، باعتبارها لحظة فارقة ينتقل بها ومعها الشاعر من الواقع إلى الحلم، ومن الألم إلى الأمل. من عالم تتكدس فيه المحن، وتكثر فيه الاعطاب الفكرية، إلى عالم رحب فسيح، يتجاوز من خلاله الشاعر مطبات المجتمع والواقع، بالقفز خارج دائرة اليأس والقنوط والموت. سواء منه الموت الفزيائي، أو الموت المعنوي النفسي.
مُنى هاشم والشغف الحارق للخيال والتاريخ: من وليدات الشاوية إلى ابن تومرت - شعيب حليفي
أحيانا نُهمل حقوق نصوص علينا بعد أن نقرأها فتتشابك القراءة بالكتابة والقارئ بالكاتب، وقد ننتقل من وضعية القارئ إلى حالة شخصية من الشخصيات. قرأت رواية " وليدات الشاوية "(ط1-2005 والطبعة الثانية في سنة 2008) للكاتبة منى هاشم، بعد سنة واحدة من طبعتها الثانية، وسجلتُ في هوامشها مجموعة من الملاحظات تمهيدا لإعادة قراءتها والنظر بالموازاة إلى تلك الملاحظات الشخصية، والتي ستُلهمني بملاحظات ثانية وثالثة. لحظتها خلّفتْ في نفسي أثرا وإحساسا بالبهجة فخطر ببالي أنني أنا من كتبتها جزءا ثالثا لروايتين سابقتين لي: " زمن الشاوية " و"رائحة الجنة". ثم تأتي روايتها الجديدة "ابن تومرت أو الأيام الأخيرة للملثمين"(ملتقى الطرق، ط2-2021)لتؤكد حالة الذهول، ولأكتشف أن منى هاشم تؤكد كتابها الأول بكتابات في الرواية والتاريخ والبحث الجينيالوجي والروحي للجماعات المغربية. إنها مثل النهر الذي ينهض من باطن الأرض ليروي ويرتوي من الذاكرة والراهن في مجرى لا ينتهي، مليء بالمنعرجات والمفاحآت واللاتوقعات.