 كان رفضه قوياً ولا يقبل المناقشة. كان يرفض بكل إصرار بعد حصوله على جائزة نوبل 1988 جمع مقالاته الفلسفية المبكرة في كتاب موحّد. وتعود وجهة نظره في هذا الرفض. إلى أنه قد كتب هذه المقالات في مطلع شبابه وقبل دخوله عالم الإبداع الروائي. وقد برز إلى الوجود كتّاب متخصصون في الفلسفة، لابدَّ أنهم تجاوزوا هذه الاجتهادات المبكّرة التي لا تعدو تكون اجتهادات الهواة. خاصة بعد نشر اجتهادات زكي نجيب محمود، وفؤاد زكريا، وعثمان أمين. هذا بالإضافة إلى أنه كثيراً ما كان يبدي دهشته عندما تُذكر له عناوين هذه المقالات...
كان رفضه قوياً ولا يقبل المناقشة. كان يرفض بكل إصرار بعد حصوله على جائزة نوبل 1988 جمع مقالاته الفلسفية المبكرة في كتاب موحّد. وتعود وجهة نظره في هذا الرفض. إلى أنه قد كتب هذه المقالات في مطلع شبابه وقبل دخوله عالم الإبداع الروائي. وقد برز إلى الوجود كتّاب متخصصون في الفلسفة، لابدَّ أنهم تجاوزوا هذه الاجتهادات المبكّرة التي لا تعدو تكون اجتهادات الهواة. خاصة بعد نشر اجتهادات زكي نجيب محمود، وفؤاد زكريا، وعثمان أمين. هذا بالإضافة إلى أنه كثيراً ما كان يبدي دهشته عندما تُذكر له عناوين هذه المقالات... مقالات نجيب محفوظ هذه ذات الطابع الفلسفي. والتي صدرت بين دفتي كتاب "حول الأدب والفلسفة". يعود الفضل في إصدار هذا الكتاب إلى الناقد والأديب عبد المحسن طه بدر الذي جمع هذه المقالات وأعدّها خلال تأليف كتابه "نجيب محفوظ الرؤية والأداء" ودفعها للناشر محمد رشاد متعاوناً في ذلك مع كل من فتح العشري ومحمد سلماوي.. إلاَّ أن نجيب محفوظ ظل غير راضٍ عن صدور هذا الكتاب، وظلّت لديه تحفظّات غير معلنة عليه، خاصة أثناء حياة معدِّه عبد المحسن طه بدر، والذي دفع به إلى السوق الأدبية كجزء أول من مشروع أدبي كبير. إلا أن القدر لم يمهله لكي يكمله.
من المعروف أن نجيب محفوظ درس الفلسفة في كلية آداب جامعة القاهرة. وكان دائماً يردّد: "إن دراسة الفلسفة أثّرت كثيراً في تكويني الفكري والأدبي وفي تربيتي عموماً. وقد اهتممت برؤى الفلاسفة المتعددة للعالم من دون أن أنتمي إلى واحدة من هذه الرؤى. ولكن على الرغم من ذلك فإنني لا أستطيع أن أنفي تأثري الشديد بديكارت وشوبنهور وسارتر وكامو.."...
هذا القول يدفعنا للتساؤل وملاحظة أن الفيلسوفين اللذين كان معنيّاً بدراستهما في ردهات الجامعة وفي مقالاته المبكّرة وهما أرسطو وأفلاطون. يغفل ذكرهما ضمن الأسماء السابقة التي أشار إليها.
الكتاب موضوع البحث "حول الأدب والفلسفة" والذي أعدّه الناقد عبد المحسن طه بدر والأديب فتحي العشري، يضم إحدى وعشرين مقالة. بدءاً من مقالة "احتضار معتقدات وتولّد معتقدات" وقد كتبها محفوظ عام 1930 وهو في التاسعة عشرة من عمره، وانتهاءً بمقالة "رسالة مفتوحة إلى سيد قطب" وهي مقالة تدور حول كتاب سيد قطب "التصوير الفني في القرآن الكريم". وكان نجيب محفوظ آنذاك في الرابعة والثلاثين من العمر...



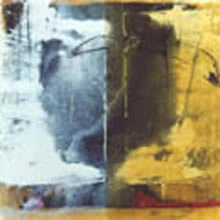 تعريف المذهب :
تعريف المذهب : ارتبط المبدع العربي - منذ القدم - بالمكان ارتباطا وجدانيا ، وهذا ما تجلى ، بشكل واضح، في استهلال الشعراء القدامى معلقاتهم بالبكاء على الأطلال و التغني بالأحبة الراحلين . ربما يتبادر إلى الذهن سؤال عن أسباب الرحيل ، الهجرة ، الانتقال الجغرافي .. بيد أن كل الأجوبة لا تعنينا في شيء ، لأن لا علاقة لهذه السطور بها .. لكننا لا ننكر إسهامات أمين الريحاني وابن بطوطة وغيرهما في ما يعرف ب:(أدب الرحلات .( هذا الجنس الأدبي الذي سيشهد طفرة نوعية - بطريقة أو بأخرى- عند كتابنا العرب ، فأغنوا المكتبة العربية ب"روايات/سيرذاتية حضارية" ، أمثال : توفيق الحكيم (عصفور من الشرق) ، طه حسن (الأيام) ، يحيى حقي (قنديل أم هاشم) ، الطيب صالح (موسم الهجرة إلى الشمال) ، عبدالله العروي(أوراق) ، سهيل إدريس (الحي اللاتيني) ، بهاء طاهر (بالأمس حلمت بك) ، عبدالرحمن منيف (شرق المتوسط) ، حسونة المصباحي (الآخرون) .
ارتبط المبدع العربي - منذ القدم - بالمكان ارتباطا وجدانيا ، وهذا ما تجلى ، بشكل واضح، في استهلال الشعراء القدامى معلقاتهم بالبكاء على الأطلال و التغني بالأحبة الراحلين . ربما يتبادر إلى الذهن سؤال عن أسباب الرحيل ، الهجرة ، الانتقال الجغرافي .. بيد أن كل الأجوبة لا تعنينا في شيء ، لأن لا علاقة لهذه السطور بها .. لكننا لا ننكر إسهامات أمين الريحاني وابن بطوطة وغيرهما في ما يعرف ب:(أدب الرحلات .( هذا الجنس الأدبي الذي سيشهد طفرة نوعية - بطريقة أو بأخرى- عند كتابنا العرب ، فأغنوا المكتبة العربية ب"روايات/سيرذاتية حضارية" ، أمثال : توفيق الحكيم (عصفور من الشرق) ، طه حسن (الأيام) ، يحيى حقي (قنديل أم هاشم) ، الطيب صالح (موسم الهجرة إلى الشمال) ، عبدالله العروي(أوراق) ، سهيل إدريس (الحي اللاتيني) ، بهاء طاهر (بالأمس حلمت بك) ، عبدالرحمن منيف (شرق المتوسط) ، حسونة المصباحي (الآخرون) . 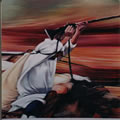 مدخل:
مدخل: تعريف الرومانسية:
تعريف الرومانسية: موضوع الشهرة أو الانتشار الذي يحصده بعض المشتغلين في الحقل الرمزي دون سواهم من الظواهر الإنسانية الأكثر استشكالا ، يتجنب الكثيرون الخوض فيه ، ويربط البعض ممن يقدم على ذلك الشهرة بالعبقرية أو الذكاء الخارق أو النبوغ أو ما شابه هذه الصفات ، و التي و إن كانت تلامس التفسير ، فإنها لا تمسك به. بينما يرد البعض الانتشار بشكل ميكانيكي تبسيطي إلى عوامل من خارج الحقل الرمزي، من الحقل السياسي في الغالب، و من الحقلين الاقتصادي و الإعلامي في حالات عديدة، و من الحقول الثلاثة مجتمعة و متداخلة في أحسن الأحوال. و ضمن كل هذه الأنماط من قراءة ظاهرة الشهرة ، تبقى المنتوجات الرمزية التي من خلالها و بها تحقق الانتشار لصاحبه بعيدة عن كل نبش و حفر و تفكيك ، و الحال أن في ثناياها و بين تضاريسها يوجد التفسير ، أو على الأقل الجزء الأهم منه.
موضوع الشهرة أو الانتشار الذي يحصده بعض المشتغلين في الحقل الرمزي دون سواهم من الظواهر الإنسانية الأكثر استشكالا ، يتجنب الكثيرون الخوض فيه ، ويربط البعض ممن يقدم على ذلك الشهرة بالعبقرية أو الذكاء الخارق أو النبوغ أو ما شابه هذه الصفات ، و التي و إن كانت تلامس التفسير ، فإنها لا تمسك به. بينما يرد البعض الانتشار بشكل ميكانيكي تبسيطي إلى عوامل من خارج الحقل الرمزي، من الحقل السياسي في الغالب، و من الحقلين الاقتصادي و الإعلامي في حالات عديدة، و من الحقول الثلاثة مجتمعة و متداخلة في أحسن الأحوال. و ضمن كل هذه الأنماط من قراءة ظاهرة الشهرة ، تبقى المنتوجات الرمزية التي من خلالها و بها تحقق الانتشار لصاحبه بعيدة عن كل نبش و حفر و تفكيك ، و الحال أن في ثناياها و بين تضاريسها يوجد التفسير ، أو على الأقل الجزء الأهم منه.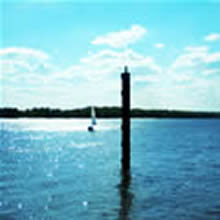 يتفق علماء السرد (Narratology) على أن اغلب قراء القصة القصيرة يشهدون بأن القص الجميل يمكن أن يصل إلى أعلى مراتب الفنون، وخاصة عندما يقبض موضوعها على هم إنساني كبير. فالقاص المجيد يطول بقلمه ما تطوله الفنون الأخرى، تقنية وإخراجا حيث يقود قصته شكلا ومضمونا لما تصل إليه تقنيات التكنولوجيا في السينما الحديثة، ويستطيع ان يحملها موسيقى هائلة، ويوقعها في نفس قارئه، وتظل تلازمه حتى وان انتهت القراءة فالنص الجميل سوف يبقى في الذهن يطارد قارئه، يمسك به لأجل أن يعود إليه مستدرجا اللذة إلى كمّها الأخير.. (فإذا كان الحب يعمي عن المساوئ، فالبغض أيضا يعمي عن المحاسن. وليس يعرف حقائق مقادير المعاني، ومحصول حدود لطائف الأمور، إلا عالم حكيم، ومعتدل الأغلاط عليم، والقوي المنة، الوثيق العقدة، والذي لا يميل مع ما يستمل الجمهور الأعظم، والسواد الأكبر- الجاحظ)، فإذ تتشكل كل مرة بمنظور جديد، وتعطي ذاتها كل مرة معاصرة لأحداث قد تنبأ النص بها، فالذهن يقارن اليوم وغداً، ويستشرف دائماً من خلال الإبداع، المهارة، والاستباق.. وقد اثبت المبدع (حسن كريم عاتي) في كتابه الصادر عن دار الشؤون الثقافية (2007م)، الموسوم بـ(عزف منفرد) بان فن القصة يستطيع ان ينافس الفنون الأخرى، شكلا ومضمونا إن توافر على مادة شيقة قد تكامل فيها كل ما يؤشر لصالح الكتابة المبدعة، حيث جاءت القصص (ألاثني عشر) بلغة متينة ارتقت إلى التعدد في المعنى، لتقرأ أكثر من مرة بتمحيص بحثا عن الاكتشاف الممتع لما فيها من جهد أنساني رفيع يبشر بتأشير جليل على خريطة الإبداع العراقي المتمكن، فتبلورت في جملة جماليات مقتدرة أجادها القاص المتمكن من سرد استنبط الأسس التي قامت بعقلانية من خلال نظم واضحة التعبير حكمت نتاجه وتلقيه.. في قص يأخذ القارئ ليركب بحرا عظيم اللجّة متلاطم الأمواج، ما بين موت محدق، وحياة حرّة كريمة..قصة مواجهه ذئب جسور وأنثاه الشرسة.. بتحدّ هائل الوقع أتقن القاص تصويره بموضوعية حاسمة دقيقة التفصيل… فـ(القصة الأولى- ليل الذئاب) بدأت فيها أنثى الذئب بالعواء التواصل لأجل ذكرها المقتول في غارة على قطيع تعودا النهش فيه كل ليلة حدّ الفناء.. ذئبان قويا الشكيمة، هما اللذان شكلا خطرا بليغا على الإنسان، وكلبه، وقطيعه.. بعد أن تعودا على إهانة ملكيته، وهدر كرامته، صار الصراع حتميا لن ينتهي إلا بالفصل القائم بالسلاح المواجه بكل مشروعيه، وعقلانية.. مصرا فيها الإنسان على احتراف قدره العظيم في الغلبة الدائمة على ظهر هذه البسيطة.. حيث يحفر حفرة دفاع أعدت بعد تفكير ملي.. لذلك الشأن وبقي بداخلها في ليل طويل ماطر، متشبثاً بالبندقية حبل خلاصه الذي لا يريم، إذ يصيب مقتلا في إلتماع العينين المتوقدة بالفتك.. بعد صبر، وخبرة الأربعين الرصينة.
يتفق علماء السرد (Narratology) على أن اغلب قراء القصة القصيرة يشهدون بأن القص الجميل يمكن أن يصل إلى أعلى مراتب الفنون، وخاصة عندما يقبض موضوعها على هم إنساني كبير. فالقاص المجيد يطول بقلمه ما تطوله الفنون الأخرى، تقنية وإخراجا حيث يقود قصته شكلا ومضمونا لما تصل إليه تقنيات التكنولوجيا في السينما الحديثة، ويستطيع ان يحملها موسيقى هائلة، ويوقعها في نفس قارئه، وتظل تلازمه حتى وان انتهت القراءة فالنص الجميل سوف يبقى في الذهن يطارد قارئه، يمسك به لأجل أن يعود إليه مستدرجا اللذة إلى كمّها الأخير.. (فإذا كان الحب يعمي عن المساوئ، فالبغض أيضا يعمي عن المحاسن. وليس يعرف حقائق مقادير المعاني، ومحصول حدود لطائف الأمور، إلا عالم حكيم، ومعتدل الأغلاط عليم، والقوي المنة، الوثيق العقدة، والذي لا يميل مع ما يستمل الجمهور الأعظم، والسواد الأكبر- الجاحظ)، فإذ تتشكل كل مرة بمنظور جديد، وتعطي ذاتها كل مرة معاصرة لأحداث قد تنبأ النص بها، فالذهن يقارن اليوم وغداً، ويستشرف دائماً من خلال الإبداع، المهارة، والاستباق.. وقد اثبت المبدع (حسن كريم عاتي) في كتابه الصادر عن دار الشؤون الثقافية (2007م)، الموسوم بـ(عزف منفرد) بان فن القصة يستطيع ان ينافس الفنون الأخرى، شكلا ومضمونا إن توافر على مادة شيقة قد تكامل فيها كل ما يؤشر لصالح الكتابة المبدعة، حيث جاءت القصص (ألاثني عشر) بلغة متينة ارتقت إلى التعدد في المعنى، لتقرأ أكثر من مرة بتمحيص بحثا عن الاكتشاف الممتع لما فيها من جهد أنساني رفيع يبشر بتأشير جليل على خريطة الإبداع العراقي المتمكن، فتبلورت في جملة جماليات مقتدرة أجادها القاص المتمكن من سرد استنبط الأسس التي قامت بعقلانية من خلال نظم واضحة التعبير حكمت نتاجه وتلقيه.. في قص يأخذ القارئ ليركب بحرا عظيم اللجّة متلاطم الأمواج، ما بين موت محدق، وحياة حرّة كريمة..قصة مواجهه ذئب جسور وأنثاه الشرسة.. بتحدّ هائل الوقع أتقن القاص تصويره بموضوعية حاسمة دقيقة التفصيل… فـ(القصة الأولى- ليل الذئاب) بدأت فيها أنثى الذئب بالعواء التواصل لأجل ذكرها المقتول في غارة على قطيع تعودا النهش فيه كل ليلة حدّ الفناء.. ذئبان قويا الشكيمة، هما اللذان شكلا خطرا بليغا على الإنسان، وكلبه، وقطيعه.. بعد أن تعودا على إهانة ملكيته، وهدر كرامته، صار الصراع حتميا لن ينتهي إلا بالفصل القائم بالسلاح المواجه بكل مشروعيه، وعقلانية.. مصرا فيها الإنسان على احتراف قدره العظيم في الغلبة الدائمة على ظهر هذه البسيطة.. حيث يحفر حفرة دفاع أعدت بعد تفكير ملي.. لذلك الشأن وبقي بداخلها في ليل طويل ماطر، متشبثاً بالبندقية حبل خلاصه الذي لا يريم، إذ يصيب مقتلا في إلتماع العينين المتوقدة بالفتك.. بعد صبر، وخبرة الأربعين الرصينة.
 يعتبر الوشم تقليدا طقوسيا عريقا وموغلا في الثقافة الأمازيغية، وغالبا ما يرتبط بالنظام القيمي أو الثقافي لدى المجتمع الأمازيغي الذي مارسه، أو بتقاليده ومعتقداته وديانته، فالإنسان الأمازيغي كان يعيش في عالم من الرموز والعلامات والقوانين التي يقصد بها التأكيد على انتمائه إلى هويته الأمازيغية، فهو إذن أسلوب ذو مضمون ثقافي أو ديني أو إجتماعي له علاقة وثيقة بالتفكير الأسطوري أو الفلكلوري كما يمكن أن يكون ذا مضمون جنسي ـ كما سنرى ـ خاصة عند المرأة الأمازيغية التي تتزين بالوشم في غياب المساحيق الملونة قصد التميز عن الرجل (1) ، ولقد ظل الوشم عبر العصور برموزه وأشكاله وخطوطه من بين أهم وسائل الزينة وتجلياتها القارة والدائمة على أجزاء معينة من جسد المرأة خاصة الوجه واليدين والرجلين(2). ويكتسي الوشم في ظاهره وباطنه دلالات عديدة وعميقة، فهو يأخذ من جسم الانسان فضاء للتدوين والكتابة ولوحة للرسم والخط (3). تقول الشاعرة الأمازيغية في هذا الصدد:
يعتبر الوشم تقليدا طقوسيا عريقا وموغلا في الثقافة الأمازيغية، وغالبا ما يرتبط بالنظام القيمي أو الثقافي لدى المجتمع الأمازيغي الذي مارسه، أو بتقاليده ومعتقداته وديانته، فالإنسان الأمازيغي كان يعيش في عالم من الرموز والعلامات والقوانين التي يقصد بها التأكيد على انتمائه إلى هويته الأمازيغية، فهو إذن أسلوب ذو مضمون ثقافي أو ديني أو إجتماعي له علاقة وثيقة بالتفكير الأسطوري أو الفلكلوري كما يمكن أن يكون ذا مضمون جنسي ـ كما سنرى ـ خاصة عند المرأة الأمازيغية التي تتزين بالوشم في غياب المساحيق الملونة قصد التميز عن الرجل (1) ، ولقد ظل الوشم عبر العصور برموزه وأشكاله وخطوطه من بين أهم وسائل الزينة وتجلياتها القارة والدائمة على أجزاء معينة من جسد المرأة خاصة الوجه واليدين والرجلين(2). ويكتسي الوشم في ظاهره وباطنه دلالات عديدة وعميقة، فهو يأخذ من جسم الانسان فضاء للتدوين والكتابة ولوحة للرسم والخط (3). تقول الشاعرة الأمازيغية في هذا الصدد:








