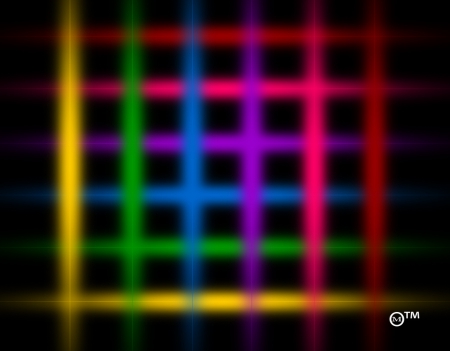 يؤشر السياسي في علاقته بالفلسفي على تاريخ مرير وملغوم . توجس الفلسفي من السياسي المتربص به مثل ظله جعل الفلسفي يترنح في شباك السياسي ويسقط في متاهته.
يؤشر السياسي في علاقته بالفلسفي على تاريخ مرير وملغوم . توجس الفلسفي من السياسي المتربص به مثل ظله جعل الفلسفي يترنح في شباك السياسي ويسقط في متاهته.
ابتلع الفلسفي طعم السياسي الى حد الانحلال والحلول فيه . بدل أن يحاكم الفلسفي السياسي أضحى السياسي القاضي والفلسفي الضحية المتهم . لم يقف الأمر عند مرافعةالفلسفي عن العار الذي لحقه من لعنة السياسي وفي محكمة السياسي بل سينصب الفلسفي من نفسه المشرع للسياسي والحامي لعرشه .
تلك كانت البداية كما دشنتها الذاكرة اليونانية مع المحاكمة السقراطية التي تفننت العبقرية الافلاطونية في رسم معالمها الملحمية الأشد إثارة لحكاية الفلسفي والسياسي .
قد تكون تلك البداية بمثابة إعلان عن النهاية المأساوية للفلسفي والسياسي وإيذانا بشريعة العنف والقتل في نفس الآن...!
لعل ما تلى ذلك من قرون لم يكن ذَا أهمية تذكر اللهم إلا مشاهد من فصول تلك المسرحية. تتعدد فيها الأدوار، يتبادل خلالها الفلسفي والسياسي المواقع . احيانا كي تتحركتلك المحكمة وتحرك دواليب اجهزتها وتحشد عتادها، من دعاوى ومتكآت حجاجية ، تستنفر همم الفلسفي لكي يطلق العنان لمخيلته قصد السبح في عالم الميتافيزيقياتوالمجردات ويصطاد ماندر من المعزوفات والمرويات والكائنات المفاهيمية ومن الشخصيات المفهومية ...لتزيين ممالك السياسي وترصيع أركان تلك المحكمة حتىلايصيبها الاهتراء والتآكل .
النقد مقاصده وآلياته عند محمد أركون ـ خالد بنشانع
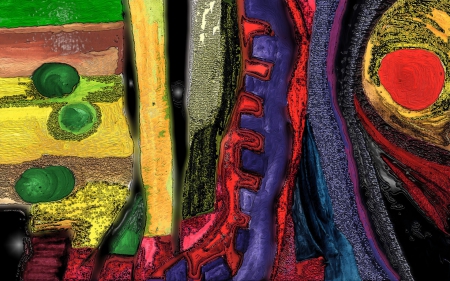 تصميم الموضوع:
تصميم الموضوع:
1- النقد عند أركون ومقاصده
2- الآليات المنهجية المعتمدة في قراءة التراث
أ- المنهج النقدي التاريخي
ب-المنهج الألسني السيميائي
ت-منهج علوم الإنسان والاجتماع
3-استنتاجات
الملخص التنفيذي:
شكل النقد عند محمد أركون آلية جوهرية في بناء مشروعه الفكري. إنه نقد يسعى من خلاله إلى تأسيس شروط الخطاب الإسلامي التنويري، من خلال تفكيكه والبحث عن القوى الارتكاسية التي أدت إلى هيمنة خطاب فكري عدمي يحد من إبداعية الفكر ويقدم الصورة الوثوقية التي تجعل من ثقافة التحريم والتحليل المقصد الأساس من الدين، لذلك استدعى عدة مناهج حديثة غايتها الأساس إعادة تجديد التراث الإسلامي بما يستجيب لمتطلبات العصر. وقد شكلت كونية المعرفة ونسبيتها الموجهان الأساس في دراسة أركون للتراث، معتمدا في ذلك على النقد البناء ومناهج حديثة لتجاوز سوء الفهم في قراءة التراث.
إن قراءة أركون للتراث ليست مجرد إجابات لأسئلة عالقة، بقدر ما أنها مشاريع مقدمة للباحثين، للأخذ بالوسائل والمناهج المعاصرة التي يمكن أن تبسط على التراث الإسلامي لاستجلاء مآزقه وفي نفس الآن الوقوف على مكاسبه الإيجابية قصد استعادته للرقي بالعالم الإسلامي.
البعد الروحي لإشكالية الدين والسياسة في الفكر الطهائي ـ أيوب كنفاوي
 لا تخرج كتابات "طه عبد الرحمن "عن نطاق بناء مشروع فكري ثقافي إسلامي مرتبط بالمجال التداولي؛ لأنه كلما كان متصلا بمجاله التداولي؛ يمكن أن ينتج معرفة؛ومن ثم يتحرر من التقليد، وقد اكتسب هذا المفكر من هذا المجال خبرة معرفية ولغوية وروحية خاضها مند عقود،فمشروعه الفكري واسع ومتسق؛وأبحاثه تدور كلها حول مجالات معرفية عديدة أبرزها التداوليات،والترجمات،والأخلاقيات،مما جعلنا نفترض مند البداية أن هناك بعدا روحيا يعالج من خلاله اشكاليته في ما بين الدين والسياسة.
لا تخرج كتابات "طه عبد الرحمن "عن نطاق بناء مشروع فكري ثقافي إسلامي مرتبط بالمجال التداولي؛ لأنه كلما كان متصلا بمجاله التداولي؛ يمكن أن ينتج معرفة؛ومن ثم يتحرر من التقليد، وقد اكتسب هذا المفكر من هذا المجال خبرة معرفية ولغوية وروحية خاضها مند عقود،فمشروعه الفكري واسع ومتسق؛وأبحاثه تدور كلها حول مجالات معرفية عديدة أبرزها التداوليات،والترجمات،والأخلاقيات،مما جعلنا نفترض مند البداية أن هناك بعدا روحيا يعالج من خلاله اشكاليته في ما بين الدين والسياسة.
لا أحد يجادل بأن هناك صعوبة للإحاطة بمجمل القضايا التي قدمها "طه عبد الرحمن "في كتابه "روح الدين"، ولاسيما مقاربته الروحية التي يحاول من خلالها إعادة النظر في الاعتقادات الراسخة والمسلمات المقررة ؛إذ يقول "أن مقاربته هذه؛ ليست بتاريخية،ولا سياسية ولا اجتماعية ولا قانونية،ولا فقهية ،ولا فكرانية ،وإنما روحية، أو قل مقاربة ذكرية غير أفقية .." من خلال هذا القول يظهر أن مشروع "طه عبد الرحمن" الجديد يسعى من خلاله إلى إعادة النظر في الاعتقادات التي يضمرها الطرف الآخر؛ والتي من خلالها يجدد تعريف الدين ووظيفته الاجتماعية والسياسية والثقافية في مجال تدبير الصلة بين فعل التعبد وفعل التدبير .
العقل الأنثوي في تاريخ الفلسفة .. غياب أم تغييب ـ يوسف عدنان
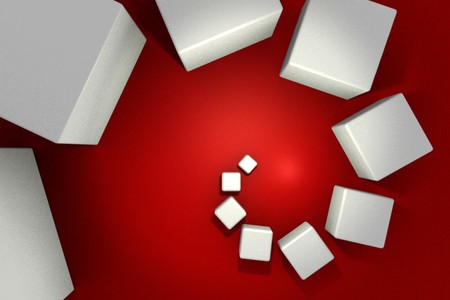 افتقر تاريخ الفلسفة لأصوات نسوية استطعن أن يخترقن القلاع الفكرية المشيّدة بإحكام من قبل الوعي الذكوري المتغطرس، بل تكاد تخلو القواميس المعرّفة بالفلاسفة من أسماء فيلسوفات سجّلن حضورهن على نحو متشظّي عبر محطات تاريخ الفلسفة. وقد تهاطلت العديد من الأسئلة اللاّسعة على هذا الإقصاء المتعمّد، إن لم نقل الممنهج للمرأة في أن تكون وجه آخر للمعرفة الممكنة حول قضايا أنطولوجية و أخلاقية و معرفية تمّس الإنسان، هذا الكائن ذو الطبيعة المزدوجة. ويمكن التقاط ضمن هذا التاريخ المنسي أسماء بعض الملقوبات بالفيلسوفات {كاسباسيا} صاحبة الصالون الذي كان يرتاده أفلاطون في أثينا، وهي المرأة التي كان لها دور بارز في السياسة، والتي يذكرها في محاوراته لبلاغتها صديقه بركليس. كما كان هناك {ديوتيما} معلمة سقراط التي أدار حولها حديث الحب السقراطي في المأدبة (1).
افتقر تاريخ الفلسفة لأصوات نسوية استطعن أن يخترقن القلاع الفكرية المشيّدة بإحكام من قبل الوعي الذكوري المتغطرس، بل تكاد تخلو القواميس المعرّفة بالفلاسفة من أسماء فيلسوفات سجّلن حضورهن على نحو متشظّي عبر محطات تاريخ الفلسفة. وقد تهاطلت العديد من الأسئلة اللاّسعة على هذا الإقصاء المتعمّد، إن لم نقل الممنهج للمرأة في أن تكون وجه آخر للمعرفة الممكنة حول قضايا أنطولوجية و أخلاقية و معرفية تمّس الإنسان، هذا الكائن ذو الطبيعة المزدوجة. ويمكن التقاط ضمن هذا التاريخ المنسي أسماء بعض الملقوبات بالفيلسوفات {كاسباسيا} صاحبة الصالون الذي كان يرتاده أفلاطون في أثينا، وهي المرأة التي كان لها دور بارز في السياسة، والتي يذكرها في محاوراته لبلاغتها صديقه بركليس. كما كان هناك {ديوتيما} معلمة سقراط التي أدار حولها حديث الحب السقراطي في المأدبة (1).
ومن الجدير بالذكر أن تاريخ الفلسفة لا يخلو من تواريخ وحجج دامغة في كون النساء قد لعبن دورا مهماً وكنّ فاعلات للغاية في المدرسة الفيثاغورية، بحيث كان لهنّ دور هام في تطور الفيثاغورية الأولى كفلسفة طال إشعاعها المجتمع الإثيني. ومن أبرز هؤلاء النسوة الفلاسفة في تلك المدرسة نجد {ثيانو} و{أريجنوت} و{مييا} . كما شهدت الفترة الفيثاغورية المتأخرة أعلام من النساء من قبيل {إيزارا اللوكانية} و{فينتس الإسبرطية} و{بركيتوني الأولى} و{إيزارا}، وهذه الأخيرة هي صاحبة الحكمة الشهيرة: «إذا قمنا بتحليل النفس فسوف نفهم القانون والعدالة على المستوى الفردي والأسري والاجتماعي»، وهي التي قدّمت فكرة القانون الطبيعي ليشمل الفرد والأسرة، ليتطارحها بعدها الفلاسفة. أما {فينتس} فألفت كتابا فلسفيا تحت عنوان »الاعتدال عند النساء « لكن ضلّ هذا المؤلف هو الآخر في طيّ الفقدان ككثير من الكتب التي ضاعت في ثنايا التاريخ المنحاز. أما {بركيتوني} فلها كتاب اسمه » هارمونيا النساء « . وفي الفترة ما بعد المسيحية نعتر على اسم {ماكرينا} القديسة الفيلسوفة التي عاشت في القرن الرابع الميلادي (2).
التباسات فلسفة الطبيعة ـ د.زهير الخويلدي
 "ما جميع الأشياء إلا أسماء أطلقها البشر عليها، واعتقدوا في صدقها، مثل الكون والفساد، الوجود واللاّوجود، النقلة في المكان، و تغير اللون الساطع."
"ما جميع الأشياء إلا أسماء أطلقها البشر عليها، واعتقدوا في صدقها، مثل الكون والفساد، الوجود واللاّوجود، النقلة في المكان، و تغير اللون الساطع."
بارمنيدس، قصيدة في الطبيعة
فلسفة الطبيعة هي عبارة ملتبسة ويعود أصل الالتباس في مظاهره المتعددة إلى ما يلي:
- في الحقبة الكلاسيكية يطلق على الفيزياء اسم فلسفة الطبيعة ويشير المصطلح إلى مضمون علمي بشكل حصري ويمكن الاستناد إلى كتاب نيوتن "المبادئ الرياضية للفلسفة الطبيعية" (1687).
- فلسفة الطبيعة في القرن 19 تعني مجموع التأملات للمثالية الألمانية ( فيخته- شيلنغ وهيجل).
- يمكن استعمال هذا المصطلح في الإشارة المرجعية إلى شبكة من المشاكل الضرورية في فهم العالم مثل: كيف تصير الطبيعة مدركة؟ هل تصير الطبيعة أمرا مفهوما بالاعتماد على خصائصها أو أن الضروري في معرفتنا لها قد تم حمله بواسطة جهازنا العرفاني؟ وكيف حاز التصور الحديث للطبيعة على التناغم المطلوب؟ وهل ثمة حقيقة في ذاتها تعرف بواسطة الحدس والصورية البشرية أم أن عالمنا ليس شيئا آخر سوى مظهر؟ هل تجريدات الفيزياء مشروعة أم أنها تحرف الواقع؟ وهل تخترق هذه التجريدات العالم أم أنها تهمش معطيات هامة؟ هل الكون محدد؟ كيف يكون متفقا مع تجربتنا في الحرية؟ وألا توجد هوة سحيقة بين الفيزيائي والذهني؟ وهل يقدر العلم على إعطاء تفسير موحد للعالم؟ كيف نفسر النجاح الذي أحرزته الرياضيات والفيزياء الرياضية في مجال فهم العالم الفيزيائي؟
تنقل مفهوم "العقل" حتى القرن 13م ـ عبد السلام بن ميس
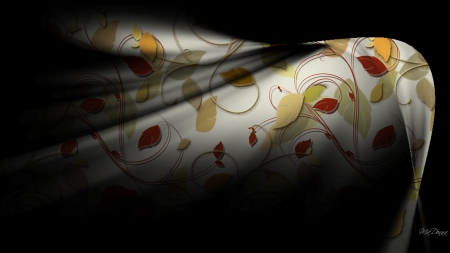 مقدمة:
مقدمة:
في هذا المقال ننوي فحص مفهوم أساسي طال حوله الجدل منذ أرسطو، على الأقل، حتى الآن، وهو مفهوم "العقل". غير أن مهمتنا لن تسهل لأن مفهوم العقل لا يحيل في الواقع على فكرة بسيطة، بل على مجموعة من الأفكار؛ لأن العقل جزء من موضوع واسع تجادل العلماء والفلاسفة حوله كثيرا هو موضوع "النفس ووظائفها". أضف إلى ذلك أن مفهوم العقل ليس إنتاجا ثقافيا بسيطا. فلقد تناوله، من قريب أو من بعيد، أغلب المثقفين القدامى والقروسطويين. فنحن نجده عند اليونان القدامى وعند المسلمين المشارقة والمغاربة، وعند اليهود والمسيحيين وعند الهنود وغيرهم.
تاريخيا، يعتبر أرسطو أول من تناول مفهوم العقل تناولا فلسفيا، وذلك في كتاب له تحت عنوان: في النفس (Péri Psukhês). حسب هذا الفيلسوف، تحيل كلمة نفس (Psukhê) على ملكات مختلفة: الملكة الغاذبة التي تقتصر عليها النباتات والملكة الحسية التي تشترك فيها كل الكائنات الحية والملكة العاقلة التي يختص بها الإنسان. ويكمن الفرق بين هذه الملكات في كون الأولى تتناول المادة ذاتها بينما الثانية والثالثة تتناولان الصور. ورغم كون الحيوان والإنسان يشتركان فيهما فإن الأول يقتصر فقط على معرفة الفرد والصور الفردية، أما الإنسان، وهو الذي يتمتع بالعقل، فيستطيع معرفة الصور الكلية.
انطلاقا من هذه الأوليات حول النفس ووظائفها، يكون أرسطو أول من أنزل مفهوم العقل (oû) إلى ميدان الدرس الفلسفي. لقد اعتبره عنصرا أساسيا في الفعل المعرفي البشري. وبناء على الثنائية الأرسطية صورة/مادة، يعرف أرسطو النفس باعتبارها "صورة للجسد". لقد رفض أرسطو الثنائية الأفلاطونية روح/جسد ورفض اعتبار هاذين الأخيرين كينونتين مستقلتين. فلا يعترف أرسطو بوجود للنفس في استقلال عن الجسد.
ركائز المشروع الفلسفي ـ د.زهير الخويلدي
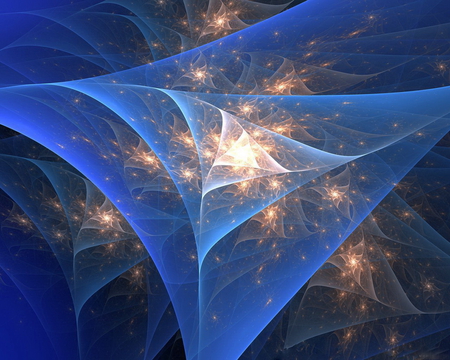 " إن فعل التفكير هو في حد ذاته مشروع خطير جدا ولكن عدم التفكير هو أيضا أكثر خطورة"
" إن فعل التفكير هو في حد ذاته مشروع خطير جدا ولكن عدم التفكير هو أيضا أكثر خطورة"
- حنة أرندت-
يصعب على المرء دراسة التفكير الفلسفي دون المرور بقضية ماهية الفلسفة وحدّها الجامع المانع ولكن عدد قليل من الفلاسفة حاول تقديم جواب شاف عن السؤال الشائك: ما الفلسفة؟، وهذا الأمر في الحقيقة مثير للاستغراب والدهشة بالنظر لانتماء معظمهم إلى المشروع الفلسفي ومساهمتهم في تركيز دعائمه.
لم يتفق الفلاسفة حول تعريف دقيق ونهائي للفلسفة ولا يوجد أمر معين اختلفوا حوله وتخاصموا أكثر من تعريفها إلى درجة أن بعض المؤرخين نفى إمكانية حصول اتفاق في العمق حول الأساس الذي يقوم عليه المشروع الفلسفي والمضمون الحي الذي تقوم الخبرة الفلسفية بتحليله والمقصد الذي يسعى الفيلسوف من خلال ممارسته وأفعاله وسيرته تحقيقه وبلوغه والمنهج الذي يجدر بكل تفلسف فعلي أن يتبعه ويسلكه.
لم يسبق أن تعرضت الفلسفة إلى التجاهل والاستخفاف من قبل العامة والخاصة لمثل ما تتعرض له زمن العولمة المتوحشة والثقافة الاستهلاكية ومجتمع الفرجة وبعد سيطرة الصورة وظهور أنماط الاستنساخ.
لماذا لم يعد الاحترام محترما؟ ـ د.زهير الخويلدي
 " لا يمكن احترام أعداء الاحترام... ولن يقدر مجتمعنا على المحافظة على ذاته بلا احترام الآخر"[1]
" لا يمكن احترام أعداء الاحترام... ولن يقدر مجتمعنا على المحافظة على ذاته بلا احترام الآخر"[1]
وقعت البشرية في خلط كبير بين رقمنة الحياة اليومية بتسريع المعلومة وإيجاد أشياء وراء أشياء وتشكيل غيوم سوداء تحجب الظواهر وتدرك معارف بلا قوة وتعميم بلا تخصيص وتزاوج غير متوقع بين كيانات متنافرة وتقوم ببرمجة الغباء وتخزين الذكاء وتعقيد المنظور وإنتاج كميات بلا كيفيات. لقد أدى استبدال الواقعي بالافتراضي بالانتقال من النظرة المادية للكون في الحقبة الصناعية إلى قيام الباراديغم الرقمي في الحقبة مابعد الصناعية وإلى ضياع التقدم وتشكل رؤية جديدة للعالم تقوم على الفوضى والصدمة والعماء.
لم تكن الثورة الصناعية هي المحرك الوحيد الذي قاد إلى السيطرة على الطبيعة بواسطة التقنية وإنما تأسست النزعة الانسانوية على قاعدة المواءمة مع قوانين الكون والتفتيش عن نعم السعادة بتفادي الآلام.
لقد جعلت الحداثة من التقدم عربة مركزية في قطار التاريخ وقرنت بين العلم والتقنية وحاولت التكييف بين العقل والطبيعة وبين الاقتصاد والسياسة وبين الأعمال والمال ولكنها اعتدت على الكثير من القيم على غرار المحبة والخير والفضيلة وضربت ثقة الإنسان في العناية الإلهية وزعزعت يقينه في استمرار كيانه.
يوجد خلل في علاقة الإنسان بالحضارة من جهة وفي صلته بالطبيعة من جهة أخرى فهو يضاعف من احترامه للمصنوع بصورة تقنية ولكنه في المقابل يعلن استخفافه من الظواهر الطبيعية ولا يذعن لها.
ما يلفت الانتباه هو قلة الاحترام التي تبدو على الإنسان المعاصر تجاه قيمة الاحترام في حد ذاتها وبالتالي فإن عدم احترامه للاحترام هو من الأمور غير المفهومة بالنظر إلى أن تبجيل المرء للطبيعة مسألة قديمة والى أنه يحتاج إلى الاحترام مثل احتياجه إلى التقدير وأنه يمن في منحه على الآخرين ويضع شروطا. لكن هل الاحترام واجب أم حق؟ وما شروطه؟ ومن يستحقه؟ وماذا عليّ أن أفعل لكي أكون محترما؟ وماذا كان ينبغي أن أفعل لكي أحترم غيري؟ ولماذا لم يعد الاحترام في حد ذاته محل احترام اليوم؟
جذر الخلاف الفلسفي بين "العلمانية" و"الدين" ـ مهند ديب
 فلسفياً، يمكن القول إن الإنسان منذ نشأته ينشد "الحقيقة المطلقة"، ولأن كانت هذه "الحقيقة المطلقة" هي من حكمت نزوع العقل البشري نحو "المعرفة"، نجد الكثير من النظريات والمدارس الفلسفية التي تناولت "المعرفة" مفهوماً وموضوعاً، بمجمل أبعاد شروطها أو تحديداتها، بل وحتى إمكانات وجودها أو قيامها، إلا أننا نعتقد بأنّ مجمل هذه "النظريات" و"المدارس" الفلسفية، بقيت تدور ـ على كثرتهاـ في فلكِ خلافٍ جوهريٍّ، تمثل بأهم منعطف تاريخي في حياة البشرية، وهو التطور الذي بدأ مع منتصف القرن الخامس عشر، الذي قسم الوجود الإنساني بين عالمين: (العالم القديم) و(العالم الحديث)، أي بين (الكوكبية) و (الكونية)، و بالتالي بين مفهومي "وحدة المعرفة" و "جزئية المعرفة"، والذي يعني بين "الدين" بمعناه الأعم "المفارق"، وهو القانون الذي يقضي بأنَّ "هذا الوجود غير مكتفٍ بذاته"، على خلاف "العلمانية" بمعناها الأعم "الموضوعي"، وهي القانون الذي يقضي بأنَّ "هذا الكون مكتفٍ بذاته"، وليس بحاجة للامتثال لأي مفهوم "مفارق"..
فلسفياً، يمكن القول إن الإنسان منذ نشأته ينشد "الحقيقة المطلقة"، ولأن كانت هذه "الحقيقة المطلقة" هي من حكمت نزوع العقل البشري نحو "المعرفة"، نجد الكثير من النظريات والمدارس الفلسفية التي تناولت "المعرفة" مفهوماً وموضوعاً، بمجمل أبعاد شروطها أو تحديداتها، بل وحتى إمكانات وجودها أو قيامها، إلا أننا نعتقد بأنّ مجمل هذه "النظريات" و"المدارس" الفلسفية، بقيت تدور ـ على كثرتهاـ في فلكِ خلافٍ جوهريٍّ، تمثل بأهم منعطف تاريخي في حياة البشرية، وهو التطور الذي بدأ مع منتصف القرن الخامس عشر، الذي قسم الوجود الإنساني بين عالمين: (العالم القديم) و(العالم الحديث)، أي بين (الكوكبية) و (الكونية)، و بالتالي بين مفهومي "وحدة المعرفة" و "جزئية المعرفة"، والذي يعني بين "الدين" بمعناه الأعم "المفارق"، وهو القانون الذي يقضي بأنَّ "هذا الوجود غير مكتفٍ بذاته"، على خلاف "العلمانية" بمعناها الأعم "الموضوعي"، وهي القانون الذي يقضي بأنَّ "هذا الكون مكتفٍ بذاته"، وليس بحاجة للامتثال لأي مفهوم "مفارق"..
إنّ التطور الذي طرأ مع بداية منتصف القرن الخامس عشر، يمكن تلخيصه بثلاث محطات رئيسية، ساهمت بشكل رئيسي في إحداث القطيعة المعرفية الفلسفية مع "العالم القديم"، التي كانت قد حكمت الرؤية الإنسانية على مدى ألفي عام، وهي:
ـ أولا: "ثورة الأفلاك السماوية" التي نسف بها "نيكولاس كوبرنيكوس" الاعتقاد القديم عن مركزية الأرض.
ـ ثانياً: "ثورة الفيزياء الحديثة" التي دمر بها "جاليليو" المقولات القديمة للفيزياء.
ـ ثالثاً: وهي الثورة الأهم التي توّجها "إسحاق نيوتن" في وضعه لمبادئ الحركة وقانون الجاذبية الكونية.
في تجلّيات كسوف الفلسفة ـ يوسف عدنان
 تواجه الفلسفة في كل حقبة زمنية تخلو، امتحانا عسيرا من طرف أحداث العصر الذي تعايشه، بغية إثبات أحقّيتها التاريخية في التّقول حول الإنسان، هذا الكائن المسكون باللغة، المطارد بالزمن، المنفرد بالعقل، والمدفوع بالرغبة. ومن الأكيد أن الفكر الفلسفي لم ينضج بين ليلة وضحاها، كما أن روما لم تبن في يوم واحد، قائلا المثل. وإنما عرف تاريخ الفلسفة هو كذلك لحظات اتّسمت بالتّوهج و الانشراح الذهني و لهفة العقل للمعرفة و بلوغ الحقيقة، و أخرى لازمها الجمود وانشغال الفلاسفة بهموم سالفيهم، كالمرحلة القروسطية التي خيّم عليها مناخ مدرسي سكولائي، جعل منه ينعت »بعصر السبات الفلسفي « . ليعرف الفكر مجدّدا كل حديث مشرق، بداية مع عصر النهضة الذي استنهض معه بوادر سؤال الذات، مرورا بالتّنوير الذي مّد جسوره الحديدية واصلا بشطر من التاريخ إلى حداثة، أقل ما يمكن القول حولها، أنها متاخمة عند الغرب ووافدة عند الشرق.
تواجه الفلسفة في كل حقبة زمنية تخلو، امتحانا عسيرا من طرف أحداث العصر الذي تعايشه، بغية إثبات أحقّيتها التاريخية في التّقول حول الإنسان، هذا الكائن المسكون باللغة، المطارد بالزمن، المنفرد بالعقل، والمدفوع بالرغبة. ومن الأكيد أن الفكر الفلسفي لم ينضج بين ليلة وضحاها، كما أن روما لم تبن في يوم واحد، قائلا المثل. وإنما عرف تاريخ الفلسفة هو كذلك لحظات اتّسمت بالتّوهج و الانشراح الذهني و لهفة العقل للمعرفة و بلوغ الحقيقة، و أخرى لازمها الجمود وانشغال الفلاسفة بهموم سالفيهم، كالمرحلة القروسطية التي خيّم عليها مناخ مدرسي سكولائي، جعل منه ينعت »بعصر السبات الفلسفي « . ليعرف الفكر مجدّدا كل حديث مشرق، بداية مع عصر النهضة الذي استنهض معه بوادر سؤال الذات، مرورا بالتّنوير الذي مّد جسوره الحديدية واصلا بشطر من التاريخ إلى حداثة، أقل ما يمكن القول حولها، أنها متاخمة عند الغرب ووافدة عند الشرق.
وما دامت الفلسفة ذات خصّيصة كونية، تخاطب المشترك الإنساني، فلا يجوز أن لا نستحضر ولو بالإشارة العابرة متون الفلاسفة المسلمين، انجلت في طيّاتها اشكالات حقبة برّمتها، لم يكتب لها هي كذلك أن تثمر وتطول، في بيئات يغمرها جنون السلاطين والحكام، وتهكّم لا مبرر من قبل العامة على الفلاسفة، بكلّ ما في ذلك من قذف وتسفيه وتكفير* . هذا بعد تفضيل النص الفقهي على النص القرآني على صعيد اجتماعيات التّدين، ليشهد العقل العربي سكونا وتعبدّا في محراب التراث، لا نحن متمسّكين به أو بتاركيه، مادام مفهوم القطيعة في مجتمعاتنا التراثية لم يثبت يوما أنه أنهى المعركة لصالحه. ليظل مجرد توصيف لحال عديم الشكل ليس إلا. مثيرا هذا الوضع من جهته، شكوكا وقلقا لدى مجموعة من المفكرين العرب، في مدى صلاحية ثنائية »رسوخ/ قطيعة « التي اعتمدوها منطلقا لتنظريهم حول المجتمعات العربية. ولهي خيبة أمل مريرة يكابدها العقل العربي في كل مرة يخوض فيها مسيرته المتدبدبة نحو الخروج من دوائر الارتهان اللاهوتي والانسداد التاريخي (1).
طيبولوجيا الأخطاء السياسية ـ د.زهير الخويلدي
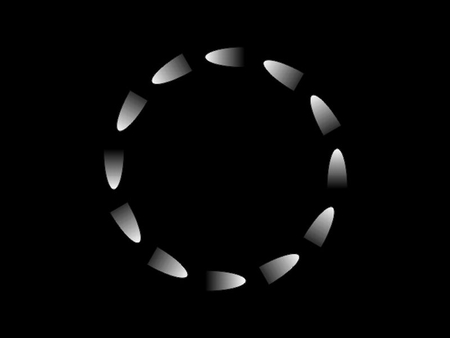 " لا حقيقة دون خطأ مصحح...ولا يتم الاعتراف بالخطأ إلا بعد حين. فالعقل هو الذي يعود إلى ماضيه في حد ذاته من أجل الحكم عليه" - غاستون باشلار-
" لا حقيقة دون خطأ مصحح...ولا يتم الاعتراف بالخطأ إلا بعد حين. فالعقل هو الذي يعود إلى ماضيه في حد ذاته من أجل الحكم عليه" - غاستون باشلار-
تعاني السياسة من تكاثر الأمراض وتزايد الآفات ويمكن ذكر رذائل الطغيان والاستبداد والشمولية من جهة ممارسة الحكم في علاقة بالمحكومين والعنصرية والاستبعاد والاحتكار والتمركز من جهة ذهنية الحكام وبنية السلطة القائمة وكذلك العنف والكذب والجهل في علاقة بأخلاقيات النظام السياسي الحاكم.
لقد دنّس التملق والطمع والنية السيئة قداسة القيم المدنية وعفّن التسلق والأنانية والوصولية الجو السياسي وتم حشر الخطأ في دائرة الأمراض التي تعاني منها الحاضنة الشعبية وتم اعتباره أحد الرذائل التي عرقلت تقدم الحراك المواطني ووقع الاتفاق على تأثيمه واستبعاده من حيث هو عيب ونقص وارتجال وتعثر.
غير أن واقع الممارسة ومحمول النظرية يثبتان خلاف ذلك ويدعوان الذهن المتبصر إلى مراجعة هذا الموقف والكف عن إصدار الأحكام المسبقة على الأخطاء باعتبارها فرصة من أجل تربية الشعور السياسي ومناسبة للتمرين والاختبار والاستعداد والتدرب على الفعل وتكرار الممارسة ونيل الثقة والنجاح المتأني.
لو قام الفكر الحاذق بدراسة تحليلية نقدية لأشكال حضور الأخطاء في الحقل السياسي منقبا في رمزيتها ووظائفها وباحثا في دورها الإجرائي في تشكل السلطة وإعادة إنتاجها في صورة قوانين وتدابير وتوزيعها بطريقة منصفة على الأفراد والمجموعات فإنه يقر بصعوبة الظاهرة وواقع تعقد التكوين وطابعها الخلاق وصيرورتها المولدة ويستوجب السير في جملة من التمشيات التطهيرية ومعالجة استراتيجية للمشكل تميز بين العاجل والآجل وبين العلل المستعصية والعلل التي يمكن التخلص منها.










