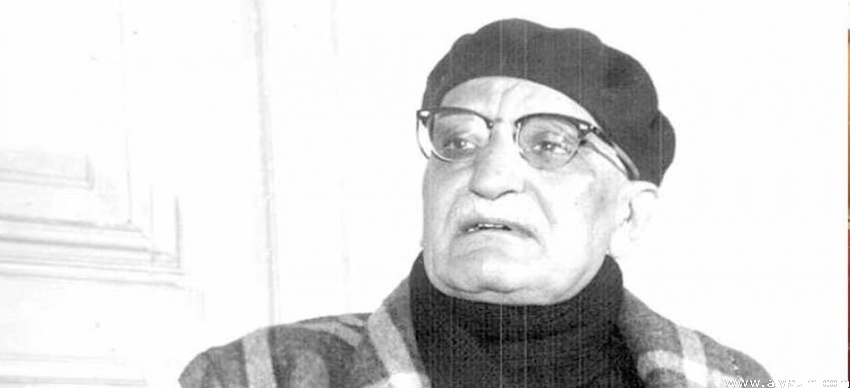" يتشارك الناس على الأقل في الأدوات اللغوية وكل الوسائل الاتصالية المرتبط باللغة"1[1]
" يتشارك الناس على الأقل في الأدوات اللغوية وكل الوسائل الاتصالية المرتبط باللغة"1[1]
لعل وضع الشخصية المفهومية الذي يتقمصها بول ريكور في مواجهة العالم الجديد الذي تنتمي إليه الفلسفة التحليلية هو رحلة استكشافية غريبة الأطوار تكاد تكون مغامرة على أنماط متعددة ومختلفة، ربما قد تكون مماثلة لرحلة كريستوف كولومبس الأولى وتشبه إلى حد كبير وضع شخصيات مفهومية أخرى في مواجهة عوالم غريبة وعجيبة أخرى مثل حنبعل وروما والأسكندر الكبير والشرق وأفلاطون والبحر المتوسط وابن رشد والعالم اللاّتيني وتنقل ابن خلدون بين شمال إفريقيا ومصر والمشرق العربي وكذلك قدوم هوبز إلى باريس وحملة نابليون على مصر والشام وتونس وتفكيره في غزو الصين ووقوفه أمام سورها العظيم عاجزا، وأيضا مجهودات هيجل أو نيتشه وهيدجر في استعادة الثقافة الإغريقية، وسفر الأسكندر كوجيف بالرغبة من أجل الاعتراف نحو الغرب أو تصدير دي توكفيل قيم الثورة الفرنسية إلى أمريكا، ولقد وقع إعادة تصوير بنفس المنوال خروج حنة أرندت من ألمانيا الاضطراري وفرار ولتر بنيامين من الضغط الشمولي وتأثير فوكو ودريدا وغادامير بدرس رورتي الفلسفي في الجامعة الأمريكية، وهي كلها رحلات معرفية مشوقة تندرج في الظاهر في أدب الرحلات العلمية وتقليد السفر المعرفي ولكنها في الباطن محاولة إجراء مقارنة مع ما لا يمكن مقارنته وذلك للتباعد بينهما ولوجود سوء تفاهم تاريخي والسعي إلى فتح ماهو مغلق وطرق الأبواب الموصدة ومخاطبة العقول في شكلها اللغوي المغاير.
مفهوم الصداقة في فلسفة جيل دولوز : شيء من الفكر- ادريس شرود
 تقديم
تقديم
يمنح جيل دولوز ل"اللقاء" أهمية استثنائية، تجعل الكلام عن الصداقة أمرا لا قيمة له، بل لا دور حاسم لها في الحياة. فهو يرى أن اللقاءات لا تحدث بين الناس، بل مع الأشياء؛ مع لوحة، مع قطعة موسيقية...، اللقاءات مع الناس مخيبة للآمال وكارثية دائما. في المقابل، يمجد اللقاءات التي تتم مع أعمال بعض الناس، ومع سحرهم، دون حاجة للقاء بهم، تلك الأعمال التي يمكن أن تترك أثرا أو اهتماما خاصا محفزا وخلاقا عبر العلامات التي يتم إصدارها، فنتلقاها أو لا نفعل. وهنا أيضا لا يتعلق الأمر بامتلاك أفكار مشتركة، بل امتلاك لغة مشتركة تساعد على السير والإحساس معا، والإنتماء إلى نفس النوع. إن اللقاءات والأحاسيس التي تنشأ أثناءها، مع فهم العلاقة مع "الآخر"، والإقامة فيها وبينها، هو شرط ولادة الصداقة حسب دولوز.
1-الصداقة كإدراك وفن، وكشرط لإمكانية الفكر
اتخذ مفهوم الصداقة مع الفيلسوف الفرنسي جيل دولوز معنى جديدا، أبعده عن التعريف الذي وضعه أرسطو، وعن التعاريف المتداولة حول الصداقة. فلم تعد الصداقة بحثا في الحصول على تعاطف أو محبة أو متعة أو لذة أو فضيلة، بل صارت رغبة(1)، توليفا وبناء، إدراكا وفنا، وشرطا لإمكانية الفكر.
أ-بعيدا عن الأخلاق والفضيلة: الصداقة كإدراك وفن
تشكل لحظة ميلاد المسيحية، بداية النهاية لعصر ذهبي للصداقة، ذلك الضرب من الفضيلة والحاجة الضرورية للحياة. فأرسطو يقول أن لا أحد يقبل أن يعيش بلا أصدقاء ولو كان له مع ذلك كل الخيرات(...). كل الناس على وفاق في أن الأصدقاء هم الملاذ الوحيد الذي يمكننا الإعتصام به في البؤس والشدائد المختلفة الأنواع(2)، بل يذهب هذا الفيلسوف اليوناني إلى اعتبار الصداقة رابطة الممالك وأن الشارعين يشتغلون بها أكثر من اشتغالهم بالعدل نفسه(3).
أسباب ظهور السلوكيات اللاإنسانية في الإنسان ـ د.زهير الخويلدي
يتعرض الإنسان في الآونة الأخيرة إلى الكثير من الظلم والامتهان والتمييز في الكثير من الحالات ويظهر هذا الاستهداف بوضوح في تكاثر الحروب وتعدد النزاعات وما يترتب عن ذلك من اعتداء على الحقوق وتهديد للمكاسب الكونية والحريات المدنية التي نصت عليها القوانين الدولية وسعت المؤسسات لحمايتها.
لقد وجد الفكر الفلسفي نفسه أمام الكثير من الصعوبات من أجل تفسير حصول الارتداد وعودة الهمجية وأعاد من جديد تشغيل المقاربات النقدية والمناهج التشخصية باحثا عن الأسباب التي تقف وراء رجوع العنصرية والتفاوت والإقصاء وانسياق الناس المسالمين وراء السلوكات العدوانية والإضرار بغيرهم.
لقد قدمت الفلسفة تصورات حول ارتكاب الناس لأعمال عدوانية تجاه أنفسهم وتجاه بعضهم البعض:
-التفسيرات الميتافيزيقية: الاعتماد في سلطة المصير المحتوم ضمن لعبة الوجود المطلق التي يحكمها صراع بين الخير والشر ويكون الناس مجرد ضحايا للقوانين الكونية التي تدفع القوى الى السيطرة على الضعيف وتكرس منطق تنظيم الأشخاص في المجتمع وفق الترتيب الذي تكون عليه الأشياء في الواقع.
- التفسيرات الأنثربولوجية: الطبيعة البشرية هي التي تحدد نوعية السلوك الذي يصدر عن الكائن الإنساني، فالطبيعة الشريرة التي تخضع لتقلبات المزاج وتناقضات الأهواء تدفع البعد الحيواني الى تغطية البعد العقلاني وتحويل البشر الى آلات راغبة ووحوش مفترسة وكيانات أنانية تمارس العنف والفساد.
- التفسيرات الاجتماعية: انقسام المجتمع إلى مجموعة من الطبقات وتفشي نزعة التملك الأناني والتسلط الاحتكاري والنفوذ الفردي يؤدي إلى التفاوت في حيازة الثروة واللاّمساواة في الحقوق أمام القوانين وينتهي مسار التاريخ إلى اندلاع الصراع بين الطبقات وظهور أشكال من الاستغلال والاستعباد والظلم.
فإذا كانت التفسيرات الميتافيزيقية موغلة في المثالية والجبرية وإذا بقيت التفسيرات الأنثربولوجية في دائرة الذاتية والوضعية فإن التفسيرات الاجتماعية تبقى الأقدر على معالجة الأمراض التي يعاني منها النوع البشري والأقرب إلى الثقافة العقلانية والتجريبية العلمية التي تنتصر على النزاعات اللاإنسانية.
الجوانب السيكوأخلاقية لزراعة القلب الصناعي ـ ابتسام رفيق
حقق ميدان << زراعة الأعضاء >> عدة مكاسب بِتِعِّلَةِ مساعدة المرضى وإنقاذهم من الموت و تجنيبهم الآلام والمعاناة الشديدة سواء تعلق الأمر بالمستوى العضوي أو النفسي أو الاجتماعي ....
"زراعة الأعضاء" تقتضي استئصال بعض الأعضاء السليمة من شخص معطي (ميت) كالقلب، الكلية، القرنية ... ومنحها أو زراعتها لشخص مستقبل (حي) في غالب الأحيان يكون في مراحله النهائية، لكن هذا النجاح تَكَلَّلَ جملةً من المشاكل الأخلاقية، سوف نتناول زراعة القلب الصناعي أنموذجاً لها .
من أهم الإشكالات التي طالت هذه العملية، هي ما تعلق بتحديد معيار إثبات حالة الموت النهائي .
فحول معايير إثبات حالة الموت النهائي، كان هناك ما يسمى بالمعيار التقليدي الذي يُعَرّفُ الموت بأنه التوقف النهائي للقلب والدورة الدموية - القلب مضخة – لكن الآمر سوف يُحسم بظهور وسائل تقنية متعددة ستعمل على إعادة الحياة للقلب، كتقنية الصدمات الكهربائية .... ذلك ما سيستدعي في النهاية إيجاد معيار جديد للموت .
الجسد بين فوكو ودولوز: من الإنضباط إلى المراقبة ـ ادريس شرود
"إن دراسات الممارسات التي تقع على هذا الجسد، والذي يوقعها
كذلك على أجساد آخرين، إنما هو موضوع الفلسفة في هذا العصر"
مطاع صفدي
تقديم
أكد ميشيل فوكو على أن تاريخ المجتمعات الإنسانية يتأسس على ظاهرة الهيمنة، أي على علاقات القوة وإرادة الإخضاع. هذا ما مكن الهيمنة عبر كل لحظة من لحظات التاريخ من تثبيت نفسها في شعيرة من الشعائر، وفرض صنوفا من الإلزامات والحقوق وتؤسس قواعد إجرائية دقيقة. لقد أسست علامات ونقشت على الأشياء، بله الاجساد، ذكريات، جعلت نفسها رقيب حساب على الديون، أضحت كونا من القواعد مسعرا لا للتخفيف والتلطيف، بل لإرواء شهوة العنف(1). إنها حقيقة لم تتأكد إلا مع تحديرات فريديريك نيتشه حول مجيء عصر العدمية وإمكانية انتصار قوى النفي والحياة الإرتكاسية وقيمها الخاصة. أخذت هذه التحديرات تتحقق مع أفول قوى الفعل والإبداع التي برزت مع عصر النهضة، وحاولت الإستمرار طيلة القرنين السابع عشر والثامن عشر. لكن تحالف قوى الإرتكاس مع إرادة العدم والرغبة في الهيمنة والتوسع، سيفتح الطريقة أمام ابتكار مؤسسات سلطوية جديدة وتكنولوجيا تأديب ومراقبة موضوعها الجسد والسكان.
1-ميشيل فوكو: الجسد في مجتمع الإنضباط
أ-الجسد بين حقيقة الأنوار واستراتيجية السلطة الحديثة
شكل القرن 18 منعطفا في تاريخ الفكر، خاصة مع مفكري عصر الأنوار. وكان سؤال إمانويل كانط حول التنوير علامة فارقة في تاريخ أوربا ودخولها "عصر الحداثة"؛ عصر العقلانية والإصلاح الإنسانوي والعقد الإجتماعي وإشهار مطالب الحرية والمساواة والعدالة. هكذا، فإن المعيار الذي تستند إليه العدالة لم يعد سلطة الملك أو حقيقة الإعتراف، إنما بالأحرى "إنسانية" جميع الأطراف الموقعة على العقد الإجتماعي(2). لكن هذه الإنسانية/إنسانية الأنوار(3)، لا يمكن عزلها عن الإبتكار الجديد لمجموعة من المؤسسات والتقنيات، والممارسات والخطابات، والمعارف والعلوم التي موضوعها الجسد وإمكانية إخضاعه وتأديبه، والسكان(الشعوب) وإمكانية تدجينهم وتنميطهم.
مشروع الأنوار من وجهة نظر تزفتان تودوروف ـ أحمد رباص
في أواخر القرن التامن عشر تطرق إيمانويل كانط لنفس الموضوع في حيز بلغ مداه تقريبا عشرين صفحة وكان قد اختار له عنوانا على صيغة سؤال: "ما الأنوار؟". في القرن العشرين عمل ستيفان بيوبيطا على نقل هذا النص الكانطي من الألمانية إلى الفرنسية. ثم جاء ميشال فوكو ليدلي بدلوه في هذا الموصوع مخصصا له حوالي 12 صفحة ومحتفظا بنفس العنوان الذي ابتدعه كانط. نشرت مساهمة فوكو مجلة Magazine littéraire في العدد 207 الصادر في ماي 1983. وقد شكل هذا النص الفوكوي مقتطفا من الدرس الذي ألقاه صاحبه ب Collège de France بتاريخ 05 يناير 1983، وقد تمت إعادة نشره في الجزء الثاني من كتاب Dits et écrits الصادر عن دار النشر غاليمار سنة 2001. أخيرا، جاء دور تزفتان تودوروف ليضيف حلفة أخرى الى هذه السلسلة الذهبية الخاصة بفلسفة الأنوار، وذلك في حيز أصغر بكثير من الحيز الذي سوّده كانط. والجدير بالذكر أن نص تودوروف مقتطف من كتاب له بعنوان L'esprit des lumières.
يبدأ تودوروف مساهمته بأنه من الصعب التعبير بدقة عن ماهية مشروع الأنوار لسببين "أولهما، أن عصر الأنوار هو عصر تتويج، وتلخيص، وتركيب وليس عصر تجديد راديكالي. ذلك أن أمهات الأفكار في هذا العصر لا تجد أصلها في القرن الثامن عشر، وحتى عندما لا تنحدر من العصر القديم، فهي تحمل بصمات القرون الوسطى السحيقة، وعصر النهضة والعصر الكلاسيكي." أما السبب الثاني فقد تمثل في "كون الفكر الأنواري يحمله عدد هائل من الأفراد، عوض أن يشعروا بالتوافق في ما بينهم، دخلوا في مناقشات حادة وعنيفة، من بلد إلى بلد أو حتى داخل البلد الواحد." هنا، وجد الفيلسوف في الزمن الذي يفصلنا عن أولئك "عاملا مساعدا لنا في عملية الفرز والغربلة: فخلافاتهم القديمة أثمرت مدارس فكرية لا زالت معاركها محتدمة إلى يومنا هذا." من ذلك يخلص تودوروف إلى أن عصر الأنوار كان "عصر سجال أكثر منه عصر توافق وإجماع". ورغم أنه يجد نفسه في هذا العصر أمام تعدد مخيف، غير أنه يقر بأنه من السهل التعرف على "وجود ما يمكن تسميته بمشروع الأنوار".
في مفتتح حديثه عن هذا المشروع يخبرنا الكاتب أن هناك ثلاث أفكار كبرى تقوم بإغنائه عبر مقتضياته العديدة، وهي: الاستقلالية، الغائية الإنسانية لأعمالنا، والكونية.
بيداغوجية الحداثة ـ أ.د. علي اسعد وطفة
يقول جيل دولوز "بأن الحقيقة تنقدح في مواجهة صعبة بيننا وبين الأشياء التي تكرهنا على التفكير والبحث عن الحقيقة". Proust et les signes
تمثل الحداثة نسقا معقدا من الظواهر التي يصعب تحديدها، ويتفق عدد من مفكري الحداثة مثل أدورنو Adorno وهوركايمر Horkheimer وفوكو Foucault بأن المجتمعات الحديثة بدات انطلاقتها في تخوم عام 1800، تحت تأثير مجموعة من التحولات الاجتماعية والسياسية والفكرية والاقتصادية الواسعة ، وقد شكلت هذه التحولات العمق التاريخي للتفكير الحديث الذي نعيشه في المرحلة المعاصرة. لقد احتضن القرن التاسع عشر عالما استنفر طاقته الكلية في البحث عن الدلالات والمعاني الكونية للعقل الغربي الذي فرض نفسه في كل مناحي الوجود وجوانب الحياة الإنسانية. وقد تجلت غاية هذا العقل في صورة إنسانية تهدف إلى تحرير الإنسان والإنسانية من كل أشكال العبودية والقهر ، ولكنه ما لبس أن وظف لاحقا كأداة لترسيخ كل أشكال العبودية والمظالم والقهر الذي استطاع أن يسحق روح الإنسان ويحطم أحلامه وأمنياته.
يتحدث أدورنو في هذا السياق عن التطور الذي شهدته المجتمعات الغربية بوصفه قوة تكنولوجية فرضت نفسها كأيديولوجية للهيمنة على المجتمعات الإنسانية مع بداية القرن التاسع عشر، وقد شكلت هذه القوة تدريجيا موضوعا لنقد المفكرين منذ لحظة تشكلها وتكونها تاريخيا. وقد أخذت هذه الانتقادات للمجتمعات الحديثة صيغا مختلفة ومتناقضة عند المفكرين والباحثين: لقد وصفها البعض بأنها "سوق رأسمالية"، ورأى فيها بعض آخر انتصار للتكنولوجيا والميديا، بينما رأى فيها آخرون تجسيدا للمجتمعات الشمولية. ويرى ميشيل فوكو في هذا السياق أن المجتمعات الحداثية تتميز بهيمنة شاملة "لمؤسسات الضبط والرقابة التي تطورت على إيقاع التطور الذي شهدته العلوم الإنسانية في المرحلة الراهنة[1].
شروط الانعطاف المعرفي من الحس المشترك إلى الفهم السليم ـ د.زهير الخويلدي
" النقد يعطي لأحكامنا مقياسا يسمح لنا بالتمييز الصحيح بين العلم والتظاهر بالعلم "
- كانط-
توطئة:
إذا كانت الميتافيزيقا قد مارست الإقصاء على الحس المشترك وأدرجته ضمن دائرة المحسوس والخيال وحكمت عليه من زاوية المعيار المنطقي والحكم العقلي واستندت إلى أولوية الروح على البدن وأفضلية الرمزي على المادي والمعقول على الحسي فإن الفلسفة النقدية المعاصرة قد أعادت له الاعتبار ورفعت عنه الضيم وصارت تعول عليه في العديد من المجالات وتعتمده كأداة للمعرفة والتواصل وقوة اجتماعية.
فما المقصود بالحس المشترك؟ ماهي المبررات التي جعلت الفلسفة الميتافيزيقية تحتمي بها لكي تقوم بتهميشه؟ ولماذا عادت إليه الفلسفة النقدية بقوة؟ وما الفرق بين الحس المشترك والعقل؟ وهل يمكن أن يمثل الحس المشترك دورا مركزيا في نظرية المعرفة وفي مجال التجربة العملية والتشريع الأخلاقي؟
لا يمنع الإقرار بمركزية الحس المشترك ضمن التناول الفلسفي من تعقيد المسألة وصعوبة الظاهرة ولا تمنع القراءات المتضاربة التي ظهرت حولها وتردد التأويلات التي مورست عليها دون جدتها وتأصلها.
لقد وفر لنا التراث الفلسفي حول الحس المشترك مسارين من التفكير في المبحث مع إمكانية التقاطع بينها:
-لقد صاغ أرسطو للمرء الأولى مفهومkoine aisthesis أثناء التفكير في مسألة الإدراك (الحس المشترك) وظل حاضرا في قلب الإشكاليات الفلسفية التي تطرح ضمن نظرية المعرفة إلى حد القرن 18 ميلادي.
- المسار الثاني من التفكير هو الذي جعل من الحس المشترك في اللاتينية sensus communis وفي الفرنسية sens commun متماثلا مع مصطلح الفاهمة المشتركة والرأي العام l'opinion..
مسألة تعريف الفلسفة ـ موسى برلال
إن ما يميز الفلسفة عن باقي التخصصات المعرفية هو كونها لا تكتفي بالبحث في أهم الإشكالات التي درجت على مناقشتها عبر تاريخها، بل على العكس من ذلك، تجعل من ذاتها موضوعا للتساؤل المستمر، وهي السمة الأساسية المحايثة للتفكير الفلسفي منذ نشأته إلى حدود الفترة المعاصرة، حيث استقلت مختلف المباحث العلمية ما جعل سؤال ما الفلسفة يطرح ذاته بقوة أكثر. في هذا الصدد يتبلور الإشكال الآتي:
كيف عالجت الفلسفة مسألة تعريفها لذاتها عبر التاريخ؟ وما الإشكالات التي يطرحها هذا التعريف؟
لا شك أن للفلسفة موضوعات ومباحث كبرى تبلورت منذ الفلسفة اليونانية، وهو ما يعرف بالمباحث الفلسفية الكبرى (الوجود، المعرفة، الأخلاق والسياسة، الجمال). غير أن ظهور الفلسفة لم ينفصل عن البحث عن ماهيتها، لدرجة يمكن القول أن كل فلسفة قدمت تعريفا وتصورا خاصا للفلسفة ذاتها. ذلك ما سيتضح من خلال هذا العرض الفلسفي، مع الإشارة إلى أن سؤال "ما الفلسفة؟" سيطرح بقوة في الفلسفة المعاصرة بشكل خاص.
علوم الأوهام من إسحاق نيوتن إلى جاك لاكان ـ حمودة إسماعيلي
علوم الأوهام هي المجالات التي تأتي من جانب علمي، لكن بناء على خرافات علمية؛ مثل قانون الجذب والعقل الباطن والتنويم المغناطيسي. كل هذه المجالات التي تعتمد على الطاقة بين الكون والإنسان، أتت من نظرية الأثير؛ وهذا الأخير هو المجال الكوني الذي اعتقد إسحاق نيوتن أن الأجسام تتحرك فيه؛ ليأتي إنشتاين بنظرية النسبية التي نفت وجود هذا الأثير! وشهرة أنشتاين تزايدت لهذا السبب، لأن الكون كان يتم النظر له من خلال رؤية نيوتن، ليقلب أينشتاين هذه الرؤية.
نظرية الأثير، سيعتمدها طبيب نمساوي يدعى مسمر Mesmer ومن اسمه اشتقت كلمة mesmerize التي تعني التنويم المغناطيسي. مسمر أراد تطبيق هذا الأثير في مجال الطب، وذلك لعلاج الناس عبر جذب الشفاء من طاقة هذا الأثير الكوني (كان لمسمر اعتقاد بقوة الأبراج وتأثير الكواكب)؛ سينتقل مسمر لمدينة باريس لإقامة صالون، يضم ديكورات وألوان وموسيقى، يسبب الجو فيه حالة تنويمية للزائر، ويتاح لهذا الزائر لعب الدور الذي يريد - يقفز، يرقص، يغني، يتشقلب إلخ. تترك هذه التجربة نوعا من الارتياح لدى الزوار؛ لتزداد شهرة مسمر مع هذا الشكل من التنويم العلاجي، فصار الأمر أشبه بحفلات تنكرية. وقد تطرقت لهذه الجوانب بإيضاح في كتاب خطورة الإنسان.
من أجل تكوين هيئات إيتيقية ـ د.زهير الخويلدي
تم تقديم مداخلة بعنوان : "الإيتيقا من حيث هي فلسفة تطبيقية" ضمن أنشطة مركز الدراسات بقرطاج تضمنت مقاربة نقدية لأزمة القيم التي يعاني منها المجتمع المعاصر في مستوى الأسباب والمخارج.
يأتي هذا النشاط في سياق فك العزلة عن علم الفلسفة ومنح المشتغلين بها أدوارا عمومية والاستفادة من المباحث الأكاديمية المتقدمة في مجال الأخلاقيات والإنسانيات والاستئناس بالنتائج التي أفضت إليها بغية معالجة الاحراجات الإيتيقية التي تطرحها التطورات العلمية والتكنولوجية وأفرزتها المطالب الحقوقية للأنواع الاجتماعية التي عانت من التمييز والازدراء على غرار الأقليات والأطفال والنساء والمعوقين.
انطلقت المحاضرة من سبر للآراء تم تنظيمه في الفضاء الافتراضي وشارك فيه عدد من المهتمين حول أسباب أزمة القيم التي تعصف بالمجتمع ورصدت انقسام الاستبيان بين سوء الحوكمة وتراجع الأخلاق ولاحظت وجود تداخل بين العامل السياسي والعامل الأخلاقي ترتب عنه انتشار للعدمية القيمية والحيرة الأكسيولوجية مع التنصيص على التحلي بالأخلاق الحميدة والسياسة العادلة من أجل بناء مجتمع سوي.
ضمت المداخلة ثلاثة أقسام كبرى تربط بينها فكرة ناظمة أساسية تتمحور حول عاجلية الدفاع عن الحقوق والحريات للفئات الهشة في سبيل احترام الكرامة البشرية وتوفير شروط أساسية تضمن تحقيق الإنساني.