 الدين على دفة. العلم على دفة. وبين الدفتَين كتاب الحياة للعرب والمسلمين؛ كتاب مفتوح لكنّه مشفّر و غير مقروء. فإن كنت من علماء الدين لا حق لك في أن تجتهد في العلم الدنيوي، لأنّ الأوان قد فاتك. وإن كنت أخصائيا في علم من العلوم غير الدينية لا حق لك في أن تجتهد في الدين، لأنك لست من علماء الدين. ذلك ما حكمَت به التقاليد والأعراف إلى حد الآن. و الوضعية جد حرجة ومسألتها جد شائكة، وقد تفاقمت مع مرور الحقب في تاريخنا المعاصر. مع هذا فإنّ الفكر العربي الإسلامي لم يكن قادرا على رفع التحدي القاضي بتقريب ما هو ديني من ما هو دنيوي من العلوم. وكلمة تتردد مئات المرات على ألسنية المفكرين من جميع المشارب: التأصيل؛ تأصيل الواقع في الدين، و الدين في الواقع، والحداثة في الثقافة العربية.
الدين على دفة. العلم على دفة. وبين الدفتَين كتاب الحياة للعرب والمسلمين؛ كتاب مفتوح لكنّه مشفّر و غير مقروء. فإن كنت من علماء الدين لا حق لك في أن تجتهد في العلم الدنيوي، لأنّ الأوان قد فاتك. وإن كنت أخصائيا في علم من العلوم غير الدينية لا حق لك في أن تجتهد في الدين، لأنك لست من علماء الدين. ذلك ما حكمَت به التقاليد والأعراف إلى حد الآن. و الوضعية جد حرجة ومسألتها جد شائكة، وقد تفاقمت مع مرور الحقب في تاريخنا المعاصر. مع هذا فإنّ الفكر العربي الإسلامي لم يكن قادرا على رفع التحدي القاضي بتقريب ما هو ديني من ما هو دنيوي من العلوم. وكلمة تتردد مئات المرات على ألسنية المفكرين من جميع المشارب: التأصيل؛ تأصيل الواقع في الدين، و الدين في الواقع، والحداثة في الثقافة العربية. وبودّي أن أستهلّ الإجابة في صلب هذه الإشكالية باستعراض وجيز لوضعية التشكل الإيديولوجي العام الذي آل إليه الحرمان من القدرة على التأصيل. ثمّ لا مفرّ من عرض أهمّ التبعات الفكرية لذلك التشكل الناتج عن حرمان من مواقف عادة ما تكون إمّا متصدّية للتأصيل، رغم ادعائها عكس ذلك، وإمّا صارفة النظر عنه. كما أودّ، في مرحلة تالية، أن ألقي بعض الضوء على نتائج بعض التجارب في الفكر العربي أخذت من التأصيل هدفا لها. وأخيرا أعتزم عرض رؤية معينة يكون فيها تأصيل الحداثة والإسلام في بعضهما البعض بواسطة تكامل الاثنين أمرا معقولا ومقبولا.
إنّ من ينادي بالتأصيل هم عادة ناشطو الإسلام السياسي ورموز الإسلام التقليدي المؤسساتي. إلاّ أنّ الغريب في الأمر، من الوهلة الأولى، أنهم هم الذي يبادرون باستعمال ورقة النقض ضد أية محاولة من قبيل التقارب بين الدين والعلم. ذلك لأنهم بقوا حبيسين لمبدأ مغلوط ورثه الفكر العربي عموما من تاريخ الكنيسة: فصل العلم عن الدين، وبمقتضاه اعتبروا أنفسهم، دون سواهم من أهل العلم، الورثاء الوحيدين للدين. فتراهم يقفون سدّا منيعا أمام كل "تطفل" على الدين من لدن دعاة العلم ولو كان دعاة العلم من المؤمنين.



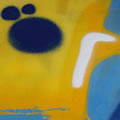 مدخل:
مدخل:  هكذا هي لغة الواقع، لو يخون الطلاء شواهده لحظة واحدة...
هكذا هي لغة الواقع، لو يخون الطلاء شواهده لحظة واحدة... اللسان العربي مصطلح أعم يشمل لسان العرب ولسان القرءان واللسان الكامن كما ورد في مقال سابق خاص بتعريف هذا اللسان وتصنيفه. واللسان العربي (ومن ضمنه لسان القرءان) يمكن دراسته على ثلاثة مستويات هي مستوى الدال ومستوى الدلالة ومستوى التداول (أنظر المقابل الإنجليزي لهذه المصطلحات في الخلاصة). ويمكن دراسة الدال في مستوى التصويت ومستوى التصريف ومستوى التركيب. وهذا المقال سوف يركز على نظام التصريف في اللسان العربي. ولأن التصريف من أهم خصائص اللسان العربي، فإن هذا اللسان يوسع الدلالة العامة الأصلية (الدلالة المحورية) للجذر الثلاثي فيه مثلاً بتصريف هذا الجذر في اتجاه الدلالات الفرعية المتعددة حسب أوزان صرفية معروفة وأخرى كامنة يمكن أن تظهر في سيرورة حياته. ونظام التصريف في اللسان العربي يمكن تقسيمه إلى ثلاث مجموعات كبيرة تحتوي كل مجموعة على مجموعات صغيرة داخلها.
اللسان العربي مصطلح أعم يشمل لسان العرب ولسان القرءان واللسان الكامن كما ورد في مقال سابق خاص بتعريف هذا اللسان وتصنيفه. واللسان العربي (ومن ضمنه لسان القرءان) يمكن دراسته على ثلاثة مستويات هي مستوى الدال ومستوى الدلالة ومستوى التداول (أنظر المقابل الإنجليزي لهذه المصطلحات في الخلاصة). ويمكن دراسة الدال في مستوى التصويت ومستوى التصريف ومستوى التركيب. وهذا المقال سوف يركز على نظام التصريف في اللسان العربي. ولأن التصريف من أهم خصائص اللسان العربي، فإن هذا اللسان يوسع الدلالة العامة الأصلية (الدلالة المحورية) للجذر الثلاثي فيه مثلاً بتصريف هذا الجذر في اتجاه الدلالات الفرعية المتعددة حسب أوزان صرفية معروفة وأخرى كامنة يمكن أن تظهر في سيرورة حياته. ونظام التصريف في اللسان العربي يمكن تقسيمه إلى ثلاث مجموعات كبيرة تحتوي كل مجموعة على مجموعات صغيرة داخلها. كنت في بداية السنوات التسعين من القرن العشرين أقرأ في المقدمة الضافية العميقة التي خطها قلم الأستاذ أحمد محمد شاكر عليه شآبيب الرحمة لكتاب الظاهرة القرءانية الذي ألفه الأستاذ مالك بن نبي رحمه الله وقد لاحظت أن الأستاذ شاكر كان يدافع عن الشعر العربي ضد الذين جاؤوا بأبيات ناصعة من الشعر ولكنهم قلَّلُوا من قيمتها عند مقابلتها بآيات من القرءان العظيم. قرأت تلك المقدمة عدة مرات وأوحت لي بفكرة الإختلاف بين لسان العرب ولسان القرءان ووجدت أن الأستاذ شاكر أحس بهذا الإختلاف ولكنه أفلت منه لأن دائرة قوله كانت الدفاع عن الشعر وعدم مقارنته بالقرءان. وسبب اهتمامي بهذا الموضوع يعود لسنوات الدراسة حيث أنني لم أكن أحب في كتب النحو أن تأتي بأمثلتها من القرءان وغيره من الكلام جنباً إلى جنب.
كنت في بداية السنوات التسعين من القرن العشرين أقرأ في المقدمة الضافية العميقة التي خطها قلم الأستاذ أحمد محمد شاكر عليه شآبيب الرحمة لكتاب الظاهرة القرءانية الذي ألفه الأستاذ مالك بن نبي رحمه الله وقد لاحظت أن الأستاذ شاكر كان يدافع عن الشعر العربي ضد الذين جاؤوا بأبيات ناصعة من الشعر ولكنهم قلَّلُوا من قيمتها عند مقابلتها بآيات من القرءان العظيم. قرأت تلك المقدمة عدة مرات وأوحت لي بفكرة الإختلاف بين لسان العرب ولسان القرءان ووجدت أن الأستاذ شاكر أحس بهذا الإختلاف ولكنه أفلت منه لأن دائرة قوله كانت الدفاع عن الشعر وعدم مقارنته بالقرءان. وسبب اهتمامي بهذا الموضوع يعود لسنوات الدراسة حيث أنني لم أكن أحب في كتب النحو أن تأتي بأمثلتها من القرءان وغيره من الكلام جنباً إلى جنب.
 الجمال نعمة كبرى :
الجمال نعمة كبرى : مواقف كثيرة طرحت، وآراء متعددة قدُّمت حول مفهوم الشورى في الإسلام، منها ما كان توصيفاً مثالياً للمفهوم، ومنها ما كان رفضاً عاماً له، وقد مَلأت الدراسات السياسية منذ بداية عصر النهضة على الأقل بكلا الموقفين، فمن الدارسين من عرض الشورى كنظرية إسلامية بديلة عن نظرية الديمقراطية في الحكم، ومنهم من رأى في الشورى مفهوماً فضفاضاً وقوالب تقليدية لا تتناسب مع نظام الحكم اليوم، ومنهم من أسقط مفهوم الشورى من حساباته بإعلانه فصل الدين عن الدولة ولم يعد من المفيد بعدها دراسة مفهوم ديني في دولة لا تعترف بالدين مصدراً أساسياً من مصادر التشريع، وقوةً دافعةً للمجتمع، ومنهجاً أخلاقياً ورؤية خاصة لتداول السلطة، ونحن إذ نحاول اليوم دراسة هذا المفهوم فإننا لا ندرسه، بأي من الموقفين، وإنما أن نعطيَه حقه فلا نضخمه ولا ننفيه. لذلك يتوجّب علينا تقديم ما يشبه التعريف العام الأولي لمفردة الشورى، ومن ثم الانتقال إلى الوظيفة التي جاءت من أجلها فالمفردة مفردة قرآنية بامتياز ولا يمكن أن تكون قد وردت نافلة أو حشواً في النص الإلهي، والقرآن الكريم كما نعلم كتاب مقدس بذاته جمعاً وتفصيلاً متحرك بفهمنا له.
مواقف كثيرة طرحت، وآراء متعددة قدُّمت حول مفهوم الشورى في الإسلام، منها ما كان توصيفاً مثالياً للمفهوم، ومنها ما كان رفضاً عاماً له، وقد مَلأت الدراسات السياسية منذ بداية عصر النهضة على الأقل بكلا الموقفين، فمن الدارسين من عرض الشورى كنظرية إسلامية بديلة عن نظرية الديمقراطية في الحكم، ومنهم من رأى في الشورى مفهوماً فضفاضاً وقوالب تقليدية لا تتناسب مع نظام الحكم اليوم، ومنهم من أسقط مفهوم الشورى من حساباته بإعلانه فصل الدين عن الدولة ولم يعد من المفيد بعدها دراسة مفهوم ديني في دولة لا تعترف بالدين مصدراً أساسياً من مصادر التشريع، وقوةً دافعةً للمجتمع، ومنهجاً أخلاقياً ورؤية خاصة لتداول السلطة، ونحن إذ نحاول اليوم دراسة هذا المفهوم فإننا لا ندرسه، بأي من الموقفين، وإنما أن نعطيَه حقه فلا نضخمه ولا ننفيه. لذلك يتوجّب علينا تقديم ما يشبه التعريف العام الأولي لمفردة الشورى، ومن ثم الانتقال إلى الوظيفة التي جاءت من أجلها فالمفردة مفردة قرآنية بامتياز ولا يمكن أن تكون قد وردت نافلة أو حشواً في النص الإلهي، والقرآن الكريم كما نعلم كتاب مقدس بذاته جمعاً وتفصيلاً متحرك بفهمنا له. 







