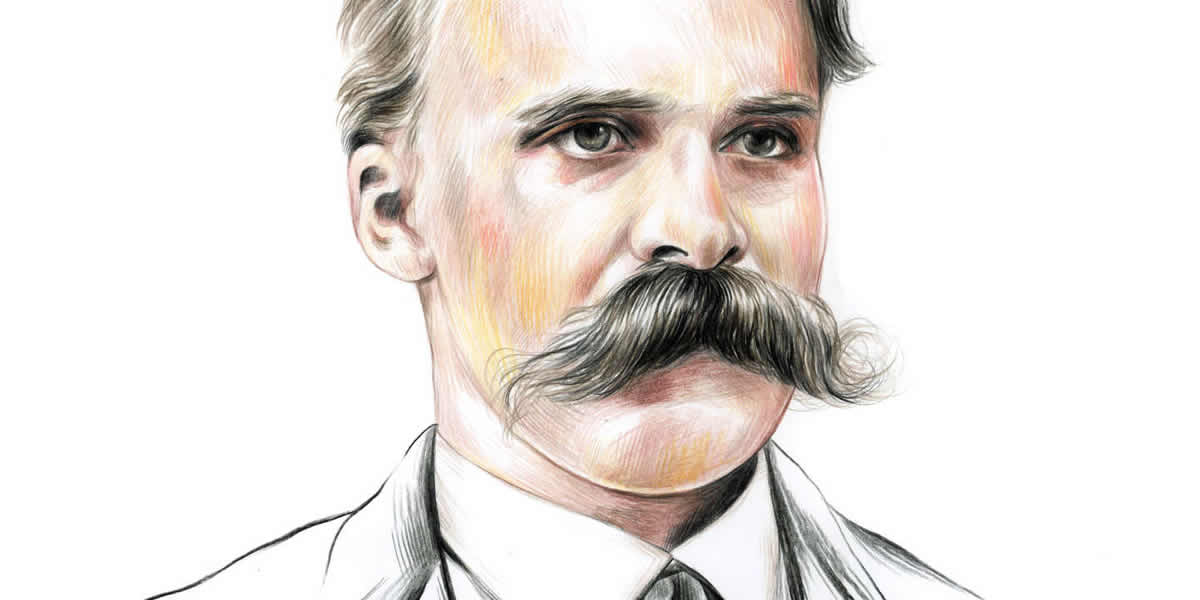تمهيد:
من المعروف ان كانط عمد في كتابه الذائع الصيت (نقد العقل المحض) إلى إثبات امكانية الادراك العقلي المنطقي المحض لاشكال موجودات العالم الخارجي الذي يحتوينا بمعزل عن محتوى تلك الاشياء المادية.
بالتعبير المباشر المختصر، امكانية العقل ادراك شكل الشيء كفراغ مكاني مجردا عن محتواه المادي حسب كانط. كما حاول اثبات ادراك الفراغ المكاني بدلالة الحدس المنطقي الميتافيزيقي وليس بدلالة الحس أن المادة محتوى الفراغ المكاني.
ونسب كانط لجهده الفلسفي بالكتاب انه انهى والى الابد كل نظريات الميتافيزيقا بالتفكير. فالى أي حد نجح كانط في تحقيق مسعاه في تحليله ونقده العقل مجردا ماديا كعقل محض من زاوية تناوله التفكير بالمنهج المنطقي؟ كتاب كانط (نقد العقل المحض) يقال انه استغرق الفيلسوف بتاليفه عشرين سنة !!. وانا هنا اناقش بعض القضايا بضوء كتاب المفكر صادق جلال العظم عنه (دراسات في الفلسفة الغربية المعاصرة ) في عرضه آراء كانط في كتابه المشار له. والشيء الملاحظ ان المفكر الماركسي جلال العظم لم يقم بنقد الميتافيزيقا التي احتواها كتاب كانط بل اكتفى بعرضها مع تعليقات نقدية توضيحية في بعض الاحيان. يلازمه حرصه الشديد عرض افكار كانط كما هي لا كما يرها في منهجه النقدي المادي.